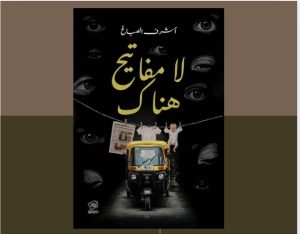د. بهيجة مصري إدلبي
سؤال المتعة
كمن يتحرك بالكلام من غوايته الأولى البكر، إلى تحولاته الشاهقة في المعنى، حين يختبره في مخيلة تستدرج الذاكرة، لا لتستعين بها على تشكيل الحكاية، وإنما لتختبر كينونتها في مختبر الصيرورة والسيرورة التي يؤولها جدل الزمن المتداخل في جدل المكان، والكائن.
فللكتابة غوايتها حين تدرك دهشة اللغة، وللغة غوايتها حين تفرد دهشتها في الذات، لينهض بين الغوايتين سؤال المتعة، بين المبدع ونصه وبين النص وقارئه، ذلك أن استجابة النص لاختبارات القراءة، ما هي إلا استجابة لاختبارات الزمن.
وكما أن لكل فن إبداعي أسراره وغواياته، وأسئلته التي تنهض من صبغته، كذلك لكل فن تفاتحه مع الفنون الأخرى، يفضي به إلى دهشة مختلفة.
والرواية هي أكثر الفنون استجابة لهذا التفاتح، واستجابة للتجريب المستمر، وبالتالي هي عالم من الغوايات، وعالم من الأسئلة، وعالم من الدهشة.
وبالتالي إن متعة السرد لا تكمن في الحكاية، وإنما في تخطيب الحكاية عبر طاقة اللغة كفعل وجود، لأن الإبداع هو احتكاك الذات باللغة لاستدراج متعة الكتابة.
هكذا يستدرج سعد القرش غواية السرد، كما تستدرجه، لينشئ نصه إنشاء مختلفا، سواء على مستوى البناء الفني الذي ينهض على متعة التجاذب النصي، بين طبقات مختلفة يدخل القارئ عبرها في مراياه وظلاله وإشاراته، أو على مستوى الحكاية التي تستظل برؤية الذات للوجود والعالم، لتصبح الرواية لديه عالما تستظل فيه الأسطورة مع الواقع، كما يستظل فيه الحاضر والغائب، الحلم والوهم، الصمت والكلام، الدهشة والمفارقة، وكأنه يسقط ذاته على العالم فتفرد فيه كل أسرارها وغواياتها وأسئلتها، وقلقها، ليعيد تركيب الوجود، كما يعيد خلخلة القلق في الذات، وبالتالي يورث القارئ دهشة لا تنتهي بفراغه من النص، لأنه معنيٌ أولا وأخيرا بصمود الإبداع لاختبار الزمن ـ كما قال ـ ولأن الإبداع لديه يعبر عن جوهر الحياة.
فحين تقرأه، يأخذك الصمت والتأمل، كما تأخذك الحكاية التي تفرد روحها في ذاتك، فتنسى أنك قارئ، لتدخل في لعبة المتعة التي أنشئ عليها النص، فثمة كثافة وبساطة وعمق في التعبير، تجعل اللغة تشهق كما تشهق القصة القصيرة التي تقبض على أنفاسك من أول كلمة حتى آخرها، فالرواية عنده لا يغريها الكلام بقدر ما يغريها الكشف عن روح اللغة، ولغة البوح في روح الكائن، سواء أكان ذلك بالسرد الشاف أو بالمشاهد الحوارية الخاطفة، أو بتلك البؤر الحكائية التي تستدرجها المواقف، لتكون أشبه بالظلال التي تنبثق فجأة أمام القارئ، حاملة دهشتها بذاتها، دون أن تخلخل دهشته بالخيط الدرامي للقصة الأم، ودون أن تكون متطفلة على الحكاية، بل يشعر القارئ بها كضرورة جمالية تفضي إلى مزيد من متعة التلقي لديه.
فاللغة لديه لينة يشكلها كيف شاء، وسرده لين يدخل القارئ في حيرة الأسئلة منذ أول كلمة من الرواية، دون أن يفضي إليه بيقين، والسرد اللين هو السرد الذي يتسرب بدهشته إلى روح القارئ، عبر إشارات وظلال، ومواقف وفجوات، تتيح له أن يختبر ذاته في النص، كما يختبر النص في ذاته.
وحين يكون الإبداع في هذا المقام، يصبح خطابا أوسع من النص، وأكثر استجابة لحركة الزمن وحركة الوجود، شاهدا على ذاته بذاته في مختبر الزمن.
ومن هنا فرواية «أول النهار[1] » هي رواية الأسئلة اللامتناهية، سؤال الذات و الوجود، سؤال الحياة والموت، سؤال المكان والزمان، سؤال الكائن، وسؤال التاريخ، وسؤال الخطاب، المنشأ على سؤال المعنى.
ولا شك حين أستدرج نصا إبداعيا إلى المختبر النقدي لا أكتفي بالنص الذي استغرقه الكتاب، ولا أكتفي بالمعنى الذي أيقظته نبوءة الكاتب ووعيه الإبداعي، وإنما وفي الغالب أجعل من النص مستندا أتكئ عليه للحفر خلف النص المكتوب، بحثا عن النص المتواري أي عن ظل النص وهذا البحث يجعل من النقد أمام مهمة تتخذ من الكشف أداة معرفية لتعرية الخطاب السردي أو الإبداعي لا لتفسيره أو الحكي عليه وإنما لكشفه، ما يجعل من الخطاب كائنا منفلتا من سلطة الزمن وسلطة المكان وسلطة المؤلف وسلطة المعنى. لينا بتحولاته، منفتحا على أسئلة المتلقي، ومستجيبا لتأويلاته المختلفة.
وإذا كان الخطاب السردي خطابا مركبا سواء أكان ذلك على مستوى الشكل أو على مستوى التخصيب الحكائي، فإن هذا التركيب يضمر في أسراره سؤال التجاذب ين المبنى والمعنى، بين الذات التي أنتجت النص، في تحولاتها، وفي تركيبيتها، وتعقيدها وبين النص الذي كما أرى هو صورة مركبة عن الذات، مهما حاول الإبداع أن يستجيب للعالم الموضوعي يبقى سؤال الذات هو السؤال الأكبر الذي يقلق النص، كما يقلق الكائن، ومن هنا يصبح الإبداع سؤالا للوجود كما يصبح الوجود سؤالا للذات، حيث تختبر الذات متعتها في استدراج العالم، وفي تأويله وتفكيكه وترتيب أسراره، كما تجد متعها في تحفيز طاقة اللغة على القول، وعلى البوح، وعلى الانتباه إلى حيويتها ككائن حي يتحرك في ذات الكائن كما يتحرك الكائن بين كلماتها، ومن هنا تنهض متعة القراءة ومتعة الكشف عن المعنى الظلي للنص الإبداعي، فلا نستطيع “أن نحكم على القراءات بمعزل عن هذا السؤال”[2]
وبالتالي إن فعالية المتعة هي نتاج لفعالية الكتابة وفعالية القراءة، من خلال الفعل الجدلي الذي يجعل كل منهما وجها للآخر، عندئذ يمكن للفعلين أن يتجسدا في فعل واحد هو فعل المتعة”[3]
لذلك “إن متعة القراءة تبدو انعكاسا لمتعة الكتابة، وكأن القارئ هو شبح الكاتب وبالنسبة لبرجسون فإن مشاركة القارئ في متعة الخلق هي دلالة على الخلق”[4]
فالقراءة ليست محاولة لتفسير النص، بقدر ماهي محاولة لاستقراء الكلمة واستقراء الدهشة الكامنة في الفعل التركيبي للكلمات فهي بشكل ما “فن اليقظة في الكلمات”[5]
وسعد القرش في سردياته وعلى وجه الخصوص في رواية «أول النهار»، مدرك لهذا الفعل المتبادل بينه وبين المتلقي، الفعل المنتج للمعنى، والمنتج للنص عبر مرايا القارئ المختلفة.
ومن هنا تبرز خصوصية «أول النهار» من خلال وعيها الفني، ومن خلال وعيها المضموني، ومن خلال وعيها التبادلي، وبالتالي من خلال وعيها للرؤية الإبداعية التي أنشئت عليها.
فأن تكتب رواية يعني أن تختبر ذاتك في السرد وأن تختبر السرد في ذاتك، ولا يستوي هذا الاختبار إلا بامتلاك الدهشة التي يفردها الخطاب في ذاكرة المتلقي، الطرف المفصلي بعد المؤلف، بل يمكن أن يكون هو المؤلف الثاني للنص، حيث يبدأ النص بالتأويل في اللحظة التي يتفلت من سلطة مؤلفه، ويصدر في كتاب، ليدخل في حركة الفعل التأويلي عبر انفتاح ظلاله على ذاكرة التلقي. كل ذلك عبر الأدوات المتاحة في مختبر اللامألوف ليعيد تشكيلها كما يتفق وانبثاق الذات في تأويل وتحليل الواقع المستند إلى مصادره، والواقع المنبثق من طاقة التخييل المفتوح.
بهذا المعنى تصبح الرواية كشفا لطاقة الخيال كما هي كشف لخصوبة الواقع ، وخصوبة الحلم المنبثق من احتكاك الخيال بالواقع، فأن نجعل من الواقع أسطورة ومن الأسطورة واقعا هو ما يجعل النص أكثر انتماء للمعنى والإبداع.
المناصات العنوانية
إذا كانت مقولة البنيويين لا شيء خارج النص، تستدل على نصية النص من خلال الكشف عن بنياته الداخلية ذاتها، سواء عبر دراسة اللغة، وحركتها في الخطاب النصي، أو في دراستها للتشكيل البنائي، فإن هذه المقولة تستجيب أيضا لدراسة التشكيل الجمالي لهذا الخطاب الذي توافق عليه الدرس النقدي بمسمى الشعريات، التي يشتغل عليها الخطاب استجابة للرؤى التجريبية لدى المبدع، ما يجعلها تختلف من مبدع إلى آخر ومن نص إلى آخر، لذلك “لم تكن الشعريات لدى جيرار جينيت ـ فيما يخص العتبات النصية ـ مجرد إجراءات شكلية، تبحث في التشكيل الجمالي الشكلي، وإنما هي إشارات، تنهض من العمق الجمالي لهذا التشكيل، الذي ينحو باتجاه تخصيب وتخطيب تلك العتبات، وبالتالي التعاطي معها كخطاب نصي له تأويلاته المنفصلة، والمتصلة بالنص / المتن، لتشكل القراءة حالة تخصيب لتلك الإشارات المحيطة، للكشف عن العلائق بينها وبين المتن النصي، الذي كان من قبل الشاغل الوحيد للحراك النقدي، والمدارس النقدية، والبحوث التي تتجه إلى التحليل النصي للخطاب الروائي، والخطاب الإبداعي بشكل عام.”[6]
ورواية «أول النهار» استجابت لهذا التشكيل الجمالي، بدءا بالعنوان الرئيس، مرورا بالعنوان الداخلي الذي يوسع دائرة العنوان الأول وصولا إلى العنونة المفصلية التي اتخذت من أسماء الشخصيات مسمى لها، إضافة إلى المفصلة المرقمة التي حولت النص السردي إلى بنيات صغيرة تستجيب إلى طاقة الكثيف التي أنشئت عليها هذه الرواية.
وبتوقفنا عند العنوان سنستكشف عبر مسارين المسار الأول هو العزل عن المتن والمسار الثاني هو الانفتاح على المتن، أما في المسار الأول فنجد أن العنوان «أول النهار»، يتألف من كلمتين (أول) و(النهار) أي من جملة اسمية خبرها محذوف، مفتوح أمام القارئ لاستدراج تأويله، عبر قرينة (النهار) المضافة إلى المبتدأ، حيث يشكل كتلة واحدة يتسرب معنى كل كلمة إلى معنى الكلمة الأخرى، ما يشي بحالة من الانبثاق من العتمة، وبداية الكشف، إضافة إلى بداية النص، الذي يوحي برؤى مفتوحة على التأويل، وإذا ما استعنا بالمناص المحيط الذي يتصل بتصريحات الكاتب نفسه، ندرك ما يعني «أول النهار» كفصول تمهيدية لعمل روائي، حيث يكمن الخبر في إمكانية إنجاز فصول تالية أي أجزاء لهذا النص المبتدأ، كما صرح بذلك المؤلف سعد القرش بقوله “فكرت في كتابة رواية عن قرية بعيدة عن العالم، يتمكن شخص أسطوري ـ بذكاء فطري ـ من إبعادها عن أنظار العالم، عن القرى الأخرى وعن الحاكم، بداية من 1800 قبل صعود محمد علي حتى وفاته 1849. ورأيت أن أكتب فصلا تمهيديا لما قبل 1800 فكتبت ثلاثة فصول تشكل رواية «أول النهار» (حيث تنتهي تقريبا عام 1800)” وهذا لا ينفي أن «أول النهار» هي رواية متكاملة في رؤيتها وفي بنائها الفني، وفي تجريبيتها، وإن أصبحت فيما بعد جزءا من ثلاثية أنجزها الكاتب، بالطاقة الإبداعية ذاتها.
أما المسار الثاني الذي نستقرئ فيه العنوان فهو بانفتاحه على المتن النصي، عبر عتبة تمهيدية أخرى وهي التي جاءت في أسفل الصفحة التي تلي العنوان،(مقطع من سيرة بلاد تخرج إلى النهار) ففي هذا المناص إشارة إلى توسيع معنى القرية التي تدور فيها الأحداث وهي قرية «أوزير»، التي تتسع حدودها لتسشمل البلاد، بل لتشمل العالم، إلى جانب الحلم الذي تنبني عليه وهو الحلم بالنهار، بالحياة في معاندة القدر السردي الذي يسير بها عبر نوافذ الموت التي تطل عليها في كل لحظة من لحظات انتباهها إلى الحياة، وهذا المناص هو تأويل للعنوان بشكل مكثف، لتكون الرواية تأويلا له بشكل أكثر تفصيلا، دون أن يكون هناك إسقاطات مباشرة للمقولة التاريخية، وإنما هناك إشارات وسعت معنى المكان والزمان لتدخلهما في مطلقهما، لتكون الرواية رواية قرية على حافة الزمن، وحافة المكان، تستدل على وجودها عبر طاقتها الكامنة لتنبثق إلى الحياة من الموت، وإلى النهار بعد الطمي، فالكاتب أراد أن يجعل العنوان الرئيس إشارة زمنية ليربطه بالمناص التمهيدي عبر المكان، ثم يربط الزمان والمكان بالمناصات الداخلية المرتبطة بالشخصيات حيث تتألف الرواية من ثلاث بنيات سردية كبرى معنونة على التوالي (عمران) (حليمة وهند) (عامر) كشخصيات تتمحور حولهم كل الأحداث، لتبدأ بعمران وتنتهي بعامر، مرورا بأم عمران المفترضة حليمة، وأم عامر الحقيقية هند.
إلا أن الكاتب لم يكتف بهذا التقسيم وهذه العنونة الصريحة، بل لجأ إلى العنونة المجردة المشار إليها بالأرقام بحيث يستمر هذا التقسيم متسربا على غفلة من العناوين الرئيسة، من البداية إلى النهاية من (1 إلى 49) وفي هذا التقسيم المستمر غير المنقطع عند حدود التقسيمات المفصلية الكبرى، إشارة أخرى إلى استجابة النص لقراءتين قراءة عبر الانتباه إلى التقسيم الأول وقراءة عبر الانتباه إلى التقسيم الثاني، ففي التقسيم الأول يختبر النص عبر التركيز على شخصيات رئيسة، وتحولاتها، وأثرها في تحولات المكان والزمان، وأثرها في مسيرة السرد، والقدر السردي، وفي التقسيم الثاني اختبار للنص عبر الشكل الفني الذي يستجيب إلى رؤية القصة القصيرة وكثافتها، إلى جانب الاستجابة إلى النقلات الزمنية عبر الحذف الزمني بين مقطع وآخر، واستجابة إلى تحقيق متعة التلقي والقراءة، دون خلخلة التماسك السردي، والتماسك النصي، والمفارقات الزمنية بطرفيها الاسترجاعي والإستباقي.
القدر السردي يتحرك بين نبوءتين:
تنفتح الرواية منذ صفحاتها الأولى على بؤر سردية، ومواقف وأسئلة قلقة، تفضي إلى خلخلة ذات القارئ عبر شحنه بفجوات مختلفة تنفتح في ذاته، ما يجعله أمام أفق انتظار يشده بأصابع من دهشة لمتابعة الحكاية، ليقف أمام نبوءة عمرها خمسون عاما، لغجرية، أسرت بها لحليمة الطفلة وقتها، ومازالت تفرد أشباحها في ذات الحاج عمران وحليمة التي تربى على يديها بعد أن هلك أهله إثر فيضان النيل.
ومن عناصر الشد والجذب التي يتبعها المبدع سعد القرش، أنه لا يوصل القارئ إلى يقين، وإنما يتركه معلقا على باب الحيرة، والقلق، وكلما أشار إليه بإشارة يظنها هي اليقين، يورثه حيرة أخرى، فمنذ الصفحات الأولى يعرف القارئ أن ثمة نبوءة ما تربك الحاج عمران، وتجعله في حالة انفعالية وغضب، وقلق من وجوده، وقلق من المستقبل، وكل ما يعرفه القارئ عن هذه النبوءة في البداية أنها نبوءة ملعونة، لتبدأ القصة باسترجاعٍ مداهُ الزمني خمسون عاما، حين انجذبت الطفلة حليمة ذات العشر سنوات وهي تلهو مع الطفل عمران، إلى قافلة لغجر راحلين إلى سمنود حل الليل فبكت والصغير لاه عنها بالاستجابة لمداعبة بنات الغجر، وفي الصبح جاء خبر موت أهل الدار جميعا بمن فيهم أبوها الخادم قالت لها غجرية وهي تقرأ طالع الولد:
ـ أنت أهله ياحليمة
لم تفهم البنت ولم ترد كما لم تستوعب خبر هلاك العائلة هزت العرافة رأسها
ـ لولاك لهلكتما مع أهل الدار حافظي عليه
ثم تضعه المرأة في حجرها وتمنحه صدرها فيستجيب للرضاعة إلى أن تفصح لحليمة الطفلة عن نبوءتها لهذا الطفل حيث قالت لها “هذا الولد من عائلة مشؤومة تحل بها كارثة كل خمسين عاما” أحست حليمة في تلك الليلة أنها كبرت وصارت أما لعمران”.
وحين ينتهي القارئ من هذه الأسطر القليلة التي أوجزت أحداثا وتحولات وتطورات ورؤى، يشعر أنه وصل إلى يقين بطبيعة هذه النبوءة وأن سير القدر السردي سيكون على خلفية تحققها، وهنا يأخذ السرد مسارات مختلفة في تأويل هذه النبوءة، التي أصبحت هاجسا مخيفا لعمران وحليمة رافقتهما طوال حياتهما، حيث “أن ما يجمعها أكبر من نبوءة ظلت سرا وكأنه موعد مع موت قريب”، ليجد القارئ نفسه أمام شق آخر من النبوءة التي يتحرك على خلفيتها القدر السردي، وهي أن “عمران مبتلى بالوحدة سيكبر وحيدا ولن يعيش له إلا ولد واحد”. وبالتالي تصبح هذه النبوءة هي المحرك للأحداث وهي المحرك للفعل، بل هي المحرك لتحولات الزمان والمكان والشخصيات، والكاتب لا يترك القارئ حرا من ذلك الهاجس بل يعود ليذكره دائما كلما سنح الموقف لذلك، بتلك النبوءة سواء عبر هواجس الحاج عمران أو هواجس حليمة، فنجاة عائلة الحاج عمران من الطاعون، لم تخلخل اليقين بالنبوءة التي أهلكت أهله كلهم في الطمي الذي أغرق القرى وآخرها قرية «أوزير» لينجو مصادفة مع حليمة وابنه مبروك وهوجاسيان العبد وابنته هند، حيث كانوا خارج أوزير في سمنود للإعداد لعرس ابنته، وبالتالي عاد إليه هاجس النبوءة وتربصها به، وبعائلته المتبقية.
فالقدر السردي الذي يتحكم به المؤلف، يتجاذب القارئ بين حيرة وأخرى، لتنهض نبوءة أخرى إثر موت مبروك ابن عمران في ليلة زواجه من هند ابنة هوجاسيان، وهي نبوءة المرأة الحلبية التي أسرت لحليمة بها في يوم ما في سوق الأربعاء، في سمنود وهي أن “هند بنت منحوسة لا يعيش من يراها عارية، حتى أمها ماتت بعد ولادتها بقليل” وهنا تربط حليمة بين موت أم هند وبين موت المملوك الذي رأى هند عارية تستحم في النيل، وبين موت مبروك لتدخل في هاجس آخر يتملكها وخوف آخر يتربص بها، دون أن تفضي بذلك الهاجس لعمران بل بقيت محتفظة به لنفسها، حتى عندما قامت بتوليد هند كادت ترفض ذلك لأنها عدته انتحارا ، لكنها استعانت ببعض الآيات وقامت بالأمر على خوف كامن في ذاتها من نبوءة الحلبية والربط بين العري والموت.
فالقدر السردي في رواية «أول النهار»، يتحرك بين نبوءتين، تتحركان على خلفية واحدة هي الموت، نبوءة الغجرية ونبوءة المرأة الحلبية.
وعلى خلفية هاتين النبوءتين بنى القرش روايته التي أنشئت منذ بدايتها على أفق انتظار يتجاذب القارئ يطول أحيانا ويقصر أحيانا أخرى، إلا أنها لا تترك فرصة للقارئ للتخلص من وطأة أي من النبوءتين كما أنها لم تترك أي من الشخصيتين حليمة وعمران لأن يتحررا من كابوسية تلك النبوءة، فأحيانا نرى أن النبوءة بدأت بالتحقق، وأن ثمة كارثة قادمة لتحل بعائلة عمران، ولكن ما نلبث أن نجد متسعا لوهم تلك النبوءة، وكذلك الأمر بالنسبة لعري هند فهناك من وقعت عليهم هذه النبوءة كأمها والمملوك الذي رآها عارية ومبروك ولكن هناك من رآها عارية وعمَّر كحليمة. هذا البناء السردي يجعل القارئ لا يلتقط أنفاسه وهو يتابع القدر السردي الذي يتحكم فيه الراوي، ليصبح الموت مرآة للحياة والحياة مرآة للموت عبر سؤال وجودي جدلي لا ينتهي، حتى آخر كلمة من الرواية، بل يبقى مفتوحا في ذهن القارئ وتأويلاته، فالقارئ لا يعرف متى يفاجئ الموت إحدى الشخصيات ولا يعرف متى تنبثق الحياة من لحظة الموت، وهذا ما كان في قصة زواج مبروك الذي مات في ليلة دخلته ولكن يكتشف القارئ بعدها أنه ترك جنينين في بطن زوجته، كذلك الأمر مع سالم ابن مبروك الذي قتل في صباحيته بعد أن ترك جنينين أيضا في بطن زوجته، ما يجعل القارئ أمام تأويلات لفعل الموت كقدر ولفعل الحياة كإرادة، وبالتالي يفضي إلى أن ثمة قدرا للمشيئة يخضع له القدر السردي أحيانا، رغم هاجس النبوءتين.
جدلية الزمكان وحركة السرد:
لا نريد الخوض في دلالات الزمان والمكان في السرد الروائي، لأن ذلك قد يشكل هامشا نقديا، وتنظيرا فائضا عن المتن النقدي الذي يشتغل على تقنية التخطيب لهذين العنصرين، فلكل خطاب سردي نظريته في الزمكان سواء من حيث المفهوم أو من حيث العلاقة الجدلية والتحولات التي يستدل عليها من خلال حركة السرد التي تعد المرآة التي تنعكس عليها حركة الزمان والمكان والأحداث والشخصيات، وبالتالي تستجيب القراءة للظلال المسقطة على مرآة السرد.
إن أول مواجهة مع التحولات كانت في الإشارة إلى طغيان المكان على المكان وذلك لتمهيد المكان السردي الذي ستنشأ عليها القرية الأسطورة، حيث طغى المكان المائي على المكان اليابس، فمحا ملامحه، وأغرق كائناته، دون أن يفقده الطاقة على الحياة، وبالتالي كانت القرية «أوزير» التي أغرقها الفيضان، وأغرق أهلها، هي المسرح أو الخشبة التي ستتحرك عليها الأحداث ويتحرك عليها الزمان وتنهض الشخصيات وتحولاتها، حيث التحول بالمكان كان مسقطا على التحول الزمني الذي كان المحرك للقدر السردي في النص.
فأحيانا يكون الزمان مرآة لتحولات المكان وأحيانا يكون المكان مرآة لتحولات الزمان، وبالتالي لا يمكن أن يكون الزمان حياديا كذلك الأمر بالنسبة للمكان المتجادل مع الزمان حيث “المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليا ذا أبعاد هندسية فحسب فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي بل بكل مافي الخيال من تحيز”[7] وبالتالي إن أوزير أصبحت بيتا للكائن الذي بناها، لتحمل ذكرياته وأحلامه ورؤاه، وآلامه، لتصبح ركنه في العالم حسب باشلار بل كونا حقيقيا بكل ما للكلمة من معنى، حيث المكان هو الذي يجعل الشخصيات والكائنات متماسكة جسديا وروحيا، وبالتالي تستطيع أن تترك أثرها على المكان والزمان، بالقدر نفسه الذي تتأثر فيه بحركة الزمان وتحولات المكان. فأوزير كانت كائنة في ذات كل شخصية من شخصياتها سواء المؤسسين أو الجيل الذي تلاهم أو الوافدين، لأنها كانت ذات أثر أسطوري على الذات، وعلى انفتاح روح الكائن عليها، وكأن الكاتب أرادها قرية يسكنها الكائن وتسكنه.
أما عن التحولات التي يمكن ملاحظتها على أثر المكان على تحولات الشخصيات فثمة إشارات كثيرة يمكن ملاحظتها على مرآة السرد، حيث يلعب تغيير المكان أحيانا بتحولات جذرية في الشخصية كما هو الحال في شخصية مروان، الذي انتقل من أوزير إلى سمنود، فانتقلت شخصية نقلة مختلفة، وتغيرت ملامحه، وتغير أفق تفكيره، وعندما عاد إلى أوزير استعاد بعض ملامحه الأولى، وكذلك الأمر بالنسبة لعامر الذي استجاب في غيابه عن أوزير بعد مقتل أخيه سالم إلى خيمة امرأة في مكان آخر مختلف فاختلفت شخصيته واستجاب لتحولات المكان والزمان، فأصبح وليا وله مريدوه، وسلطته، وعندما عاد إلى أوزير استجاب لأثر المكان الأول في شخصيته، وقد يلعب المكان وتغييره دورا في مصير الشخصية كما هو الحال مع مبروك الذي انتقل من الدنو إلى العلو، فكان المكان الجديد، سببا في تحول مصيره ونهايته، أما عن أثر الزمان فيمكن أن نلاحظه في التغيرات التي طرأت على شخصيات عمران وحليمه، وهند وعامر، سواء على مستوى البناء الجسدي للشخصية أو على مستوى البناء النفسي، فمثلا عندما عاد على الله القهوجي إلى أوزير بعد غياب سنين طويلة، يضعنا المؤلف أمام مرايا كقرائن لمرور الزمان وأثره على الشخصيات، وأول هذه المرايا هي قراءة على الله القهوجي لأثر الزمن في شخصية الحاج عمران “ثم تأمل القهوجي الحاج، ورآه قد اكتهل، وكاد يسأل رواد القهوة عن سنوات أضافت، في غفلة من الزمن، إلى وجهه خطوطا، تؤرخ لعمر من الشقاء والفراق” والمرآة الثانية/ القرينة الزمنية، هي في معرفته من الحاج أن سالم الذي قتل في صباحيته ترك جنينا أصبح شابا وتزوج، عندها ينتبه القهوجي إلى أثر الزمن في ذاته “فأفاق القهوجي على سنوات سرقت منه هو، ولم تسقط من ذاكرة الحاج” أما المرآة الثالثة فكانت عندما وجد ابنه منصور وقد أصبح شابا بعدما تركه لحما في لفة الهدوم.
بهذه التقنية العميقة في التعبير عن الزمن، يقدم لنا القرش جدل الزمكان في حركة الخطاب السردي، حتى كأن القارئ يشعر بأثر الزمن يتسرب إلى ذاته، من خلال اللغة التي شفت، فخفت، فتماهت في الزمن، كما تماهى الزمن في الشخصيات، سواء أكان بقرائن واضحة، أو بقرائن خفية، تدرك من خلال مسيرة القدر السردي في التحولات التي طرأت على كل شخصيات الرواية.
أما إذا توقفنا عند حركة السرد في استجابته للمفارقات الزمنية استباقا واسترجاعا، فإن لعبة المفارقات في هذا النص تعد إضافة جمالية إلى جمالية التخطيب الزمني في السرد الروائي، بل يمكن أن تحمل خصوصيتها ونظريتها في ذاتها، التي تنهض من حركتها الذاتية، حيث كانت تنفتح على شكلين شكل متصل بالشخصية ذاتها، بشكل مباشر عبر استرجاع لقطات من ماضيها، مازال لها أثر في حاضرها مثل استرجاع حادثة الغرق، ونبوءة العرافة، التي هي بذاتها تعد استباقا إذا أسندت إلى الحدث، واسترجاعا إذا أسندت إلى الشخصية، والشكل الاسترجاعي الثاني كان ينبثق على شكل محكيات مختلفة متصلة بموقف ما أو بحدث ما أو بشخصية ما، قد تنتهي دون أن يكون لها أثر في أحداث الرواية، وقد يستمر أثرها إلى فصول تالية ثم ينتهي، وبالتالي هي انبثاقات جمالية كقصص قصيرة مثل قصة سمعان الغجري، وقصة التحاق هوجاسيان وابنته هند بعائلة عمران، وقصة المجاعة التي عاصرتها حليمة قبل ولادة عمران بثلاث سنوات، وقصة المرأة التي زعقت على ناصية قريبة من دار المرأة التي ذهب إليها مبروك بعد ليلته الأولى الفاشلة مع هند، وقصة المرأة التي استقبلت عامر على مشارف سمنود حيث كان هائما يعاني من الجوع والعطش بعد موت أخيه سالم فأدخلته خيمتها فمنحته ما أنساه الجوع والعطش لتعلن بعدها أنه ولي من أولياء الله ليصبح له مريدون وتتغير حاله من حال إلى حال، فهذه المحكيات المنبثقة تحرك الزمن السردي عبر تشعبات قصيرة، ما يكسر الرتابة الزمنية.
ومن جمالية الخط الزمني في هذه الرواية أنه يوهم القارئ بتراتبه وحركته من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، إلا أن الأمر يختلف حين يُستقرأ الزمن في حركة السرد، فهو زمن متداخل، متشعب، يبدو بسيطا في مساره، إلا أن ثمة بنية معقدة ألبسته هذه البساطة الظاهرة.
وبالتالي كان سردا فائقا في حركته وسرعته، ولم يكن للاسترجاعات طالت أم قصرت أي أثر في إبطائه، وذلك لأن حيوية الاسترجاعات وأثرها في مسار الحكاية يجعلها حاضرة أكثر من كونها استرجاعا، وهذا ما دعا المؤلف لأن يعيد بعض الاستراجاعات أكثر من مرة وبأساليب مختلفة أحيانا بإشارة ما وأحيانا بسرد الاسترجاع كاملا، وأحيانا يضيف إلى هذا الاسترجاع إضاءات كانت مغفلة في سرده الأول مثل استرجاع نبوءة العرافة، التي كانت خيط القلق المستمر الذي ترك أثره على الشخصيات والمكان والزمان، وكذلك قصة موت مبروك، التي كانت هاجسا كابوسيا تلبس هند حيث كان حاضرا معها في كل لحظات حياتها، تسترجعه، كلما سنحت لها الحالة للتذكر، بمحفز من حدث أو شخصية، أو حتى بدون محفز.
وما ساهم في حركة السرد ورشاقته تلك الإسقاطات الزمنية أي الحذف الزمني الذي ينبثق بشكل مفاجئ أمام القارئ، حيث لا يشعر بها إلا من خلال بعض القرائن التي يشير إليها الكاتب بتحول على شخصية ما، أو بتحول على المكان، كما هو الحال في الحذف الزمني لخمسين سنة مضت من عمر عمران أشار إليها الكاتب دون أن نعرف تفاصيلها، ولكننا عرفنا الكثير من آثارها عبر مسيرة الخمسين السنة التالية، وكذلك الأمر في الزمن الذي انقضى على غياب عامر عن أوزير ما يقارب العشرين سنة لم نتعرف سوى على تفاصيل قليلة إلا أن الآثار الجذرية التي نستقرئها في شخصية عمران يمكن أن تشير إلى ما حدث في ذلك الزمن المحذوف، وكذلك الحذف الزمني للفترة التي غابها على الله القهوجي عن أوزير حيث قرأنا قرائنها في شخصية عمران وسالم الحفيد ومنصور كما تقدم وبينا ذلك. ولعل الحدف الزمني في رواية «أول النهار» مشغول بتقنية فائقة، حيث يترك بعض القرائن التي يستجيب لها القارئ كفجوة يمكنه ملأها بمخيلته التي تسربت إليها مخيلة الرواية ذاتها، فيكون مشاركا في تأليف النص ذاته، وفي اختبار طاقة التخييل لديه.
وإذا كانت تقنية المشهد الحوار في السرد الروائي، حالة يتوقف عندها السرد، لأنها انبثاق للحظة الحاضر بين شخصيتين أو أكثر، فإن المشهد الحواري في رواية «أول النهار» له خصوصيته، التي تداخلت مع حركة السرد، فأحيانا يقدمه المؤلف بأساليب مختلفة تارة يقدمه بشكل غير مباشر بنقل محكيات الشخصيات في داخل البينة السردية، حيث الفكرة للشخصية والمحكي للسارد، ما يجعلها تستجيب لحركة السرد، وأحيانا يكون في التمهيد لمحكيات الشخصية، وكأن السارد أو الراوي هو الذي يدير الحوار بينهما، وإذا توقف للحظة تاركا الشخصيات تستجيب لحوار مباشر، فذلك يشكل انبثاقات قليلة في المشاهد الحوارية تحمل حميميتها دون أن يشعر بها القارئ، لأن حركة السرد ما تلبث أن تنتبه فتعود إلى الإمساك بمحكيات المشهد الحواري وتخضعه لحركتها.
وفي النهاية يمكننا القول إن رواية «أول النهار» رواية الانتباه إلى حركة الحياة في لحظة انبثاق الموت فهي قائمة على ثنائية الموت والولادة وكأنها تبحث عن كينونة الوجود الإنساني وفي سؤال الموت الذي لا يقل عن سؤال الحياة، وذلك عبر سرد يشتغل على دهشة القصة القصيرة في كثافته وإشاراته الخاطفة التي يفاجئ بها القارئ ويتركه معلقا حتى يستجيب إلى النص لفك الإشارات التي تمثل أحيانا استباقا أو استرجاعا زمنيا طويل الأمد.
فسعد القرش الذي ينشغل بالإبداع كما ينشغل الورد بعطره، وكما ينشغل النهر بعذوبة مائه، ليصبح السرد لديه سردا لينا تستدرجه الرؤية النقدية فينفتح عليها عبر هذه الليونة التي تغرف من الحكي كما يغرف الفلاح بفطرته من ماء النيل، لأنه روائي يشغله الإبداع قبل كل شيء ذلك أن الرواية لدى سعد القرش تأويل لمتعة الإبداع وليست عملا واجبا بقدر ماهي عمل طارئ على الذات في لحظة اندهاشها بالعالم، فالإبداع هو الحالة التي لا يمكن توقعها وإنما هي استجابة لفجوة الذات وهي تبحث في أسئلتها الكامنة، التي تنفتح على أسئلة القارئ، فتورثه دهشة لانهائية.
…………….
* كاتبة سورية
(من ملف بمجلة “أدب ونقد”)
[1] سعد القرش، أول النهار، الدار المصرية اللبنانية، ط1 2005 ، والحائزة على الجائزة الأولى في مسابقة الطيب صالح 2011
[2] د. مصطفى ناصف ـ اللغة والتفسير والت واصل ـ عالم المعرفة ـ الكويت ـ العدد 193 ـ 1995 ، ص 9 ـ 10
[3] م ن ، ص 5
[4] جاستون باشلار ، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط4 1996، ص 25
[5] مصطفى ناصف ، م س ، ص41
[6] د. بهيجة مصري إدلبي، الرواية النسائية السعودية، العتبات وفلسفة الزمن، الملحقية السعودية، 2013 ، ص 17
[7] جاستون باشلار ، جماليات المكان ، م س ص 31