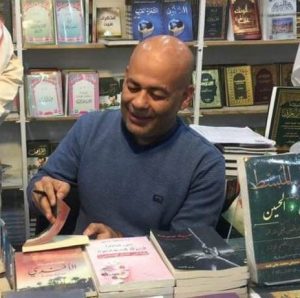إيمان بنداري
هي ليست عن الخيانة، أو اليأس، ليست عن الوحدة أو الحب.. عن الخوف، بالتأكيد عن الحب؛ ليبرأ مما ألصق به، أكتب؛ لأروي ما كان فعلًا؛ لأنني أخشى أن أنسى بعد فترة. تنبهت لذلك بينما كنت أشاهد التلفاز، كان المشهد يجسد سيدتين تنصح إحداهما الأخرى في شأن حبيبها، وعمرها الذي تحرقه في مدفأة الانتظار، وتستعجب كيف تصدقه، تنبهت، ورأيتني مكان التي تبكي على الشاشة.
أصطدم به مرة كل عام، وأقول له أحبك، وأعود لإعداد الطعام ومراقبة الحقائب المدرسية في الليل. ينال من قلبي كل مرة، وتؤلمني معدتي تمامًا في المنطقة التي يرتكز عندها كل التواء، وأنسى ما كان في غيابه حين أوقن أنه لا يحبني، يأتيني لألعق له جراحه، ويركن إليّ في انتظار أن يشفى موضع أظافر امرأةٍ غادرته في صخب وعنف. يتمتم في نومه أحبك، يشد السبت المعلق في حبل الغسيل، وتنتبه حواسي.
يشد قلبي فيصحو، يشد أيامي فتزهر، أقول لنفسي: لا يحبني.. أعلم. فيقول أحبك، فأصدقه؛ لأنني أريد أن يفعل. أراقبه بعيني الساكنتين في تعريشة من شحوم وأَوَانٍ.
صوته يرافقني في طريقي للعمل، أصير أكثر من (عملي).. أكثر قليلًا. في حجرة المدرسين أشارك في أحاديث الشجارات المنزلية، الأبناء والمذاكرة، “السيستم” الذي لا يعمل ولا يوصل الراتب، أشاركهم كل الأحاديث ولا أشاركهم به، يمكنني أن أشاركك ثلاث حكايات، ثلاث نساء، يمكنك أن تخمن مَن منهن أنا، مَن منهم هو.
بسذاجة الفكرة وبدائيتها، أقول: “أحببته منذ أول يوم وقعت عليه عيني”، بلحيته الخفيفة وعينيه التي لم ترني.
قد أكون سناء!
الأخصائية الاجتماعية، تشعل سيجارتها في شباك حجرة المدرسين الخالية، وتنفخ دخانها ببطء في شرود. أدخل فنتبادل تحية الصباح، امرأة بيضاء ذات قوام ممشوق، لم يلهُ به طفل كبالون دافئ، تخطت الثلاثين في انتظار زوجها الذي لا يعود، قالوا: مريض، معتقل، متزوج بأخرى، لم يكن أي هذه المزاعم حقيقيًّا، ولم يثبت خطؤها أيضًا. يدخل أستاذ علي، ينظر لي بتأفف بينما يأخذ غرضًا ما، أقصد ينظر لها، ربما تلاحظ خطأ في الضمائر من وقت لآخر وتشتبه في الحقائق، لكن لن تستطيع الجزم تمامًا أيها صحيح وأيها تزييف. حسنًا لنتفق إلى أي مدى يمكن أن تتعاطف مع زوجة وأُم تحب، تحب رجلًا غير زوجها؟! ذلك أمر يحتاج للكثير من الإبداع لكي لا تحكم عليّ، ذلك أمر مخيف جدًّا.
زوج سناء اعتقل لسبعة أشهر في المرة الأولى، بعد عودته كانت تقول إنه يبكي كثيرًا كثيرًا، حتى في نومه، ويصمت كثيرًا، يشرد ويلمسها بدهشة طفل يكتشف أُمًّا في نهاية عمره، احتضنته قدر ما كان يمكن أن يطول، بعد اعتقاله الثاني كان غاضبًا طوال الوقت، يثور لأتفه الأسباب ويتشاجر لأي سبب، شجارات لا تنتهي. ذات مساء خرج لشراء علبة سجائر ولم يعد، كانت تشعر أنه رحل، لم يُلْقَ القبض عليه في مدخل البناية، ولم يشِ به مخبر عند المنعطف آخر الشارع، تخفف هكذا ورحل، ولكنها فعلت كما تفعل النساء، من قسم لقسم، من مركز لبندر، ومن سجن لإشاعة ومن دليل لحفرة. تمامًا كما يجب أن يحدث، وتغير طريق العودة من العمل كل يوم علها تصطدم به في الشارع مثلًا، أو تراه يركب ميكروباصا من الموقف الكبير، ذاهبًا لمكان ما، أو عائدًا إليها، مثلًا.
بعد فترة جفت الشجارات العالقة بكل زوايا البيت، جف الضيق، الصراخ، عدم التفهم، الغضب، ولسعة الألم. اختفت رائحة دخان السجائر، ولم يظل سوى رائحة الحنين وبرد الغياب. أربعة أعوام من الانتظار، البحث، والخوف.
أو نجوى..
مدرسة الموسيقى، عملها يبدو مناسبًا لامرأة تحب، وتخاف في انتظار حبيبها، رومانتيكية الاسم ستجعله مناسبًا أن تكون ـ أكون، مدرسة موسيقى. غير أنه عليّ أن أخبركم أن المدرسة الابتدائية التي نعمل بها لا تحتوي سوى على أكسيليفون بحالة متوسطة، وطبلتين واحدة كبيرة وأخرى صغيرة، وأكورديون قديم ثقيل الوزن ذو أربعة مفاتيح مفقودة، ثقيل لدرجة يصعب معها على طالب صغير أن يحمله بمفرده، تخيل أي رومانتيكية ورهافة يمكن أن تستحضرها صورة طالب يرتدي حزام الأكورديون ويديه تلعب على المفاتيح التي سقط منها أربعة مفاتيح، بينما طالب آخر تتناوب يداه على حمله من الأسفل، فترى الأكورديون يميل من وقت لآخر بينما يبدل الطفل الآخر يديه، واللحن ينقطع!
نجوى، مدرسة الموسيقى التي لا تتحدث كثيرًا، وتنطق شُباك بضم الـ “ش”، ويخشى الجميع شجاراتها؛ لأنها تتحول فعليًّا لامرأة أقرب للسوقية منها للتعالي، تدير بيتها بنفس الطريقة، وتحكي أحيانًا لنا عن زوجها الذي لا يعرف كلمة لا، أمام دموعها. وكانت أسرع امرأة أعرفها يمكنها أن تذرف الدمع.
وقد أكون الست هناء..
هي “الست” بيننا جميعًا، “الست” ليست السيدة، أو المعلمة، ليست حتى “أبلة”، بملابسها الواسعة السوداء وجسدها النحيل.. جدًّا، بنظراتها المنكسرة بلا سبب واضح، ووجهها الذي يضيء لأيام بلا سبب معروف أيضًا.
سنوات عمرها التي لم تصل للأربعين ليست كافية لتكون “الست” هناء، لكنها لا تحكي كثيرًا عن حياتها سوى أنها تريد أن تبني بيتًا كبيرًا يومًا ما. لا تتدخل في شئون الآخرين، ولا تكون بأي شكل أول من يسأل سؤال: “ما الذي حدث؟”.
الست هناء التي تشي ملامحها الدقيقة بجمال ليس بقليل، تحب تربية الطيور، تمنحهم أسماءً وتواريخ ميلاد، ودورًا في حياتها التي لا نعلم عنها شيئًا.
تحتفظ في حقيبة يدها بصور لها بملابس بيت ملونة، وقصة شعر قصيرة، جريئة وطفولية جدًّا، وببغاء جميل يقف على كتفها، ينظران لبعضهما، وتلامس شفتها المبتسمة منقاره بفرح وبامتنان كما نرى في عروض السيرك تمامًا. تضع الحبوب يوميًّا على سور الدور الأخير في المدرسة، وعلبة ماء لإطعام الطيور. أظن أنها تضع مثلهم حيث تسكن، لكنها يجب أن تفعل ذلك مبكرًا جدًّا عن المارة حتى لا يظنون أنها مجنونة.
الست هناء لا تحب الأغاني، العاطفية خاصة، غير أن عينيها تقولان شيئًا لا نريد فضه، ربما لا نقوى عليه.
ثلاث نساء ربما يكون لكل منهنّ حبيب مجهول.. تخاف عليه ـ منه. ثلاث نساء قد يعرفن الخوف أو الانتظار، أنا أو هن، أو هكذا أراهن لأبرر خوفي. الخوف الذي نتربى عليه جميعًا، أو خوفي الخاص، خوفي من سطوة اسم العائلة، من اليوم، من الغد، وخوفي من جسدي، خوفي يزوجني لأول رجل بدين يتقدم لخطبتي لأطفئه. لأكتشف بعد الحياة المشتركة، من السنين والأبناء، الطباع التي تلين وتقسو، التي تختلف وتتنازل، أكتشف أن لي قلبًا أكبر من جسدي، وأن هذا ليس ذنب أحد، وأنه لا يتوقف عن النمو، وأقع في الحب بخفة ريشة تسبح، ترقص، أو حرة تسافر.
أرتدي للقائه ملابس جديدة، بألوان زاهية، ورقاقة سعر صادمة. أرتدي قلبي كإكسسوار فخم، أجلس قبالته فأتذكر، يبدو بعيدًا جدًّا، بينما عيناي تراه بوضوح، أشرب الماء في محاولة لتناسي عطشي، والأشياء التي أود فعلها به ومعه الآن، أتجاهل الرغبة في اللمس، بينما أرى كفيه تقترب وتبعد بينما يتكلم، أو أن أغمر شعره بأصابعي، أوقن أن ملمس كفه سيكون أشهى من الشوكولاتة، والخريف، وقطيفة الليل. أن ألمس وأرى وأحس، أحس وأتنفس، وأحيا.
يجلس أمامي متحررًا من نفسه، ألعق له جراحه جرحًا جرحًا؛ فينظر لي بامتنان حتى يغفو، يتمتم في نومه أنه يحبني، ويقترب المساء فننهض، بامتنان التحرر، ووحشة الفقد، وجحيم المعرفة.
أعود وأندس في سريري، تمنعني عدم قدرتي في تبرير بكائي للآخرين من البكاء، ينتابني أرق الليلة الأخيرة من الحب، إنني أعلم الآن، أتذكر، وأرى، وأعي. الصب تفضحه عيونه، لا يقول أحبك. أرى ذلك وأريد أن أتذكره عندما تحبسنا المسافات، وأريد ألا أنسى، أن أتذكر هذه الليلة ولا أبالي، أرى أنني نجحت.
ولكنني أحبه..