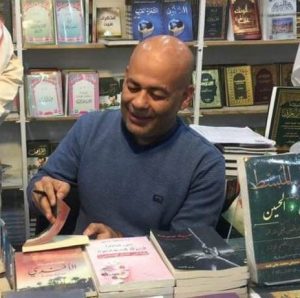ذات مساء كانت أبلة (هانم) المعلمة بمدرسة (ميت حدر) ووالدة (وليد بدير) زميلي في الفصل في زيارة لأمي بالبيت مع ابنها .. حينما أخذت (وليد) إلى غرفتي للعب، دار حوار في حجرة الصالون بين أمي وأبلة (هانم) حول ضرورة أن تكون لي مساحة من الحرية خارج البيت والمدرسة .. كان (وليد) يمتلك هذه القدرة على الوجود في أي مكان يريده دون قيود، وسمعت والدته تنصح أمي بأن تتركني أذهب مع ابنها إلى الاستاد، أو إلى قصر ثقافة الطفل، وأن أشاهد الدنيا، وأعرف الناس بعيدًا عن سجن الأسرة .. أتصور أن (حالتي) كانت واضحة للجميع داخل العائلة، وفي المدرسة، والشارع .. الخجل الشديد، والارتباك الهائل عند التعامل مع الغرباء، وأعتقد أنها لم تكن المرة الأولى التي تسمع فيها أمي هذه النصيحة من الآخرين، لكنني أظن ـ بسبب النبرة القوية لأبلة (هانم) التي كانت تصل إلى سمعي خارج الصالون ـ أنها كانت المرة الأولى التي تتخذ فيها النصيحة التقليدية هذا المستوى المرتفع من الإلحاح، والحسم .. بدا كأن أبلة (هانم) كانت تؤكد لأمي بطريقة ضمنية أن الأمر لم يعد من الممكن السكوت عنه، وأن معالجته لا تحتمل التأخير .. ربما كان هناك فرقًا مثيرًا للشفقة، وسهل الملاحظة بالفعل بيني وزملائي في الفصل، وربما كان من اليسير أيضًا إدراك أن هذا الفرق يتسع بمرور الزمن بحيث أصبح من الضروري حدوث تدخّل منقذ لوضع حد له .. أعتقد أيضًا أن هذه الفجوة بيني وأقراني التي استوعبها (الكبار) تجاوزت اللجلجة، واحمرار الوجه، والصمت العاجز عند وجوب الكلام إلى فضيحة مستقرة، تنمو طوال الوقت من الاختلافات الخطيرة التي تؤثر على ما يُسمى بـ (بناء الشخصية) .. كان الكثير من زملائي ـ خصوصا الذكور ـ خبثاء .. جادين .. أقل طفولية مما ينبغي، أو مما أتصور أنه بديهي .. سريعي الخاطر (وتلك الميزة ليست مرتبطة على الإطلاق بمستوى التفوق العلمي بل على العكس أغلب من كانت تتوفر لديهم هذه السمة على نحو واضح كانوا أقل التلاميذ كفاءة دراسية، ولهذا كانت الدلائل الواضحة لسرعة البديهة تتجسد خارج كل ما له علاقة بالتعليم، أو بشكل أدق داخل العالم الكبير المجهول الذي تقع المدرسة على هامشه) .. خبراء في الحياة .. منهم الأذكياء في ممارسة الشرور، وفي تفاديها، وفي ردها لو أصابتهم .. خفيفي الدم أحيانًا بطريقة ملفتة؛ إذ لم يكونوا مهرجين دائمين بالكيفية المضرة لكرامتهم، أو متصنّعي الكوميديا في الأوقات الخاطئة، وإنما كانوا في لحظات قليلة مفاجئة يغادرون جديتهم المألوفة، وغموضهم الرصين، ويخلقون دعابة غير متوقعة، غالبًا ما تكون مدعومة بجرأة الإيحاء الوقح، الذي لا يكشف عن بذاءة كاملة .. في نفس الوقت كانت تعطي اللامبالاة المتزنة التي تميز أساليبهم في خلق الدعابات رسوخًا إضافيًا، وأكثر حدة للهيبة ـ متعددة الصور ـ التي يصطبغ بها وجودهم .. كانت دعاباتهم تحفر بعمق أثرًا سحريًا في روتين الفصل، يجبر المعلمين والمعلمات ـ حتى أكثرهم وقارًا وعنفًا ـ وكذلك التلاميذ الآخرين ـ حتى أكثرهم كرهًا ونفورًا من صاحب المزحة ـ على الضحك ـ بقدر ضروري من الغيرة ـ بل والتفكير فيها، واسترجاعها في الأوقات التالية كذكرى تستحق الاستعادة، ونقلها أحيانًا لمن لم يشهد حدوثها باعتبارها هدية مباغتة، ومبتكرة يلزم تداولها .. أما أنا فكنت على الجانب المضاد أتحلى بذلك النوع الفاخر من الغفلة، التي يحكمها فراغ تام كان يجب أن تملؤه تجارب وخبرات مماثلة لتلك التي يمتلكها زملائي .. كنت ذلك الطفل التقليدي (“تربية البيوت” كما كانوا يقولون للإشارة إلى تكوينه المناقض للأولاد الآخرين “تربية الشوارع”) رغم انتمائي إلى نفس المنطقة الشعبية التي يسكنها أغلب زملائي .. كنت ذلك الكائن الصغير الذي تتوفر في طبيعته كافة الخصال المعروفة للسذاجة بوفرة فائضة، وكان هذا يجعلني مختلفًا حتى عن الأولاد الآخرين (المؤدبين والمتفوقين) مثلي؛ إذ كانوا هؤلاء يتصفون بالذكاء الاجتماعي ـ الذي لا يخلو من دهاء غير مُضر ـ وبفطنة الانعزال المحسوب، الواثق، بعيدًا عن مسارات الأذى المحتملة والطائشة التي يحتلها الأولاد (السيئين) .. كانوا أطفالاً عاديين، أي لديهم سلامة النية الشائعة في مثل هذه السن الصغيرة، والتي كانت تعرّضهم ـ منطقيًا ـ في بعض الأحيان لمضايقات نفسية وجسدية من (ذوي الأخلاق الفاسدة)، ولكن ردود أفعالهم كانت تتسم دائمًا بالتحفّظ والتعقّل، وبكثير من عدم الاكتراث، والأهم أنهم كانوا لا يعانون بسبب هوسهم بمصادقة من يضايقونهم .. كانوا ـ على العكس مما أكابده ـ لا يتلجلجون، ولا تحمر وجوههم وآذانهم دائمًا، ولا يصمتون حينما يجب أن يتكلموا .. لم تتحوّل سلامة النية في طفولتهم إلى وصمة مهينة .. كنا (أي الأولاد المؤدبين والمتفوقين) نشبه أطفال البرامج الصباحية، ومسلسلات وأفلام ومسرحيات الثمانينيات من حيث النظافة، والأناقة، ووفرة الأدوات والأغراض الدراسية، وسلامتها وجمالها، إلى جانب فصاحة اللسان التي كانت تتحوّل عندي إلى باعث للضحك والشفقة .. لكن بالطبع لم يكن يتوفر لدى أي منا ذلك النوع من الفهم الذي يدفع أحدنا عندما يتعرّض لمضايقة نفسية أو اعتداء بدني من أحد الأولاد (الأشرار) لأن يبتسم في وجهه بهدوء قاتل، ويخبره بمنتهى الثقة المدمرة أن العنف الذي يرتكبه دون مبرر ضد الأولاد المسالمين ليس إلا نتيجة طبيعية للبؤس الأسري الذي يعيشه، ولتعويض المهانات اللا أخلاقية التي يتعرّض لها في بيته، أو للانتقام من الرذائل والموبقات التي تحدث في نطاق عائلته .. لم تكن هناك قواعد أكيدة، أو حسابات قاطعة للانفصال بين هاتين الفئتين من الأطفال اللتين تمثلان ـ ظاهريًا ـ ثنائية (الخير والشر) .. كانت المسألة بعيدة عن الغنى والفقر، أو الرقي المهني ووضاعته؛ فمعظمنا كان من أبناء الطبقة الوسطى بتدرجاتها وتنويعاتها، وبالتقاطعات الغائمة لأطيافها، ولم يكن (حسن التربية) متعلقًا بالمستوى الوظيفي أو بدرجة الكسب المادي .. لكن ينبغي التفكير في أن موضوع (الانفصال) بحد ذاته يبدو أكثر طغيانًا في الطفولة، حيث الميل الفوري ـ الذي يعاند التراجع، وإن يسمح بسلوكيات غير خاضعة لصلابته أحيانًا ـ لتصنيف الآخرين ـ ولو بحسب ملامحهم ومظهرهم الخارجي ـ وتوزيعهم دون تفاوض على العالمين المتباعدين: الأبيض والأسود.
لو أردت تحديد كلمة واحدة لوصف علاقتي بأقراني في الفصل، وفي الدرس الخصوصي الوحيد الذي أخذته طوال المرحلة الابتدائية في الصف السادس عند الأستاذ (عاشور) الذي كان يسكن في شقة بالدور الأرضي داخل شارع جانبي أمام سينما (ركس)؛ ربما ستكون كلمة (الادعاء) هي الاختيار الأنسب: ادعاء الخبث .. ادعاء الجدية .. ادعاء المعرفة .. ادعاء القوة الجسدية .. ادعاء الدهاء اللا أخلاقي .. ادعاء الصلابة النفسية .. ادعاء الصداقة بأقراني.
أظن أن هذه الادعاءات هي صاحبة الفضل الأساسي في تحويل الغفلة من مجرد حالة إقصائية، تنطوي على آلامها الخاصة المحدودة في نطاق التوحد الطفولي إلى مهزلة كوميدية حاضرة، ومتجددة طوال الوقت من الإذلال الرائج .. تحويل السذاجة من إنزواء مقفل للهموم الصغيرة إلى تراكم متداول، شبق، ومضحك، للجروح المغرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدرت مؤخرًا عن الهيئة العامة للكتاب.