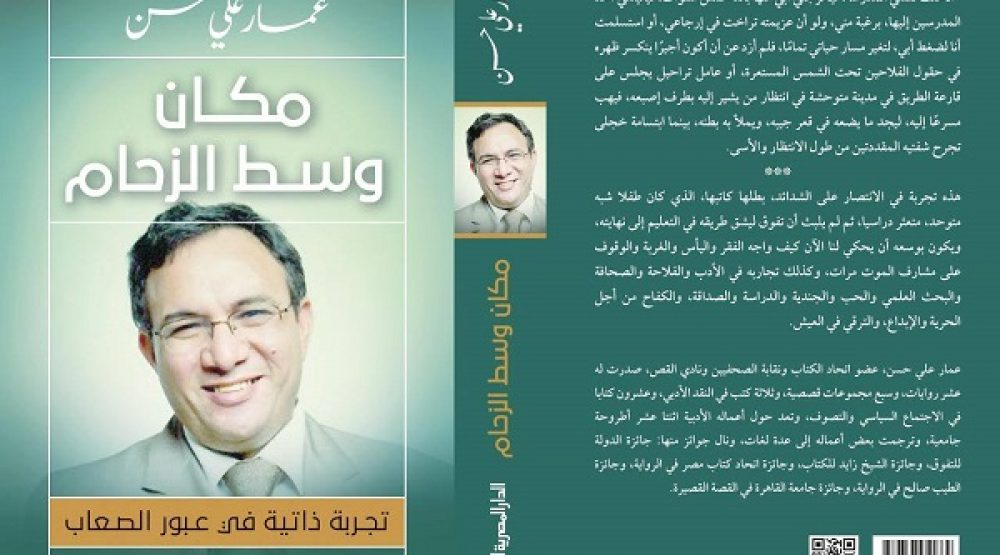سعيد نصر
ينقسم كتاب “مكان وسط الزحام.. تجربة ذاتية فى عبور الصعاب”، للدكتور عمار على حسن،إلي ثلاثة أجزاء،هى (طفل كبير ،صيد الحكايات،علم وعمل)،وتقوم فكرته الأساسية، والتى هى محور ارتكاز الأجزاء الثلاثة،على أن الكاتب فى كل محطات حياته الدراسية والعملية وتجاربه الحياتية والعاطفية والبحثية والسياسية، يعتمد على نفسه،و يطوع كل شىء وينتصر بإرادة حديدية على كل الصعاب، ويتعامل مع الظروف المحيطة المعاكسة له بنزعة التمرد الإيجابى التى تعلمها فى طفولته وشبابه من أبيه،ويستغل كل لحظة فى حياته،منذ طفولته وحتى الآن ،فى قراءة الكتب والقصص والروايات،ويضحى بفرص مربحة أكثر بكثير،منها مناصب رفيعة، لكى تبقى فيه روح الكاتب والأديب والروائى، مدفوعا فى ذلك، بنبؤة مدرس اللغة العربية التى قال له فيها:”سيصبح صوتك مسموعا”،وهى نبؤة سمع جده لأمه مثلها من رجل صوفى ، حيث قال له: “لا تخف عليه، سيكون رجلًا يسمع منه الناس.”
ويحكى الكاتب فى “طفل كبير” كيف أنه تحدى رفض أبيه وأدخل نفسه المدرسة بنفسه،وتحدى لدغة لسانه الرائية وعالجها بنفسه، وتغلب بثقته فى نفسه على مرض عسر الكتابة (dysgraphia) “، بأن أصبح يكتب الحروف معدولة بعد أن كان يكتبها بالمقلوب،ويصف لحظة دخوله المدرسة فى أكتوبر 1973، بأنها الأشد تأثيرا فى حياته، لكونها المحطة الأولى التى لولاها فى الصغر،ماأصبح كاتبا مسموعا وشخصا مرموقا فى الكبر،ويتذكرها لما فيها من مشاهد محفورة فى ذاكرته إلى الأبد،منها مشهد إخراج المدرس له من الفصل لعدم وجود اسمه فى الكشف، حيث يقول:لكننى رميت جسدي على عتبة الفصل، ورحت أصرخ في حرقة، ودموعي تسح على خديَّ ساخنة. فلمَّا وجدنى مستشبثًا بالبقاء، أوقفنى، وربت كتفيَّ، ورأيت فى عينيه شفقة عميقة، وقال لى:تعال معى.”، ومنها أيضا مشهد ضرب ابن الجيران له بحجر فى رأسه، وذلك لربطه بين هذه الواقعة وبعض أعراض مرض التوحد التى عانى منها فى طفولته.
ويقول الكاتب أن قلب أبيه رق له وسعى لإدخاله المدرسة بوساطة عضو بالاتحاد الاشتراكى لإعفائه من شرط السن، ويؤكد
أن جده لأمه لعب دورا كبيرا فى حياته، ففى بيته عرف السكينة والحنان، وتعلم مهارات الحساب، وأنصت إلى المذياع، ووجد التشجيع اللفظى والعملى لاستكمال دراسته، وكان لتزامن وفاة جده فى عام 1985 مع نجاحه فى الثانوية العامة وحصوله على المركز الثانى بمحافظة المنيا أثرا كبيرا فى نفسية الكاتب، ولم لا؟ فالذى كان يساعده ويشجعه قد مات وهو على أعتاب الدراسة الجامعية، ولو كان قد ظل على قيد الحياة ما استطاع أن يخالف رغبته فى إدخاله كلية الحقوق.
ويكشف الكاتب عن أحد أهم أسرار تمترسه دائما مع الحق من خلال المعارضة المتزنة والموضوعية، ويتمثل فى نزعة التمرد الإيجابى التى ورثها فى طفولته من معارك أبيه فى الحق،وشجاعته التى مكنته من صد رجال قرية بأكملها لاتقانه لفن لعبة العصا،ويستدل على ذلك بأنه تمرد على رغبة أبيه فى ضمانه تعيينه السريع من خلال إدخاله مدرسة المعلمين عقب نجاحه بتفوق فى الإعدادية، وأصر على الالتحاق بالثانوية العامة، وبعد نجاحه فيها بتفوق، تمرد على رغبة أبيه فى ضمان تعيينه من خلال إلحاقه بكلية التربية بالمنيا، وأصر على الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى القاهرة،حيث يقول:” وكان رأيه أنه لا قبل له بالإنفاق على غربتى. تأثرت بحديثه ساعات، لكن سرعان ما طردته من رأسى،وقلت لنفسى:تمرد إيجابى جديد لا بأس به….. وقلت لأبى:لن أكلفك شيئَا،فأنا أعرف أن حملك ثقيل.”
وفى مقام آخر بالجزء الأول، يحكى الكاتب أن نزعة التمرد الإيجابى المصحوبة بالطفل الذى بداخله، تسببت له فى واقعتين تعرض فى إحداها لشبح الرفت من المدينة الجامعية، بسبب تمسكه بحقه فى الطعام رغم ضياع بونه، وفى الأخرى للرفت من الكلية،بسبب انتقاده للتربح من وراء منح الطلاب الخليجيين لدرجات علمية لايستحقونها، ولكنه نجا فى الأولى باعتذاره لموظف المطبخ، ونجا فى الثانية بسبب تعاطف الدكتور أحمد الغندور عميد الكلية معه، ووقوفه إلى جانبه ضد بعض رؤساء الأقسام.
ويضطر عمار للإنفاق على دراسته الجامعية إلى العمل فى بنايات المدن كعامل تراحيل، ولم يكن هذا الشقاء جديدا عليه فى شبابه، فقد عمل فى دريس القمح ورى الأرض فى صقيع الشتاء،و اضطر للعمل بالفأس فى حقول الآخرين بقريته فترتان كل يوم ، ماعدا حقول الأغنياء،وذلك للحفاظ على صلابة وعزة أسرته التى افتقرت بعد غنى، وكعامل “دودة” فى طفولته لتطهير القطن من الدود، ورى الأرض مع أبيه بالطنبور، وبيع الخضار فى قرية صفط اللبن، وكعامل تراحيل فى فترة الإعداية.
ويكشف الكاتب عن بعض تفاصيل ثنائية شقاء الكدح ومتعة القراءة فى حياته، فيقول:لم يكن الكتاب يفارقني في ساعات العمل بالحقل، فأختلس ساعات راحة، أو حين تذهب عينا أبي عني، فألتهم السطور، ويقول أيضا :”كما أننى لم أنس فى كل رحلاتى تلك سعيًا وراء الرزق الكتب، إذ كنت أضع في حقيبة ملابسي روايات ومجموعات قصصية وكتبًا في مختلف ألوان المعرفة، أنظر إلى سطورها قبل النوم على ضوء مصباح خافت، أو فى الوقت الذي نجلس فيه منتظرين على قارعة الطريق، مع عمال التراحيل، قدوم أي من مقاولى الأنفار”، ويقول فى مقام أخر:”ولم يكن الكتاب يفارقنى حتى فى الحجرة الوسعية المستطيلة التي كان أهل قريتنا يتخذونها مقهى، يقضون فيها ساعات ليل من المرح بعد يوم عمل شاق.” كنت ألقى على الرقعة لمحة خاطفة بعد أن ينقل أحدهما أي من القطع، ثم أعود لأدس عينى فى كتاب معى، غالبا ما يكون رواية أو مجموعة قصصية أو ديوان شعر، ألتهم السطور، فتُطوَى الصفحات أمامى.”،ويقول فى مقام ثان :”ولم يكن الكتاب يفارقنى أيضًا فى الساحة التى نلعب فيها كرة القدم بعيد عصر كل يوم فى قريتنا.”
ويحكى الكاتب عن هوسه الفطرى والمكتسب بالكتب الجديدة والقديمة وشرائها من سور الأزبكية والمطابع ودور النشر، وأماكن أخرى، حتى صار لديه مكتبة فى قريته،كانت هى النواة لمكتبته الحالية الكبيرة بالقاهرة ، وقد دفعه لعمل ذلك حبه الشديد للقراءة منذ طفولته، حيث قراءته للكتب التى كان يبع جده فيها السلع التموينية، وللكتب فى مكتبة المدرسة الإعدادية بقرية البرجايا، حيث يقول:ذهبت إلى المكتبة في أول أيامي بها، وكان أول ما استعرته منها هو سيرة “حمزة البهلوان”، وعلى ضخامتها قرأتها في أسبوع من ولعي بها، ثم بدأت رحلة استعارة روايات كبار الكتاب المصريين والعرب، حتى أنني قرأت لكثيرين منهم كل ما كتبوا تقريبا.”وفى ذات السياق، يحكى الكاتب فى مقام أخر:” كنت، ولا زلت، اعتبر المعرفة قوة في وجه الطغيان والتسلط، وتملكني حرص شديد على ألا أنقطع عن القراءة تحت أي حجة أو ذريعة أو قانون. ولهذا حولت غرفتى فى كتيبة للدفاع الجوي التى انتقلت إليها بعد تخرجى “ملازم ثان” بصحراء السويس إلى مكتبة صغيرة، كانت فيها كتب متنوعة.”
ولم تمنع القراءة فى الصغر الكاتب من اللعب مع أقرانه ، أو تجاهل طقوس العيد فى قريته، ولكنه كان ينعزل عن ألعاب بعينها،بسبب انشغاله بنبؤة البعض له بأنه سيكون كاتبا كبيرا،حيث يقول:”وكنت أفضل الاختلاء بنفسى ساعات فى حديقة جدي، لأغرق فى أفكار خيالية كانت تأخذنى من نفسى، وكان يتملكنى وقتها شعور غامض بأن لى دورًا ينتظرنى فى هذه الحياة، عليَّ أن أسعى خلفه ولا أضل الطريق.”، ويكشف عمار عن سر أخر بخصوص عشقه للقصة والرواية،حيث يقول:”كنت أتغيب كل خميس تقريبًا لدخول السينما، حتى فى السنة الثالثة م الثانوية العامة غبت تسعة وعشرين يومًا، وكلها كانت من أجل عيون الحكايات والصور.”
ويحكى عمار كيف أن اعتياده على تحمل المسئولية كلفه الكثير فى حياته، منها حرمانه فى السنة الأولى من السكن بالمدينة الجامعية الأم رغم أحقيته فيها، وحرمانه منها فى بداية السنة الثانية حتى دخلها بالتماس،وقضائه يومين كاملين جائعا فى شهر رمضان بالمدينة الجامعية بإمبابة،بسبب غلق الطعم وعدم وجود فلوس معه،حيث يقول:”تحملت جوع الصيام بالنهار والليل على ذل السؤال”،وقد ساعدته على ذلك نزعة الزهد الصوفية، ويتذكر الطعام الشهى فى بيت جده، والطعام العادى فى بيت أبيه، ويسترجع التغذية المدرسية لطلاب المدارس، ويكشف أهميتها القصوى لهم ولأسرهم فى ذلك التوقيت.
ويؤكد الكاتب أنه كاد يرسب فى مادة قاعة البحث بسبب تمرده الإيجابى على دكتور كان حاقدا وجاهلا فى نقده لكتابات لويس عوض،واختلف معه لهذا السبب، وكان يرفض الدروس الخصوصية ، والطرق العقيمة فى التدريس أثناء المرحلتين الإعدادية والثانوية، ويكشف أن تلك النزعة لازمته أثناء تأديته الخدمة الإلزامية كضابط احتياط، ويؤكد أنه كان يتصرف مع الجنود بدوافع إنسانية وتسبب ذلك فى غضب قياداته العسكريين منه، وكان يتم حجزه فى المعكسر والكتيبة وحرمانه من الإجازة بسبب تمرده الإيجابى ،حيث يقول:”وفى يوم أراد أحد صف الضباط أن يعاقبنى بطريقة مهينة، فرفضت الانصياع له، وقلت له:لا يمكن لمن قرأ آلاف الكتب أن يُهان هنا.”
ويشيد الكاتب بالحياة العسكرية لأنها أكسبته اللياقة البدنية وقوة التحمل، ويقول فى رده على سؤال لقائد كتيبته، :” بلى، علمني الجيش الكثير، وأنا مدين له، ففي كلية الضباط الاحتياط تعلمت من العلوم العسكرية ما لم يكن بوسعي أن أتعلمه لو لم أخض هذه التجربة. وتعلمت الانضباط، والوصول إلى الهدف من أقرب طريق، وتعملت قوة التحمل، والعمل تحت ضغط شديد، وإدارة أزمات متلاحقة. وتدربت على السلاح، وأشرت من النافذة إلى المدافع الواقفة فى مرابضها، وإلى مخزن الذخيرة المدفون تحت الأرض، وقلت له:وقعت على استلام عهدة بملايين الجنيهات.”
ويحكى الكاتب أنه نجح فى مهمة فشل فيها قائد كتيبته، وأعاد جندى خطير على الأمن إلى الكتيبة بعد هروبه منها، وأعاد جندى أخر بلطجى عقب محاكمة عسكرية له، كان يظن الجميع أنه سيهرب لا محالة، ويؤكد أنه كان عادلا فى تعامله مع جنود سريته، وكان متواضعا معهم كأخ لهم، وأنهم كانوا يحبونه لهذا السبب،وأنه تأكد من حبهم له قبل توديعه لهم بإصدار أمر عقابى لهم نفذوه جميعا عن طيب خاطر،ويكشف تفاصيل استدعائه والظروف الملابسة له.
ويقول الدكتور عمار على حسن ، أن أيامه الأولى فى القرية طبعت فى نفسيته وعقله خمس بصمات ظهرت على سلوكياته فى حياته الجامعية والعكسرية والعملية المدنية،هى:(الطفولة الدائمة، وعزة النفس،والميل إلى مجالسة الكبار، والصرامة فى الحق، وعدم مد يده إلى ما ليس له)، ويربط بين التعفف والكبرياء كصفة لازمته فى حياته العملية وبين مظالم كثيرة تعرض لها، كالتنكيل به بنقله من قسم إلى أخر، وحرمانه من مكافآت وحوافز، وخصم من راتبه وتهديده بالرفت،وترتيب رؤسائه لتنفيذه، وذلك عن طريق موظف اعترف له بذلك وهو على فراش المرض بالسرطان، وسامحه الكاتب.
ويحكى الكاتب أن خصلة الصرامة فى الحق شكلت مواقفه من الانتخابات، حيث كان يرفض الترشح فى أيا منها، وعندما ترشح للجنة النقابية بوكالة أنباء الشرق الأوسط كان هدفه رفع الوعى وكشف الفساد بها، وعندما ترشح لمجلس نقابة الصحفيين فى 2003 ، كان هدفه انتهاز فرصة الانتخابات لرفع الوعى، وفضح الفساد، وتعزيز تيار الرفض ثم إيصال أكبر عدد منه إلى مجلس النقابة، ويتحدث الكاتب عن مشاركته الفاعلة والمسئولة فى ثورة 25 يناير 2011، وتصويته لحمدين صباحى فى انتخابات 2012، وإبطاله لصوته فى انتخابات الإعادة بين شفيق ومرسى،ويؤكد أنه لم يصوت للمشير عبدالفتاح السيسى فى انتخابات 2014، ورفض أن يكون عضوا فى حملته الانتخابية، ويقول:” ولم أصوت لصالح المرشح الذى اكتسح انتخابات الرئاسة لسنة 2014 المشير عبد الفتاح السيسى،ورفضت أن أنضم إلى حملته بدعوة من أحد قادتها البارزين، وأعطيت صوتى لصباحى، رغم أننى نصحته بألا يخوضها أصلًا، بل دعوت السيسى إلى أن يظل وزيرا للدفاع، لأننى كنت مؤمنًا بأن مصر لن ينهض بها إلا رجل مدنى.”
وعلى الرغم من أن موهبته فى الحكى و السرد قد تبدت له من خلال قدرته الكبيرة على الخطابة فى المساجد والمآتم وسرادقات العزاء،إلا أنها تأكدت لديه أكثر عندما قرأ فصل من قصة على تلاميذ الفصل فى غياب المدرس وطلب منه أحدهم بأن يكمل الحكى لحلاوته، حيث يقول:” ربما فى هذه اللحظة تعلقت نفسى بالقصص، فبدأت معها قارئًا، ولا أزال،ثم انتقلت إلى كتابتها بعد تخرجى فى الجامعة، ولهذا قصة أخرى.”
ويحكى عمار أن إقدام والدته على حرق يده لأنه أخذ بصلتين من أرض الجار، دون إعلامه بذلك، أثر بشكل كبير على سلوكياته، وكان سببا فى عدم أخذ دواء من الكتيبة لصديق مدنى مريض ولايجده فى الصيدليات المدنية، وكان سببا أيضا فى كتابة قيمة حقيقية لبدل انتقالاته لتغطية المؤتمرات، فى حين كان أخرون يبالغون فيها ، ويقدرونها على خلاف الحقيقة والواقع بعشرة أضعاف.
ويتحدث الكاتب أنه تعرض للموت مرات كثيرة، وفى كل مرة كان ينجو منه ، كان يعتبر نجاته فرصة جديدة لترك علامة على الأرض،ففى المرة الأولى كاد أن يموت غريقا تحت قنطرة على ترعة،وفى الثانية كاد أن يموت نتيجة خنقه من جانب صديق له،عندما كانا يستحمان ويلعبان لعبة الشبكة والقرموط، وفى الثالثة كاد أن يموت غريقا فى النيل بعد أن لفت بقعة من الحشائش على خصره، والرابعة كاد أن يموت بسبب انفجار الزائدة الدودية وتعفنها داخل بطنه، والخامسة كانت بسبب غلق باب النفايات عليه بالعمارة التى كان يسكن فيها بأبوظبى، وفى السادسة كاد أن يموت بسبب هبوط حاد فى شقته القديمة بالمنيل، وفى السابعة كاد أن يموت بسيجار الأستاذ محمد حسنين هيكل، لعدم درايته بكيفية تدخينه، بالإضافة إلى تعرضه للموت خمس مرات أثناء ثورة 25 يناير.
وفى الجزء الثانى من الكتاب، وعنوانه”صيد الحكايات” يكشف الكاتب النقاب عن الأشياء التى أثرت عليه فى الصغر وجعلته ميالا للسرد والحكى فى الكبر، وجعلت علاقته بالرواية ثلاثية الأبعاد، “سامع وقارىء وكاتب”، حيث استمع، عندما كان طفلا صغيرا، من أبيه حكايات حافلة بالقيم النبيلة والفروسية مثل السيرة الهلالية وشاور وضرغام وعلى الزيبق وأدهم الشرقاوى وقصص ألف ليلية وليلة ،واستمع من خالته الصغرى حكايات شعبية كانت متداولة فى الصعيد، وبعدها اعتمد على نفسه واستمع للسيرة الهلالية من عبد الرحمن الأبنودى وجابر أبو حسين فى إذاعة الشعب ، وتزامن ذلك مع تعلمه من خالته الكبرى اللحن الشجى، ويقول الدكتور عمار:” فى كل مرة أبدأ كتابة رواية جديدة يرد على ذهنى شخصان، أبى فى حقله، وسيدة الحافلة.”، وهى سيدها وجدها بالصدفة فى إحدى الحافلات، وهى تغزل تريكو ،ويقول عنها:وقفت أتابع دأبها فى شغف عميق، وتعلمت منها أن تراكم القليل يصبح كثيرًا، وتتابع الصغير يجعله كبيرًا. وقلت لنفسى وأنا واقف أمامها مشدوهًا: حرف وراء حرف، تولد كلمة، وكلمات تصنع جملة، وعبارات تصبح فقرة، وفقرات تصبح صفحة، وصفحات تصير فصلًا، وفصول تتتابع تخلق كتابًا. ومن يومها كلما بدأت فى كتابة رواية تأتينى صورة هذه السيدة، ممتزجة بصورة أبى مع فأسه أمام الأرض اليباب.”
ويؤكد أن نظم الشعر الحر استهواه بعد التحاقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،ولكنه لم يأخذه من القصة، وظل يستعيد نبؤة مدرس اللغة العربية فى الصف الثانى الإبتدائى، عندما قال له:”سيصبح صوتك مسموعا”، وكان الأدب سابقا على انشغاله بالبحث السياسى وليس لاحقا له،ففى عام 1988 فاز بالمركز الأول فى مسابقة نظمتها المدن الجامعية، ونال مكافأة ثلاثين جنيها عن قصة رمزية عن النضال السلمى الفلسطينى من أجل الحرية، وفى شهر فبراير 1990، تحدث فى ندوة أدبية بمبنى نقابة الصحفيين القديم، وكانت أولى محاولاته لنشر كتاب هى محاولة نشر مجموعة قصصية،فى سلسلة إشراقات أدبية، ولكنها لم تر النور، وفى فى سنة 1997 نشر كتاب”الصوفية والسياسة فى مصر”، وفى 1998 نشر مجموعته القصصية الأولى “عرب العطيات، وبعدها بثلاث سنوات صدرت روايته الأولى “حكاية شمردل”.
ويقول الدكتور عمار على حسن :”وبلغ انشغالى بالأدب حدًا كبيرًا لدرجة أننى طوعت له دراستى للدكتوراه، فجعلتها عن “القيم السياسية في الرواية العربية” مدفوعًا بالرغبة فى معرفة الرواية بنصها ونقدها أكثر من معرفة السياسية بتصاريفها وأحوالها.”،ويؤكد أن قصصه وراياته لايطغى عليها المضمون السياسى، باستثناء رواية السلفى، بدليل أن أبطال قصص”عرب العطيات” من المهمشين، وأبطال مجموعة “أحلام منسية” من الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعصيبة وإعاقات ذهنية، وشخصيات مجموعة “التى هى أحزن” متنوعة من الريف والمدينة أيضًا، وبها قصة طويلة تحمل عنوان المجموعة عن سيدة رومانسية تعانى مع زوجها المتبلد الغشوم فتطلب الطلاق منه لتبدأ مأساة جديدة، وقصص “حكايات الحب الأول” عبارة مائة قصة وأقصوصة شاعرية عن تجربة الحب الأول.
ويصف الكاتب نفسه بأنه أديب درس العلوم السياسية وانخرط فيها كناشط سياسى ومحلل سياسى،ولكنه قادر على الفصل بين الأديب والسياسى فى الكتابة، ويقول : أنا حريص في كتابتي الأدبية على أن تكون البنية الجمالية للغة والتخيل حاضرين بشدة ،وهى نوع من الكتابة يختلف فى الأسلوب وليس فى المضمون عما أكتب فى دراساتى الاجتماعية والسياسية” .
ويوفق الكاتب بين الباحث والصحفى والأديب باستخدام ما يسميه بـ “نظرية الترانزستور”، أى كتابة أكثر من شىء فى توقيت واحد، وهو ماجعله قادرا على كتابة 3 أنواع من الكتابة فى آن واحد، أثناء أثناء عمله باحثا بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجة فى أبوظبى خلال الفترة من 1998 إلى 2002 ، ويؤكد مرارا وتكرارا على أن الكتابة التى بقيت معه ولم تبلى مع الأيام هى الكتابة الأدبية، على الرغم من أن الإغراءات المعنوية والمادية للكتابات الأخرى فى البداية كانت أكثر.
ويكشف الكاتب أنه ضحى بوظيفته فى وكالة أنباء الشرق الأوسط وبفرص كثيرة أخرى من أجل التفرغ للأدب، ويقول :”وقد أدركت ذات يوم أن عدم تفريطى في أعطية الأدب أو موهبته كان قرارًا سليمًا حين قال لى المفكر السياسى الراحل د. محمد السيد سعيد بعد أن قرأ مجموعتى القصصية “أحلام منسية”:أنا أغبطك، فأنت فعلت ما ندمت أنا على عدم فعله.”، ويقول أيضا فى هذا الصدد:”وأتذكر هنا ما قاله لى المفكر والناقد الكبير الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيرى حين قابلته فى ندوة عن مسيرته عقدت بدار الحكمة عام 2005، وكان قد قرأ بعض مقالاتى: يعجبنى أسلوبك فى التعبير عن أفكارك وتصوراتك، وأتمنى لو كان لى مثله.”
ويؤكد الكاتب فى “صيد الحكايات” أنه كان بوسعه أن يكون قريبا من نجيب محفوظ، وأن يكون من شلة الحرافيش، بعد أن دعاه لذلك الفنان التشكيلى الراحل المهندس محمد الشربينى،وذلك بعد قراءة محفوظ لمقال مطول له بعنوان “التجليات الاجتماعية فى أدب نجيب محفوظ”، ويكشف السبب الحقيقى الذى دفعه لرفض ذلك، على الرغم من فرحته الكبيرة به، حيث يقول:”غمرتنى فرحة، وهممت أن أوافق إلا أنى تذكرت عبارة كانت شائعة فى تلك الأيام وهى “جمعية المنتفعين بنجيب محفوظ” فجفلت، وتحول إقبالى إلى إدبار.”
ويقول عمار عن نجيب محفوظ :”ربما لم يعجبنى فى محفوظ صمته حيال ما كان يجرى فى داخل بلادنا من فساد واستبداد، وقلت فى نفسى إنه قد اكتفى بما أورده فى رواياته وقصصه من مواقف، وتذكرت ما قاله عنه غالى شكرى واصفًا إياه بأنه “أجبن إنسان وأشجع فنان”، وهى مسألة فصلت فيها حين كتبت مقالًا مطولًا عن نجيب محفوظ بعنوان “المتحايل” ضمن عدد خاص أصدرته مجلة “الهلال” العريقة تحت عنوان “عش ألف عام”، لكننى أكبرت فى محفوظ زهده وأدبه الجم وإنسانيته العميقة، وترفعه عن الصغائر والمكائد والفخاخ العابرة التى سقط فيها غيره، وعدم انزلاقه فى أى لحظة فى نفاق رخيص لأهل الحكم.”
ويحكى الكاتب معاناته مع النشر والناشرين فى البداية، حيث طلبت منه إدار الصحوة للنشر والتوزيع، التى كانت تنشر ليوسف القرضاوى أن يتحمل تكلفة النشر، فغضب منهم وقال لهم: دور النشر ستجرى ورائى،وهو ما تحقق له فيما بعد، ويؤكد أن المسئول عن باب الأدب فى روزاليوسف زاغ منه ولم يقابله، عندما ذهب لينشر قصصه بالجريدة، ويشيد بطريقة تعامل الأستاذ “عبد العال الحمامصى” رئيس تحرير سلسلة “إشراقات أدبية”، بدار المعارف، وكذلك “محمود العزب”، مدير تحرير السلسلة، و الشاعر “المنجى سرحان” سكرتير التحرير،حيث كانوا معه غاية فى اللطف والود والترحاب،وإن كانت سلسلة إبداعات برئاسة فؤاد قنديل، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، هى التى نشرت أول مجموعة قصصية له،وذلك بعد أن استفاد من قصص الجيل الجديد التى قرأها بعد أن تعرف عليها فى ندوات محمد جبريل الأسبوعية رئيس قسم الأدب بجريدة المساء.
ويحكى الدكتور عمار على حسن أن رئيسا لتحرير دار الهلال كان يعطيه من طرف اللسان حلاوة، ويؤكد له أن الدار ستنشر روايتى زهر الخريف وجدران المدى، ويقول:”فما إن أنصرف عنه حتى يقسم للجالسين معه بأن روايتى لن تصدر عن سلسلة الهلال ما دام يقوم هو على أمرها. وأباح لى سكرتير التحرير بهذا، وهو يأتمننى على ما يقول، وأفهمنى أن الرجل يخشى إن أصدر روايتي أن تغضب السلطة منه، لأنى من معارضيها، وقد يخسر رهاناته على مناصب صحفية أو سياسية أكبر.”
ويفتخر الكاتب بجوائز فاز بها،بسبب مردودها المعنوى وتأثيرها الإيجابى على مسيرته كقاص وروائى، ولكونها تعتبر اعتراف من المختصين بأنه يمضى على الطريق الصحيح، الأولى كانت عن قصة فازت بمسابقة لـ “رابطة الأدب الإسلامى العالمية، والثانية كانت عن مجموعة قصصية فى مسابقة نظمتها جريدة الأدب وسلم جوائزها نجيب محفوظ، وقال عن العشرين الفائزين أنهم أدباء موهبون، وكانت الجائزة الثالثة تسمى “القصة والحرب”،ونظمتها جريدة “أخبار الأدب” أيضا بالتعاون مع مجلة “النصر” التى تصدرها القوات المسلحة المصرية.
ويؤكد عمار أن عادة القراءة فى الزحام لازمته منذ الصغر، فى دكان جده، وفى طريقه إلى مدرسة المنيا الثانوية العسكرية، وهو جالس على مقعد فى عربة نصف نقل، واستمرت معه فى الجامعة والجيش والعمل فى المؤسسات البحثية والصحفية، ويكشف أن الحكايات التى استقرت فى رأسه طوال مسيرة حياته،خاصة الطفولة والشباب، كانت هى مصدر حكاياته وقصصه ورواياته،حيث يقول:إنها الحكايات التى استقرت فى رأسى، ولا تزال،وأغرف منها كلما احتجت إليها فتصير قصصًا وروايات. وبهذا توالت رواياتى ومجموعاتى القصصية وكتبى، وظهرت عناوينها فى أكبر دور النشر المصرية والعربية، بعد أن تعبت سنوات من أجل أن ترى حروفى النور. واليوم تأتينى اتصالات بين حين وآخر من ناشرين كبار:هل انتهيت من الرواية الجديدة؟ هل انتهيت من كتابك الأخير؟ “
ويرى الكاتب أن تقدير القراء أفضل بكثير من حصد الجوائز، حيث يقول:”ورغم حصد الجوائز فإن أعظم تقدير ذلك الذي جاء على لسان فلاح بسيط عقب مؤتمر جماهيري حاشد بعد ثورة يناير حين قال لى:أنت ضمير مصر،فبكيت من هول ما سمعت، وغرقت في المسئولية.”
ويتحدث الكاتب عن طقوسه فى الكتابة، فيؤكد أنه يكتب فى أى مكان لإيمانه بأن الإبداع عملية إرادية، ويقول:”إننى حين أكتب أغوص فى نفسى لأصنع بهجتى العابرة وسط حزنى المقيم، سواء بالتأمل أو الاستماع للموسيقى أو مشاكسة الحياة،ثم أكتب فى أى مكان وتحت أى ظروف، وتشى تجربتى فى الكتابة عمومًا أننى إنسان بسيط، جسده يئن تحت ثقل أحلامه، ويشغله طوال الوقت أن يهش تجار السياسة عن الوطن، وتجار الدين عن الورع،والأدعياء عن الجلوس فوق رؤوس الموهوبين، وأعتبر، ككاتب وقبل هذا كإنسان، أن الحياة مجرد رحلة قصيرة، السعيد من لا يظلم فيها أحد ويترك عليها علامة.”
ويعتقد الكاتب أن كل رواية تختار لغتها وبنائها أو شكلها وكذلك حجمها،وتختلف طقوسه فى الكتابة من رواية إلى أخرى ومن شخصيات إلى أخرى،ويداهمه البكاء وهو يرسم أوجاع شخصيات قصصه على الورق، ويقول:لحظة الكتابة حين تأتى تأخذنى من كل شىء، ومن بعض نفسى، إذ أتحول إلى شخص آخر، يندمج مع العالم الذي يصوره على الورق، ويصير واحدًا من شخوصه…”، ويقول أيضا:” وحين أختلى إلى نفسى أراهم رؤي العين، وأسمعهم كأنهم من لحم ودم…” ،ويقول فى مقام ثالث:”أحيانًا أغمض عينى وأنا أكتب لأرى.وتأتى الشخصيات لتقف أمامى،فأتخيلها فى فرحها وحزنها،وفى غضبها وحلمها،وفى قلقها وسكينتها، وفى حلها وترحالها.ويكاد هذا التخيل أن يصير واقعًا.
ويشرح الكاتب كيف يصطاد أفكار وشخصيات رواياته، فرواية حكاية شمردل مأخوذة من قصة تعرض لها أثناء تواجده فى الخدمة العسكرية، ورواية سقوط الصمت كتبها بهدف التوثيق لثورة 25 يناير،وبدافع معايشته لأبطالها الثوار،وبسبب خوفه من تشويهها على أيدى خصومها فى المستقبل، ورواية خبيئة العارف كتبها بسبب تردده الدائم على مقر الطريقة “العزمية” فى شارع “مجلس الأمة ” لإلقاء محاضرات، والمشاركة فى ندوات عن أمور دينية وسياسية،وقراءته المستفيضة عن شيخها وقناعته بأنه يستحق تخليد سيرته فى رواية هادفة،ونفس الشى ينطبق على رواية بيت السنارى، ورواية “زهر الخريف” التى نُشرت عام 2008، شغلته لسنوات لأن بطليها على وميخائيل كانا جارين له فى قريته، ومجموعته القصصية “التى هى أحزن” بطلتها سيدة التقته بالصدفة فى مترو الأنفاق وحكت له قصتها.
وفى إطار شرحه لطريقته فى صيد الحكايات، يقول الكاتب:” ليس بوسعى أن أغفل تجاربى العاطفية التى انداحت فى أعمالى بشكل أو بآخر. فإن كانت البطلة خائنة لعواطفها، تجري وراء صاحب مال أو منصب، استدعيتها لأستفيد من سماتها وقسماتها، لتفيدنى فى رسم ملامح وصفات شخصية مثل “سلمى” بطلة “جدران المدى”، وإن كانت مكتملة الأوصاف لم تبرح القلب، جئت بها لتساعدنى على صياغة “حفصة” بطلة “شجرة العابد”، وإن كانت وفية حريصة على العائلة تهادت لى لتكون “وفاء” بطلة “زهر الخريف”، كاسم على مسمى. وإن كانت تلك التى آنست بها طريقًا فى الحياة وبناء العائلة جاءت لتسهم فى بناء شخصية “جميلة” بطلة “جبل الطير”، وإن كانت تجربة تنزع نحو الحس والاشتهاء، مفارقة تلك الأنماط المتكررة من “الحب الأفلاطونى” قدمت لى معروفًا فى صناعة شخصية مثل “سميرة” بطلة رواية “باب رزق”، وهكذا.”
ويبرر الكاتب طول رواية جبل الطير بأنه ناجم بشكل طبيعى عن منطق “تداعى المعانى” أو موجبات الحكى والسرد،ويؤكد على أهمية النقد الموضوعى للأديب والحياة الأدبية، ويرى أنه محظوظ لأنه من الذين استمعوا إلى الإشادة بطريقته فى الكتابة والتحليل السياسى، ويشدد على أهمية التواصل بين الكاتب والقراء والاستماع إلى نصائحهم والجلوس معهم وجها لوجه،ويقول أنه عاشق للقاهرة، ويراها أجمل مدن العالم، على الرغم من سفرياته الكثيرة ورؤيته لمدن كثيرة فى أسفاره، وأنه عاشق لبهجة الريف ويستدعيه فى قصصه ورواياته، ويكن الحب والاحترام لزوجته وأم أولاده، حيث يقول عنها:”وهى الوفية التى تصون عرضى ومالى وترعى أولادى، ولا تعوزنى شيئًا، يطلبه رجل من امرأة. وقد أهديتها مجموعتى القصصية الأولى لأقول لها فيها إنها “سدرة منتهى الحسن، ومنتهى سر البراءة، بداية الحلم ونهاية الرحيل فى المستحيل”، فقد كانت بالفعل نهاية رائعة لقصص مستحيلة، تحول المستحيل معها إلى ممكن أعيشه بكل كيانى.”
ويشغل الكاتب باله بأسباب استمرارية الكتاب فى عقول الناس بعد وفاتهم،ويرى أن الكاتب مسئول عن فعل ذلك، بتقديم كتابات للناس تنقعهم فى حياتهم ومستقبلهم،ويشعر بالرضا بحس الطامح فى المزيد، من تناول رسائل دكتوراة وماجيستير فى جامعات محلية وأجنية لرواياته وأعماله الأدبية،ومن حديث النقاد عنه، ووصفهم له “بأنه يمتلك مشروعًا روائيًا طموحًا بانت ملامحه جيدًا من خلال أعماله السردية التى توالت فى السنوات الأخيرة، والتى يعمل فيها على شق طريق لواقعية سحرية عربية، وإعادة تشكيل ومساءلة مرويات تاريخية مستقرة، وتعزيز التسامح ومناصرة الحرية والبحث عن الجواهر المخبوءة فى النفس الإنسانية وفى طرائق عيش البشر.”
ويخصص الدكتور عمار على حسن الجزأ الثالث من الكتاب ، والمعنون بـ”علم وعمل”، لتبيان أسرار علمه بقواعد البحث فى العلوم الإنسانية وعمله باحثا فيها،وهو المجال الذى رآه مناسبا له بعد فوزه بجائزة المستشار محمد شوقى الفنجرى فى الفقه والدعوة الإسلامية فى بحث بعنوان: “منهج الإسلام فى بناء الإنسان”،قال عنه الشيخ محمد الغزالى: “لو قدم لى هذا البحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه لأجزته.”
ويحكى الدكتور عمار كيف أنه قرر بدء مسيرته لتحقيق الذات ومواجهة صعوبة الحياة بالعاصمة، ففى آخر شهرين له بالجيش قام بتأجير سرير فى غرفة فى شقة بحى “عين شمس” الشرقية ، حيث يقول:” فلما كان آخر يوم فى تجنيدى هبطت إلى “القاهرة” ليلا، وأنا أقول لها:لن أتركك أيتها المدينة المتوحشة حتى تعترفى بأن لى مكانًا فى شوارعك الغريبة عليَّ.وكنت أحيانًا أجسد الموقف فى حديثى مع الأصدقاء فأقول لهم:خلعت ملابسى لأواجه “القاهرة” بصدر عار.”
وكان يأمل أن يجد وظيفة مناسبة فى مركز الدكتور عبد الصبور مرزوق فى يوليو 1992 ، واستقبله الرجل وتعاطف مع مشكلته،ولكنه أخبره بأن الوظائف المتاحة ليست مناسبة لمؤهله وثقافته ووعده بأن يتوسط له لدى صحفيين ليعمل بالخليج، فهاتف الكاتب رجل أعمال ، كان قد حضر حفل تسلمه جائزة الفقه والدعوة الإسلامية، وعمل معه فى مكتب استيراد وتصدير فى مجال تصدير البذور والنباتات العطرية والطبية، براتب 200 جنيه شهريا، ولكنه سرعان ما ترك العمل بعد تأكده من أن الرجل يريد استغلال إمكاناته فى إعداد المادة العلمية لنيل رسالة دكتوراة فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وتظهر صفة التمرد الإيجابى للكاتب فى إجابته بطريقة إبداعية على سؤال فى مادة التاريخ حول سبب عودة نابيلون إلى باريس بعد غزو مصر، وذلك أثناء تقدمه للعمل كمدرس تاريخ بمدرسة مودرن سكول، وتظهر أيضا فى سخريته من سؤال عن طول الهرم الأكبر أثناه تقدمه لوظيفة محرر صحفى فى “جريدة واعدة!”، حيث قام وترك المكان، وتعرض الكاتب كغيره من ظاهرة النصب على الخريجين بالإعلانات عن الوظائف والتربح من وراء رسوم امتحاناتها المبالغ فيها، وحاربها بمكالمات تليفونية لتخويف القائمين عليها من مغبة ما يفعلونه ،مدفوعا فى ذلك بصفة التمرد الإيجابى التى ورثها عن أبيه.
ويحكى الكاتب عن تجربة عمله فى مركز “التنمية السياسية والدولية” التابع لصحيفة عالم اليوم، حيث اتصل بـ 140 وحصل على رقم تليفون الدكتور جهاد عودة مدير المركز،و هاتفه من تلقاء نفسه، دون سابق معرفة، وقابله وعرض عليه أبحاثه وحضر اجتماع التحرير يوم الزلزال فى 20 من شارع وادي النيل، حيث يقول:”ما إن انتهى الاجتماع حتى وجدت الدكتور جهاد يستدعينى إلى مكتبه،وأجلسنى أمامه،وراح يكتب خطابًا إلى الأستاذ “عماد الدين أديب” رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة “العالم اليوم” يطلب فيه تعييني براتب قدره مائتين وخمسين جنيهًا.”
ويضيف الدكتور عمار على حسن:”لا أنسى هذا اليوم ما حييت، ففيه تحددت وجهتى كباحث فى “الحركة الإسلامية”، ورغم اختلافى السياسى العميق مع الدكتور جهاد، الذي صار من قيادات الحزب الوطنى الحاكم فيما بعد، فقد حفظت له الجميل، ولم تؤد فرقتنا السياسية إلى نسيان ما فعله معى، وكنت أذكره بهذا كلما التقينا متناظرين بعد سنوات فى البرامج التلفزيونية، هو عن السلطة، وأنا عن المعارضة.”
ولم يستجيب الكاتب لنصائح مدير المركز بالتخلى عن كتابة القصة،على أساس أن حضور المشاعر يجور على حضور العقل، بما ينعكس بالسلب على العمل البحثى، ولكن الدكتور عمار احتج على مبرراته بأن طه حسين وزكى نجيب محمود كتبا فى مسائل فكرية بأسلوب سلس، فحصر الأدب فى العلم، دون إخلال بالقدرة على البرهنة، والوصول إلى المعنى من أقرب طريق.
وينتقل الكاتب إلى محطة مهمة فى حياته، وهى تعيينه محرر صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك بعد فترة من إطلاعه على الأرشيف الخاص بالجماعات الإسلامية، بمؤسسة الأهرام،وهو عبارة عن عشرة ملفات ضخمة، تمتد منذ عام 1974 وحتى 1992،وقد سهل له مركز التنمية السياسية عمل ذلك،فضلا عن تجربته الميدانية مع الجماعة الإسلامية فى المنيا ومحاولة تجنيدهم له، دون جدوى، وتعرفه على دراساتهم وأبحاثهم السطحية وأفكارهم وتصوراتهم المغلوطة.
ويشارك الكاتب خلال عمله بالمركز فى المؤتمر السنوى الذى ينظمه مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد، جامعة القاهرة، ويقدم فى مؤتمر ديسمبر 1993 مقترحا حول “دور الطرق الصوفية فى التنشئة السياسية فى مصر”، فيعجب به الدكتور كمال المنوفى وينصحه بأن يجعله عنوان رسالة الماجيستير، وخلال سنتين يحصل عليها وينشرها فى كتاب من مائتى صفحة فى 2009 تحت اسم “الصوفية والسياسة فى مصر”، ويعمل فيه عقله وقلمه ويحوله لكتاب من سبعمائة صفحة تحت عنوان “التنشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر .. مسار التحديث وثقافة الديمقراطية لدى تيار دينى تقليدى”، ويدخل به المنافسة على جائزة الشيخ زايد للكتاب فى فرع التنمية وبناء الدولة، ويفوز بها عام 2010،ويساعده على تقديم استقالته من العمل بوكالة أنباء الشرق الأوسط للتفرغ للأدب والبحث والتحليل السياسى.
ويربط الكاتب بين قراءته بنهم ونجاحه فى تحقيق هدفه ،حيث يقول:”مع الكتب أخلصت لمقولة نجيب محفوظ “القراءة بلا حدود وفى أي اتجاه”، وصارت علاقتى بمكتبتى علاقة وجود، فمن دونها ما كنت هذا الذي يراه الناس.”، ويضيف:”وفى كثير من الأحيان أنتقل من القراءة للمتعة إلى القراءة الوظيفية، حيث أقرأ الكتب والروايات والمسرحيات ودواين الشعر والكتب على اختلاف موضوعاتها لأكتب عنها مقالات للعرض والتحليل والنقد، وأنشر ما كتبت فى الصحف والدوريات. “
ويعد الكاتب رسالة الدكتوراة أثناء عمله بأبوظبى، ويحصل عليها، وينشرها فى مركز الأهرام تحت عنوان “النص والسلطة والمجتمع: القيم السياسية فيىالرواية العربية”، وتصبح أحد المراجع التى يعتمد عليها الباحثون فى مجال الأدب، ويستفيد منها الكاتب بأن أصبح قادرا على كتابة المقالات النقدية للأعمال الأدبية فى الصحف والدوريات.
ويرفض الكاتب العمل فى وظيفة مدرس بكلية “العلوم الاجتماعية” بجامعة السادس من أكتوبر الخاصة، بعد صدور قرار تعيينه، خشية أن يعوقه الانهماك فى التدريس الأكاديمى والانشغال بأمور إدارية عن الكتابة الأدبية التى يعشقها ويكرس حياته لها،حيث يقول:”رفضت العمل فأنا لم أترك وظيفتي بالإمارات كى أدفن نفسى فى وظيفة جديدة تأكل رأسى ووقتى وترمينى فى آلة جهنمية تدهسنى بلا رحمة.”
ويكشف الكاتب عن محطة أخرى فى حياته العملية والأدبية ساعدته على تحقيق هدفه، لأنها خلصته من قبضة العمل الروتينى تحت وطأة الحاجة، وهى نشر مقالات فى جريدة الخليج الإماراتية لمدة ثلاث سنوات، ونشر مقال أسبوعى فى جريدة البيان الإماراتية لمدة ثلاث سنوات، وكتابة مقال دورى بجريدة الاتحاد الإماراتية، ونشر مقالات سياسية فى صفحتى أفكار وقضايا بجريدة الحياة اللندنية، ومقالات نقدية فى صفحة الأدب وأخرى فى الدراسات الدينية فى ملحق أفاق بذات الصحيفة، فضلا عن كتابة مقال بالحوار القومى بجريدة الأهرام بعنوان “منظومة قيم سياسية لا أيديولوجيا”، بالإضافة إلى نشر دراسات سياسية وأدبية له فى مجلة شئون عربية التى تصدر عن جامعة الدول العربية.
ويشرح الكاتب عمار على حسن مفهومه ورؤيته للمثقف الحقيقى، فيقول:”وفي كل ألون الكتابة كان، ولا يزال، لدى اعتقاد في أن المثقف الحقيقى هو الذي يمشى أمام السلطان ليقوده ويرشده وليس خلفه ليبرر له ويحميه ولا حتى إلى جانبه ليقول ليس في الإمكان أبدع مما كان. والمثقف منحاز إلى الناس، يحمل أشواقهم الدائمة إلى التقدم والحرية والعدل، وهو معارض بطبعه ليس حباً في المعارضة، وإنما لأنه يجب أن يتمسك بالأفضل والأمثل لمجتمعه.”
ويربط الكاتب بين مفهومه للمثقف الموضوعى وانخراطه بقوة فى النشاط السياسى، يقول:”وقادنى هذا اليقين إلى أن إنخرط في الحركة السياسية بكل كيانى، محاولًا أن أكون مثال “المثقف العضوى” الذي كتب عنه المفكر الإيطالى أنطونيو جرامشى فى “كراسات السجن” وأن أكون “الباحث المتدخل” الذي أراده عالم الاجتماع الفرنسى آلان تورين لتلاميذه حين كان يدفعهم للمشاركة فى ثورة الشباب فى ستينيات القرن العشرين ليكتبوا أبحاثهم من واقع الميدان، وألا تقتصر مصادر معرفتهم على الكتب إنما ما يفعله البشر أيضًا. ولهذا أقول دومًا إننى ألتقط معرفتى من الكتب وأفواه الناس.”
ويتحدث الكاتب عن طريقته فى البحث العلمى ، ويؤكد أنها تمر بمراحل هى القراءة المستفيضة فى الموضوع وتقسيم الدراسة، أو وضع خطتها، الكتابة ، المراجعة، ويعتبر نفسه سعيد الحظ لاشتمال دراساته على المسائل النظرية والبحوث الميدانية والتطبيقية، ويقول:”كانت طريقة البحث فى أطروحة الدكتوراه مختلفة فى جانبها المتعلق بتحليل النصوص الأدبية، وقد حددت أربع قيم سياسية لأدرسها فى عينة روائية تضم عشرين رواية سياسية عربية، وضعت معايير منضبطة لاختيارها، وكانت هى قيم الحرية والعدل والمساواة والانتماء، وفى مقابلها الإكراه والظلم والتفاوت والاغتراب.”