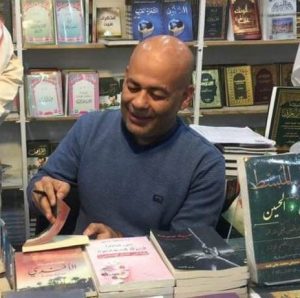في كل يومٍ بعد صلاة العصر؛ تعبر أمامي إيناس بنت الشيخ حسين، تُمسك في يدها بكيس أسود مليء بطعام، وتذهب بالغذاء إلى محل أبيها، وهي تتعثَّر في سوادٍ مُطلقٍ. أصبح الخفي خيالًا في الغُرفة، أحاول استنباط جسد البنت، أتفحَّصُهُ بعيني أثناء الذهاب والمجيء، ثُمَّ أُحاول انتزاع الملابس عن اللحم انتقامًا من الشرموط أبيها؛ وأستمني. ألتقط صورًا لها بالمحمول، أقوم بتكبير الصور على الكمبيوتر، وأفرز جسمها قطعةً قطعةً للوصول إلى حقيقةٍ. أجد جسمها يُشبه جسم سلمى بشكلٍ كبيرٍ، أتفحَّص وأجد خطوتها كذلك؛ للبنت مشية سلمى وحركات سلمى، عندما تتكلم بهمساتٍ وهي تُناول حسين الكيس أمام باب المحل كنتُ أسمع صوت سلمى. أُذنُي تنمو وأسمع حسين يقول: «يا سلمى!».
صحوتُ مفزوعًا في ليلةٍ، ممتلئًا بالعرق، كنتُ أصرخُ مضروبًا بالنتائج التي غابتْ عن عقلي؛ هذه البنت هي سلمى والله، الشيخ حسين تعمَّد إهانة كرامتي أثناء وجودها في الشارع ليأخذها إلى بيته. الشيخ حسين متواطئٌ مع نوال التي سلَّمَتْهُ سلمى بحيلة النساء. حبيبتي مختفيةٌ عني في بيت الشيخ (أحَّه) المتزوِّج مِن ثلاثٍ. تمرُّ أمام عيني كل يومٍ في ملابس سوداء وغطاءٍ على الوجه؛ فيزداد ضحك أولاد القحبة على محنتي.
لم أنتظرْ أكثر من ذلك لكشف تلاعبهم بي. في اليوم التالي، كانت تعبر أمام القهوة، فناديتُ بصوتٍ عالٍ: «يا سلمى»؛ التفتت البنت تجاهي، ثُمَّ استدارت مرتبكةً، وأسرعت الخُطى تتعثَّر باتجاه المحل؛ تأكَّدتُ مِن شكوكي تمامًا، قطعتُ المسافة بيني وبينها قفزًا، سددتُ الطريق عليها ونزعتُ القماش عن الوجه. تفاجأتُ؛ قلتُ: «مدة بسيطة في بيت حسين تُغيِّر ملامحك هكذا يا سلمى؟!». كانت تصيحُ مفزوعةً، تُعيد الغطاء لوجهها، بنت القحبة تحبُّ الأسر، وحسين يضربني على ظهري ويُزيحني من الطريق، والناس من حولنا. شدَّني المدهش من يدي نحو البيت، وقفتُ رافضًا الذهاب، أصرخُ فيه: «والله أنت تعرف وتعرِّص على صاحبك». أقنعتني ثناء أنَّ البنت ليست سلمى. قالت: «لا تُصدِّقْ أبيك. لكن صدِّقْ أُمَّك حبيبتك». أعطتْني ثناء مئة جنيهٍ، وقالتْ: «لا تجلس في الحارة، اذهبْ للتمشية على النيل ليروق فكرك».
كنتُ أخرج من الفجر، أمشى في شوارع وسط البلد بلا هدفٍ. رأيتُ سلمى مرَّاتٍ كثيرةً ولم ألحقها. وفي مرَّاتٍ أُخرى كنتُ أُمسك بها؛ فأجد واحدةً أُخرى بين يدي. لكني عرفتُ هناء في ذلك الوقت؛ كانت تسير في طلعت حرب، تُلامس الأرض بخفةٍ كأنها تطيرُ، يسبح شَعرها مع الهواء، وذراعاها كالأجنحة. كدت أُناديها: «يا سلمى»؛ ولكني تذكرتُ أنَّ سلمى مع الطبيب. تتبعتُها حتَّى بيتها، أنتظرُ أمام البيت بالساعات حتَّى تظهر، وأظلُّ خلفها في المشاوير، أمشي معها إلى محل عملها، وأُلازمها في طريق العودة. أُسجِّل المواعيد بحرصٍ. ألتقط الصور؛ أطبع وأُعلِّق في غرفتي، أحتفظُ بواحدةٍ في المحفظة. تعلَّقتُ بالبنت وتقاسمتُ معها العيشة؛ تأتي ليلًا إلى سريري لمؤانسة المحنة. أصبحت هناء حبيبةً في ذلك الوقت الذي عز فيه الأحبة. كانت كزوجةٍ؛ تعتني بملابسي وطعامي. تظهر أمامي في البيت وتضحك، تتعرَّى مِن ملابسها قطعةً قطعةً، تنظر وتضحك، تسحبني إلى الكنبة وتقول: «لا أرتاح إلَّا وأنت فوقي»، تهتزُّ تحتي مِن لذةٍ وتضحك. تجلس معي إلى المائدة، ولا آكل إلَّا حين تأكل معي.
كنتُ أسأل بحرصٍ؛ عرفتُ اسمها وعملها وأصولها مِن سؤال الجيران، وأصحاب المحلات المجاورة للبيت، والجالسين في المقهى المجاور للبيت، والمُصلِّين في المسجد القريب من البيت، وزملاء العمل. أجمع قطع البازل وأدوِّنُها بعنايةٍ في سبيل معرفةٍ كاملةٍ. كانت الأمور سلسةً فيما يتعلَّق بجمع المعلومات عنها بخلاف البنت أمنية المنحوسة؛ والتي ما إن سألتُ صاحب محل البن جوار منزلها، حتَّى انفرجتْ أساريرُهُ، وأمسكني مِن ذراعي بودٍّ، قال: «طالما تُريد الحلال يا ابني، تعال، ونتشرف بزيارتك في البيت، تعرفنا ونعرفك، وبعدها اسأل واطمئن كما تحب، أنا خالها والبنت والله من بيت أصول». قلت «والله ليس لي يا حاج، أنا في خدمةٍ لصديقٍ أعطاني العنوان، وقال اسأل. أمانة، وأنا أدَّيتُ ما عليَّ وابنتكم جوهرةٌ، وعن قريبٍ تتلاقى الوجوه إن شاء الله».
انقطعتْ بعدها علاقتي بالبنت رغم جمالها، لكن قريبها هو السبب، وليس بيدي حيلة يا بنت، ولا تهمني النساء؛ فأنا معجباني مثل بذوري.
لم تطلْ علاقتي بـهناء والسبب أنيسة. كانت أنيسة تمرُّ أمامي أثناء انتظاري لـهناء، كنتُ أجلس على الرصيف المواجِه لمدخل الشركة التي تعمل بها هناء. خرجتْ هناء ويدها في كف الولد الذي يظهر معها مُؤخَّرًا، يدورون أمامي بالساعات في شوارع، يذهب معها حتَّى باب البيت، ويُقبِّل يدها قبل أن تغيب. كنتُ أصبر وأحسبه أخاها أو قريبًا يطمئنُّ على وصولها، لكن ما إن رأيتُ أنيسة أمامي، حتَّى قلتُ فورًا تحلُّ أنيسة في قلبي، ولتشبع هناء بالأهبل. أنيسة يا مرَّ رُوحي وحلاوتها! بكِ أحيا، وبكِ أموت، وبكِ أُقيم، وبكِ أبارح. احتلت أنيسة مكان هناء، نسيتُ الأُخرى تمامًا، ونسيتُ الوجع. كنتُ أكثر خبرةً وحساسيةً عند السؤال، وبتمرُّس وبحرص المحبة الغالية عرفتُ ما أريد؛ الأب أحمد فؤاد كان ضابطًا في الجيش، تُوفِّي في حادث سيرٍ؛ صدمته سيَّارةٌ وهو يعبر أمام المنزل، وتركتْهُ في دَمِهِ، فترك خلفه بنتًا وحيدةً وزوجةً صغيرةً تحمل شهادةً جامعيةً. فضَّلَت الأُمُّ أن تظلَّ في المنزل، ترعى البنت وتعيش على معاش الزوج ومساعدات العمَّين. ربَّت الأم ابنتها وتحمَّلت الحياة دون زوجٍ، إلى أن تخرَّجَت البنت في كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ والبنتُ تعمل مهندسةً معماريةً في مكتبٍ هندسيٍّ في وسط البلد. سيرتها طيبةٌ ولم تدخلْ في علاقة؛ قالوا إنها مثل أبيها موهوبةٌ للدراسة والعمل، ورفضت الطالبين بحجة الدراسة وإثبات الذات.
تحب أنيسة درجات الأزرق والرمادي؛ ملابسها تتأرجح بين اللونين. قال لي عامل البوفية إنها تفتتح يومها بقهوةٍ سادةٍ بالرغم مِن مُعاناة القولون، كما تشرب الشاي دون سُكَّرٍ. تُدخِّنُ قليلًا في البيت؛ تشتري علبة سجائر واحدة (ميريت أصفر) كل أسبوعٍ أو أكثر، ولا تُدخِّن أمام عيني أو في العمل، وتحتفظُ بقدَّاحةٍ وقعتْ مِن حقيبتها ذات مَرَّةٍ. تسمع فيروز أو عبد الوهاب طوال وجودها في المكتب. بينما أخبرني بائع الخبز أنَّ والدتها تحب الست والشيخ عبد الباسط، وأنَّ الأم تأكل الخبز وحدها، بينما أنيسة تأكل الأرز أو المكرونة فقط كما قالت له الأم.
كدتُ أهلك مِن الفرحة حينما أعطاني صبي المغسلة ملابسها المتسخة مقابل عشرين جنيهًا، كنتُ أنتظرُهُ أسفل منزلها ولا أُصدِّق أنَّ الأمر سيكتمل كما أحلم، تشمَّمتُ ووصلتُ لرائحة الجسم، كنتُ أدسُّ وجهي طوال الليل في الثياب، واشتريتُ زجاجةً مِن عطر أنيسة بعد أن أخذتُ البلوزة لمحل عطورٍ، وأدخلتُ البائع في وصلة شمٍّ عميقةٍ أصابتني بالغيرة. اشتريتُ العطر، ووضعتُ منه على الوسادة في كل ليلةٍ؛ لتظلي هنا يا أنيسة.
كنتُ أتتبع، أراقب، أجمع التفاصيل، وأحفظ عن ظهر قلبٍ تحت سيف جمالها الضارب في الروح. تختفي هناء من بيتي، وتتجول أنيسة، لكن أنيسة لا تتعرَّى أمام الكنبة، أنيسة تجلس جواري، وتلمس يدي، فتنتصب روحي والله. أصبحتْ صورها على الجدران، وثناء تسألني وتضحك، تدعو لي برائق البال؛ ووجهها للأعلى بملامح رجاء محترق، ويداها تهتزان كأنها تطرق الهواء حولها للإجابة، تشبُّ على أطراف أقدامها، حتى قلتُ ثناء ستصعد للسماء وهي تدعو. تنهر المدهش وتصرخ: «اتركه في حاله يا حاج، أبوس إيدك؛ ماصدقنا يخرج للشارع».
كنتُ أُكلِّم أنيسة وهي تُعِدُّ العشاء لنا، أتصيَّدُها وهي تستحمُّ لأتعرَّى بين ذراعيها تحت قطرات الماء. تطبع على خدي قُبلةً يوميةً أمام مقر عملها، وتسألني متي أعود لمرافقتها إلى البيت. تسهر في غرفتي أمام اللوحات. ترتدي ملابسي وتستكمل الرسومات الهندسية الخاصة بالمكتب الذي تعمل به، بينما أُحْضِر كوبَي شايٍ دون سُكَّرٍ كما تُحِبُّ. أجلس على طرف السرير، أُراقب يدها التي تخطُّ، وأقول: «أنا لوحةٌ، فاكتبي على جسمي يا بنت الجميلة». لا أحتاج أن أدوَّن تفاصيلها للتذكُّر كما فعلتُ مع هناء؛ فكل شيءٍ محفورٌ في رأسي. كانت أُنسي والحبيبة التي أردتْها للمحبة. لكنها غابتْ فجأةً، لم تَعُدْ تذهب للعمل، وطوال أسبوعٍ لم تظهرْ خارج البيت؛ كنتُ أُجَنُّ، قلتُ: «تزوَّجَتْ مِن وراء ظهري». أبكي وأقول «أخذوها إلى السعودية». أظلُّ أمام بيتها طوال النهار والليل، وأنام أحيانًا على الرَّصيف، ولا أثر.
ظهرتْ فجأةً في عصر يومٍ؛ كانت تمسك بيد أمها وتبدو منهكةً. استقلَّتا تاكسي، ورحتُ وراءهما، ذهبتا إلى عيادة طبيب مُخٍّ وأعصابٍ في الفلكي، ثُمَّ مركز أشعة في عمارةٍ مقابلةٍ للطبيب، وعادتا بعدها إلى البيت. لم تكن أنيسة التي أعرف؛ كانت ذابلةً وتائهةً، تخطو بصعوبةٍ. كنتُ أُجنُّ مِن الخوف، وأُريد أن أعرف. ذهبتُ في الصباح إلى العيادة؛ كانت مغلقةً، وانتظرتُ على السُّلَّم حتَّى أتتْ مُساعِدة الطبيب. ذكرتُ اسمها وأوصافها، سألتُ عن حالتها ومرضها، أعطيتُها عشرين جنيهًا، قلتُ: «رشَّحها لي قريبٌ للزواج، وأُريد أن أطمئنَّ قبل دخول البيت». كانت تضحك بخبثٍ، قالت: «مسكينة؛ يقول الدكتور إنها أخذت دواءً بالخطأ، ولا تتذكَّر أيَّ شيءٍ، رأسُها كالصفحة البيضاء».
لعبت الكلمات برأسي، النسيان جميلٌ، كانت فرصةً تحتاج للجرأة يا يوسف. ولكن البنت تستحقُّ المغامرة. كنتُ أُعِدُّ التَّفاصيل اللازمة بحرصٍ، أُدوِّن ما سأقول ومتى، أنتظرُ البنت التي لا تخرج إلَّا في يد الأم، صرتُ أتتبعهم في الزيارات إلى المستشفيات والمعامل في انتظار لحظة انفرادٍ بالبنت. تركتها الأم في صالة الانتظار وذهبتْ إلى دورة المياه؛ كنتُ أقترب لأوَّل مَرَّةٍ من أنيسة، قلبي يدقُّ وكالمحموم، لكني كغيري لأوَّل مَرَّةٍ أمام أنثى. كانت تنظر في عيني بحيرةٍ، مظاريف مِن الأشعة والتقارير الطبية فوق ركبتيها. كنتُ أدسُّ في يدها ورقةً مطويةً، قلتُ: «اقرأيها وكلميني، ولا تدعي أحدًا يراها وسوف تفهمي». كانت الورقة تحكي عن تفاصيل محبتنا، بدايات التَّعارف، قُبلتها اليومية، أملنا في الزواج، عذابات النسيان وافتقادي لها تحت وطأة المرض، رقم تليفوني مع اقتراحٍ بموعدٍ قد يُنعش الذَّاكرة، ولكني لم أذكر زيارتها لغرفة نومي ولا تجولها عاريةً في بيتي. كلمتْني أنيسة في الليل، لاسمي منتهى الحلاوة حينما تقول «يا يوسف». التقينا، نمضي متشابكي الأيدي في الشوارع أمام الأعين. نمشي وتسأل وأحكي: «أنتِ تشربين الشاي دون سُكَّرٍ، تمدين يدك بالكوب، تقولين لي تنفَّس في الكوب فقط قبل أن أشرب، وتقولين نَفَسك يحلِّي العيشة وليس الشاي». أقف وأشتري لها علبة سجائر، أقول: «هل لا تزال الولَّاعة الزرقاء تعمل؟»؛ تضحك أنيسة، وروحي معها والله. أشتري زجاجة عطرٍ، وحذاءً أحمر جديدًا بدل الذي انكسر كعبُهُ وأنتِ تنزلين سلالم المكتب. «هنا قبلتيني لأوَّل مَرَّةٍ، وقلتِ إنك لا تأكلين الخبز، لكن يمكن أن تأكليني». أحملها أمام النَّاس، وأعبر الطرق السريعة بين العربات، الناس تضحك، وأنيسة تضحك في صدري، وأنا أصيح: «سأظلُّ أحملك حتَّى لا تخافي مِن العربات». أضخُّ الذِّكريات وأدوِّن التفاصيل مخافة النسيان والخطأ. قلتُ اصطنعتُكِ لنفْسي، والله يا أنيسة أنت بأمي وأبي وعيني. كانت حالتها تتحسن؛ فأفرح وأخاف، يزول الذبول والنظرة التائهة؛ فأفرح بقرب الشفاء وأخاف منه يا بنت. ارتدتْ حجابًا ولم أعترضْ على حرماني مِن رؤية شَعرها، قالت لمزيد من الدعم النفْسي. أحكي وتعيدُ تمثيل ما أحكي في محاولةٍ لإنعاش الذاكرة. تمثِّل التفاصيل من جديدٍ، وتبثُّ كلماتي للحياة؛ تُجسِّدُ الإيماءات وطريقة الكلام، الانفعالات والضحك تُعيدهم حسب وصفي، وتسأل عن صحة أفعالها في ذاكرتي. ترتدي ملابسها المفضلة حسب حكايتي، وتأكل الطعام الذي أكلَتْهُ في الحكايات. صارت لنا ذاكرةٌ واحدةٌ؛ أحكي وهي تفعل، تتشبَّث بالذاكرة من خلالي. قالتْ: «المحبة تقتل النسيان»؛ وحكتْ عن تذكرها لشرب الشاي في كوبٍ زجاجيٍّ صغيرٍ في المنزل، تحتفظ به منذ أيام الدراسة الجامعية، وفرحة الأم ببشائر الشفاء. دقَّ الخطر نافوخي، فكرتُ في الانسحاب من عالمها، لكني بدأتُ في الاطمئنان من جديدٍ، حينما عادت لعينيها النظرة التائهة.
في آخر مَرَّةٍ أتتْ ساكتةً وحزينةً، حاولتُ أن أعرف، نظرتْ لي بمحبةٍ لا صفة لها في الأرض، وقفتْ بمواجهتي وأسندتْ يديها على كتفي، اقتربتْ بوجهها من وجهي وقبَّلتني بين عينَيَّ. همستْ بضعفٍ: «لماذا تأتي المحبة متأخرةً يا مدهش. أنا لستُ فاقدةً للذكريات يا مدهش، ولو أني كنتُ أرغب في ذلك. أنا أعرفُكَ منذ مراقبتك لي يا مدهش. أراك تمشي ورائي بالأيام والليالي، وأستغرب لما عرفته يا مدهش. أنا آسفة والله وأحبك. أنا مريضة بسرطان في المخ يا حبيبي». مضتْ، تركتني في الشارع وحدي، وماتت ليلتها.