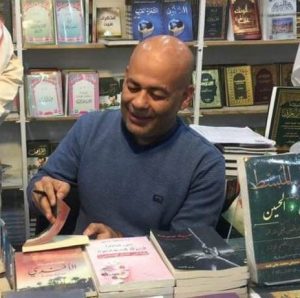حسني حسن
صحا من نومه مشَوشاً ودائخاً، قليلاً. فتح عينيه ببطء، مستمتعاً بإراحة رأسه، لدقائقٍ إضافية، على الوسادة الطرية الدافئة، فيما تواصل إلحاح الصوت، القوي العميق من طبقة “التينور”، مؤكِداُ ومشدِداً:
-لا هناك.. لا هنا، لا هناك.. لا هنا!
لم يكن استيقاظه، هذه المرة، على رنة منبه الموبايل المضبوط على نغمة “توكاتا باخ” الأثيرة لديه. سرح بعينيه في أرجاء الغرفة التي لا تزال مسربلةً بالظلام، ومد يده إلى الكومود، بجوار السرير، ليلتقط الهاتف الذي أشارت ساعته إلى الخامسة والنصف. رفع وسطه، قليلاً، واستند بظهره إلى شُبّاك الفراش، مصيخاً بسمعه لنقرات المطر، المتواصلة، وهي تدق زجاج النافذة الألوميتال، من وراء الستارة الثقيلة الداكنة. هو يوم آخر من أيام ديسمبر، الباردة المطيرة وكثيفة الغيوم، التي تقبض بخناق تلك المدينة، الصغيرة الأنيقة مضطربة الهوية، المُسمَاة الرباط. نهض من السرير، بهمةٍ ونشاط، في مسعى جدي لتبديد أية غواية للتكاسل، أو الركون للهواجس والاسترسال في الأحلام. أخذ حماماً دافئاً، سريعاً، ثم أعد لنفسه كوباً من الشاي، الأسود الساخن، شربه مع شريحة خبز، سميكة، مدهونة بالزبد ومربى المشمش.
في السابعة تماماً، و بينما كان يرتدي جاكيت البذلة، سمع جرس الباب يدق لمرّةٍ وحيدة، قبل أن يبلغ أذنه صوت “تكة” المفتاح، وهو يدور في القفل . خرج ليقابلها، وقد انتهى من ارتداء ملابسه بالكامل، ليجدها في جلابتها، السوداء المزركشة بزهورٍ حمراء زرقاء، رافعةً “القُب”، الغرقان بمياه الأمطار، والذي يشبه القمع المقلوب، على رأسها. دلفت إلى الحمام الصغير، مسرعةً، لتنض عن جسدها الجلابة المبللة، ثم عادت، في التريننج البيتي الرخيص، لتكون بحضرته، مستبقةً نزوله المتعجل، على عادته، للمكتب. ابتسمت وهي تهمس:
– مطر بزّاف!
لم يجد شيئاً يجيب به على ملاحظتها الزائدة، فاكتفى بالابتسام لها بدوره.
– أُجهِز الشاي والفطور؟
– لا، أفطرت وشربت الشاي، شكراً.
رفعت نحوه نظرةً مستفهمة، لمح فيها نوعاً من نداءٍ، غامض، لم يستطع أن يميّز طبيعته. أحس بالإشفاق عليها، مفكِراً أنها لابد وقد غادرت بيتها وأولادها، في سلا، قبل ساعة من اللحظة، على أقل تقدير، لتكون في موعدها معه، بالسابعة صباحاً، لتجهِز له الشاي والإفطار قُبيل ذهابه للعمل. تساءَل عما يقهر الناس، ويدفعهم لمغادرة سربهم وذويهم، وينتزعهم من بيوتهم الدافئة وأحلامهم اللذيذة السرية، ليلقي بهم إلى العراء والمطر، في صباحٍ غائم وكالح كهذا! كان ما يقهرها على تلك الخيانة للدفء، هو، بالضبط، ما يقهره على احتمال وحدته الطويلة، ولياليه المسهدة المحرومة، بذلك البلد البعيد الذي ظن أسلافه، يوماً، أنه آخر الدنيا، حيث من ورائه يسقط العالم في الظلمات! كانت في خدمته، وكان هو، بدوره، في خدمة سيدٍ آخر ما، وهكذا يتم تدوير الخدمة والسيادة وتداولهما، ليغدو الكل، كلنا، خُداماً أسياداً، أو أسياداً برسم الخدمة!
– والعشاء؟
– أي شيء، كالمعتاد.
– دجاج وشوربة وسلاطة؟
ابتسم ثانية لسؤالها المكرور، ما شجعها على أن تعاجِله بطلبها الذي ظلت تجهٍز لطرحه عليه طول الطريق. زفرتْ:
– ممكن سلفة من مرتب الشهر؟ البنت مريضة، كما تعرف، يا حاج، وأبوها لا يجد شُغلاً، حتى الآن.
حدّق في عينيها، المكحولتين، بثبات، الأمر الذي، ربما، أخجلها أو أخافها، قليلاً. كانت قد نبهته، ذات يوم، إلى أنها تخاف تحديقاته تلك في عينيها، وما أعار، من جانبه، ملاحظتها أدنى اهتمام. سأل باقتضاب:
– كم؟
– مائتان.
فتح حقيبة يده، وأخرج الورقة، الزرقاء الكبيرة، المزينة بصورة أمير المؤمنين، من فئة المائتي درهم، وأعطاها لها. قال بصوت اجتهد كي يبدو جافاً، ما استطاع:
– مائة سُلفة على المرتب، والأخرى مني للبنت.
شيَعته بنظرة امتنان وشكر، أفلت منها، بسرعةٍ، غير سامح لنفسه، أبداً، بالوقوع في شباك غواية فضله الذي حاولت نظرتها أن تبيعه إياها. أدار محرك السيارة، باهتياجٍ مكبوح لا يعلم مصدره على وجه الدقة، وراح ينهب طريق الأمم المتحدة، نازلاً باتجاه وسط المدينة، ليلج مكتبه قبل الثامنة بدقائق.
كان يوم عمل روتينياً مملاً وتافهاً، شعر فيه وكأن الحياة لا تمضي للأمام، بل تنكص متراجعةً للوراء. كتابة التقارير ومراجعتها، إعداد تقدير موقف لهذا الموضوع أو تلك القضية، واجتماعات تضج بالنقاش الميت كمضغ نشارة الخشب. كلام كلام كلام! كلام بلا أحلام ولا أشواق. رغب في أن يصير سهماً نارياً حياً، ولو لمرّة واحدة في حياته الثلجية هذه، سهماً ينطلق باتجاه المجهول الذي يقع، ربما، عند حافة ذاك الوجود، الهشة الصلبة الرجراجة، حيث يثمل المرء بالخوض في مستنقعات الحيرة وأحراشها البرية، وحيث يُصاب بالتشوف المرضي المستحيل، ليشي بيت جسده بفوضاه، وبقساوة التهدم المحتم! قالت سكرتيرته:
– تبدو متعَباً، أستاذ.
– هل انتهينا الآن؟
– تقريباً.
أمرها بطباعة التقرير الأخير، وإرساله بالإيميل، ليلقى، غالباً، المصير نفسه الذي أحاق بسابقيه. هل ثمة من يقرأ، ما يكتبه، على الجانب الآخر من قناة العمل الاتصالية؟ يُخيل إليه، أحياناً، أن أحداً ليس هناك، في تلك الدواوين والمكاتب المؤثثة بالرهبة وباصطناع الجدية. لملم أوراقه في حقيبته الجلدية، والتقط رواية لــ”كونديرا” ليقرأ فيها بضعة أسطر، قبل أن يطرحها جانباً، شاعراً بتكاثف اليأس وتراكمه، طبقات على طبقات، فوق صدره. لماذا لا يطوِح بذلك كله، من وراء ظهره، ويمضي بعيداً؟ نطّ السؤال إلى وعيه بفجاجةٍ أليمة، فوجد نفسه ينهض، ويغادر المكتب، هرولةً، كالهارب من الحريق.
أمام عجلة القيادة، جلس متحيراً، وعاجزاً، عن إجابة السؤال الحرج:
-لكن، إلى أين؟
راحت السيارة تعبر القنطرة، المقامة على نهر “أبي الرقراق”، مخلفةً الرباط من ورائها، في طريقها إلى سلا. على أطراف غابة المعمورة، الشاسعة، أوقف، أخيراً، المحرك.
كانت الشمس تؤذن بالمغيب حين غادر العربة، متخذاً قراراً جنونياً بالتوغل على قدميه إلى قلب الغابة المظلمة. لوهلةٍ، توّهم أنه قادر على رسم خريطة، في الذاكرة، للخروج، وقتما يشاء، من تيه أشجار البلوط الفليني، السامقة، التي لا تُعد ولا تُحصى. كان قد دخل تلك الغابة، بالذات، عدة مرات من قبل، لكن في ضوء النهار، ومن دون توغلٍ عميق بدروبها الضيقة الملتوية المتشابكة. مضى، غير مكترثٍ، كالمسحور، أو كالمقهور، بقوة غلابة لا يملك حيالها شيئاً. ولأول مرّة، منذ استيقاظه في فجر اليوم، يشعر بنفسه يتنفس بقدرٍ من الحرية والانتعاش. أحس بقدمية تهرسان أوراق الأشجار، المتساقطة والمتيبسة، فتصدر عنها أنات التكسر والتهشم الخافتة، لتمتزج بأصوات الجنادب وخنفسات الغاب الصغيرة، وهي تنادي بعضها بعضاً. فكّر أن هذا ما ينبغي له أن يهتم به حقاً؛ أصوات الحياة التي تنادي الحياة، أصوات الحياة التي تتبادل الحياة، وفكّر أننا قد نمضي عمرنا، كله، متوهمين أننا أحياء، أننا نصنع الحياة ونعطيها، أو أننا، ويا للعجب، الحياة ذاتها، جسدها وروحها، فيما نحن، لسنا أكثر من، وهمٍ يُبحر في وهم، حتى أننا لسنا مجرد شهود يعبرون خفافاً قنطرتها السرية!
-ألا يمكن أن تكون الغابة مسكونة بالأفاعي، أو الذئاب، التي تنشط ليلاً؟ وهل من الحكمة اقتحام ممالك تلك الكائنات المرهوبة، في ظلام كهذا الظلام، ومن دون أي سلاح، ولا خبرات سابقة بالتعامل مع مثل تلك المواقف؟
حدّث نفسه، معتبراً أن مثل تلك الأسئلة، المنطقية كلها والعاقلة كلها، قد باتت فاهيةً منذ أن وطئت قدماه دروب الغابة وتاه بين شعابها وبركها، ثم لماذا ذاك الخوف كله من أخوته الذئاب؟! ولماذا يفضلون الكلاب على الذئاب؟! لطالما شعر، هو شخصياً، بقرابة أعمق تجمعه بالذئاب! الذئب أنوف بري عصي على التدجين، فهل من الإنصاف أن ُيدجِن سليل القرد سليل الذئاب، ويطوِعه لرغباته، ويبتز وفائه ومحبته لنفسه؟! هل من المقبول أن نصم الذئب، الذي يحافظ على ذئبيته، بالتوحش والغدر، فيما نغالي في وصف الكلب، الذي أهدر طبيعته الذئبية ليألف العيش مع القرود وبخدمتها، بالوفاء والنبل؟! أو ليس هذا معياراً بالغ الأنانية للحكم القيمي؟!
– أراك قد وصلتَ، أخيراً!
بادره الصوت نفسه، العميق القوي من طبقة “التينور”. تلفتَ حوله في الظلام، مفتشاً عن محدثه الذي عاجله بالقول:
– أتكلم لتراني.
– وهل كنت تتوقع مجيئ؟
قال بصوت يُرعشه السؤال، رهبةً ونشوة، فزلزله “التينور” بضحكةٍ مرحة متهكمة:
– بطبيعة الحال. لا أظنك جاداً في السؤال!
خفض رأسه متصاغِراً. أدرك، مع هذا “التينور”، أنه لا يملك، ولا يليق به، ادعاء أنه يجهل، قانون اللعبة الساري في الوجود منذ فجر يوم العالم. تابع “التينور”:
– بالتأكيد، لا أحد يحب أن يمضي من خلال النار، ولا أن يصل عبر الضياع في التيه، لكن الشرط هو على ذاك النحو بالضبط، أراك تحتج! هل تحتج؟
– أتساءلُ عن العدل وعن المعقولية، ليس الأمر أمر احتجاج ، بل تساؤل مضنٍ ومشروع.
– تساءلْ كما تشاء، من يملك الحق في منعك من التساؤل؟! لكن اعلم أن التساؤل، بالخصوص عن العدالة والمعقولية، لهو مجرد صراخٍ صبياني، تافه، بوجه الأب “الأناركي” الخالد، الأعمق معرفة والأوسع حكمة، وهذا الأب يقول إن الفوضى جزء أصيل من نظام كل شيء، أفلا تفهم؟
– إذاً، فإلى أين يمضي بنا ذلك كله؟ هل تقدر على أن تدلني؟
سأل بنبرةٍ ملتاعة أفصحت، بوضوح، عن انزعاجه وتألمه، فما كان من “التينور” إلا أن أجاب بهدوء ممتلئ ومكتفٍ:
– إلى أين؟ إلى أين؟ ولماذا ينبغي، برأيك، أن يمضي بنا إلى أي مكان؟ عموماً، هو يمضي بنا لا لهناك، ولا لهنا!
– لا هناك… لا هنا!
– بالفعل.
رد “التينور”، بثقة وجزم.
– والآن؟
– الآن؟! الآن، وقد انتصف الليل، فقد حان وقت العمل.
كان النهار لمّا يزل بعيداً، واللحظة، صار لديه ما يكفي من الليل ليسحبه لهناك، عارفاً أن هناك ليس كهنا، أو أن هنا لن يصير، أبداً، لهناك، أو أن، وهذا أمر مقطوع به نهائياً، لا وجود لا لهناك، ولا لهنا!