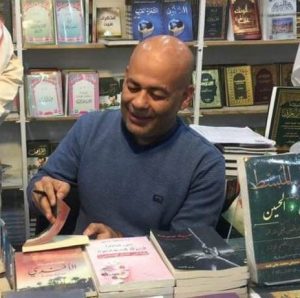إنجي همام
هناك أيام نحياها تصلح أن تكون نصوصاً حية، نصوصاً متحركة في شوارع المدن، نعود لنسطر كل خطوة خطيناها، وأيام بلا كتابة بلا وازع لحرف، أيام صامتة داخلنا وعلى الورق، لا تدفعنا سوى لمحاولة التخلص منها، وأيام محايدة قابلة لما نريد، ربما ببعض التحايل صارت كتابة جيدة …
صباح بلا لحظة نوم واحدة، رأسي مبعثر، ما الجديد في الأمر، عليّ أن ألملم شتات رأسي ونفسي وأستعد للخروج، موعدنا في العاشرة والنصف، بقيت ساعتان، ارتديت ملابس بلون العلم تقريبا ينقصها الأبيض، توشحت بوشاح سماوي عوضاً عن ذلك، ووضعت الكثير من المساحيق لتخبئة آثار الصحو الأبدي، في الطريق هاتفت “موسى” كما اتفقت معه، لن يتمكن من ملاقاتي على الموعد، في العمل لم يسمحوا له بالانصراف قبل الحادية عشرة، أخبرني ألا أستقل تاكسي، أن أستبدله بمترو الأنفاق وأترجل من ميدان التحرير وانتظره أمام تمثال عبد المنعم رياض، لعلي أضيع بعض الوقت ريثما يتمكن من المجيء، لم تكن ثمة مشكلة، فموعدنا في ماسبيرو في الحادية عشرة والنصف.
في المترو لم يكن هناك ما يلفت، كسائر الأيام تقريبا، يوم عادي شديد الحرارة متوسط الازدحام، نساء متكدسات في عربات خاصة بهن هربا من وجع الرأس، باعة لكل ما يمكن بيعه، وصغار غافلون فوق أفخاذ الأمهات، أشرد كعادتي مع الوجوه، أقرأ حكاياتها، بضع محطات وأنزل، الشمس شديدة بالخارج، من أين تسطع بهذه القوة في قلب الشتاء، لم نبرح منتصف فبراير، أبصرت الشارع خاليا تقريبا، أنا والشمس وظلي، سرعان ما انتبهت لوجودهم، كانوا هناك متربصين، على نواصي الشوارع، الشوارع الخالية إلا منهم، هذا الجو الخانق الحارق في آن معا يحيلني عقد وأكثر من الزمان إلى الوراء، حيث كان حاضرا كل الحضور، خرجتُ من منفذ الجامعة الأمريكية، طلة سريعة على محمد محمود ونظرة واسعة على الميدان، أمضي لبغيتي، صوب تمثال البطل الشهيد، على الجهة المقابلة للمتحف سرت ببطء، بحذاء شريط البازرات المغلقة، أكاد أعد خطواتي، فقد وصلت مبكرا رغم محاولات التلكؤ، تلفت نظري لافتة لم ألحظها من قبل، من مشروع “كان يسكن هنا فلان” كانت تسكن الجميلة رائقة الروح ” مديحة سالم” في مواجهة المتحف، يرن صوتها المرح في أذني فيزيح بعض تعاسة الجو العام، أتبسم وأقرأ لها الفاتحة.
الموعد لم يحن بعد لكني وصلت للتمثال، أدور حوله هربا من عيونهم المرشوقة فيّ، ثلاث دورات.. أربع .. كأني أؤدي صلاة قديمة، صلاة التلهي، لا أحتمل التفكير فيهم، أتفحص ساعة الهاتف، لازالت عيونهم تلحق بي، تلك العيون التي تعودت أن تحمل أسئلة خادشة لكل البشر، أسئلة لا تعني إجاباتها سوى أصحابها وحدهم، ولكنهم أصحاب كل شيء هنا، بعض الأشخاص متناثرين هنا وهناك، يهشونهم بعنف كما يُهًش الذباب، لم أكن لأحتمل أسئلتهم، هاتفت “موسى” لأتأكد من أنه تحرك، كان في الطريق، الطرق خالية بشكل موحش، لابد سيصل سريعا، الشمس تأكل عقلي، ملابسي لم تكن مستعدة لمواجهة ذلك الحر، أجفف جبيني مرات وأذهب بعيدا للبحث عن سلة ألقي بها مناديلي الورقية، أبتعد قليلا عن مواجهتهم على ناصية “محمود بسيوني”، بعد دقائق طويلة -في شعوري- جاء “موسى”، ترجلنا لماسبيرو، لم نكن قد التقينا منذ فترة طويلة، نتبادل الأسئلة عن الأحوال، نتلهى عن تلك العيون المتفحصة، بالقرب من ماسبيرو كانت الحياة عادية، نفس البائعات يفترشن الأرض بخضرواتهن، نفس الباعة بعربات الكارو، طقس لا يليق بالطريق إلى مبنى تلفاز الدولة!!، لكنه العادي، أي شيء هنا يليق بموقعه؟، نجلس في بهو المبنى ننتظر معدة البرنامج، شاشات عرض كبيرة تعرض تاريخ الزعيم، الانجازات الكبرى واللحظات الجليلة، لكل زعيم إنجازاته التي لا تُعد ولا تُنسى، لكل منهم تاريخه الحافل، كنت أعرف أن “موسى” رجل ذو وجه واحد، في زمن الأوجه التي لا تُعد لكل فرد، كنت أعرفه صادقا نزيها لا يتلون، لكنها كانت المرة الأولى التي أرى فيها شجاعته، وسط البهو الصغير، بجوار كل من يتسمعون، وسط عقر دارهم أخذ يسب ناقما على كل هذا الزيف، يلعن التضليل والتهليل، نظرت له حائرة، فرحة ومضطربة في آن، هناك من ينصر الحق بتهور جامح، لازال هناك البعض، لم يقضوا على السلالة، لم تنقرض بعد، أعرف بوجودهم بالطبع ولكني أندهش في كل مرة كأنها الأولى، غير أني على يقين من أنهم موجودين، بعضهم لازال طليقا يمشي في الشوارع، بنصف عقل وقلب مشوش وروح مهلهلة، ولكنهم أحياء، يتلفظون بما شاءوا في وجه أكاذيب العالم، يخرقون أعين السفهاء البلداء.
مررنا من الماكينات بعد أن أخذوا هوياتنا، كان موعدا غريبا للغاية، كان حديثاَ عن السينما في يوم سينمائي بامتياز، لكنه لم يكن الأنسب مطلقا، كان الموعد محددا سلفا، بعض الأشياء عليها أن تحدث في موعدها مهما طرأت من مستجدات، تسألني المذيعة الشابة نفس السؤال بطرق عدة، وأحاول إعطاء إجابات توسع دائرة المعنى، حصرتنا في زاوية، بل نقطة، التففتُ حولها ما استطعت، كان ما تبقى من ذهني يتململ من كل هذا، تنفست الصعداء مع كلمة الختام، جلستُ بعيدا أتأمل الاستوديو، جاء دور “موسى” وانتظرته كما فعل معي، الكاميرات والمخرج والإضاءة، مرايا لطقس مماثل خارج الاستديو الصغير، لكن الاستديو العملاق كان يشهد تصوير فيلم قصير، فيلم لمدة نصف يوم، ربما أقل من ذلك، أسعدني الاختباء هنا ريثما ينتهي التصوير الخارجي، بعض البرودة الداخلية تريح عقلي، لاسيما بعد أن انتهت الأسئلة، ينجح “موسى” مع المذيعة الشابة، يأخذ الحديث حيث يريد، أشاهده بإعجاب، إنه متمرس مع مثل تلك المواقف، كنت قد قاطعت تلك اللقاءات منذ زمن، اتخذت منهاجا جديدا واتبعته، الابتعاد عن العالم .. الاقتراب من نفسي، جئت اليوم من أجل موسى، على الأرواح المتشابهة التلاقي من حين لحين، أنهى حديثه بابتسامته العذبة وانطلقنا خارجين، رغم أن الفيلم لا يصوًر بوسط المدينة، لكنها دوما محط مخاوفهم، لازالوا يعسكرون على نواصي الشوارع، أعرف أنهم مجبورين، تقفز لفظة أحدهم لأذني ونحن نعبر الشارع صوب محمود بسيوني، “كل الفلول هناك طبعا” ابتسم من ذلك الفيلم الهزلي، كان عليً أن أقهقه، لكني لم أرغب في تضخيم أمارات الجنون، ليس من الضروري أن يعرف الجميع، علني شخص عادي اضطره سوء حظه لنزول وسط المدينة اليوم، نبحث عن مكان لنجلس فيه، كل الأماكن مغلقة تقريبا، نتجول بلا وجهة على أمل الجلوس.
في منتصف “حسين المعمار” مقهى صغير يزاول نشاطه، إنه شارع داخلي، لا يشكل قلقا، يسألني “موسى” هل نجلس هنا فأوافق، نطلب قهوة وسط – كما أحب أن أدعوها على الطريقة الشامية- ونثرثر قليلا، كتابي وروايته، الجرائد والمجلات والعمل، الندوات والأصدقاء، حال الدنيا، تعود عقولنا حيث نحن، لا نتقن الهرب طويلا، هذه المشاهد التمثيلية التي تؤديها بلدة بأكملها حيث يجيد الجميع دوره، ليس لأمثالنا فيها دور، نحن مشاهدون مرغمون على المشاهدة، لو تمكنا لقاطعنا كل ذلك، لأوقفنا ذلك المخرج العابث عند حده، للسينما أصول، لكن جميع الأصول والفروع هنا فارقت منذ زمن مضى، يخاف كل منا أن يزيد أوجاع الآخر، نقرر التحرك بعد وقت قصير.
أودع موسى عند منفذ المترو الذي خرجتُ منه وأعود أدراجي صوب الداخل، أبدأ بهدى شعراوي، “تنمية” الحبيبة أول ما يخطر ببالي عند نزول وسط البلد، أسأل “نهى” عن رواية “سحر الموجي” الأخيرة وبعض الكتب في السينما، أحمل ما اشتريت وأمضي بلا هدف بعينه، كنت في انتظار صديقة، بقيت ساعتان على الموعد، أتمشى “بقصر النيل” ومنه أعرج على “شريف”، أشتري بعض اللوحات الجديدة وأتجه صوب “كوستا” كي أستريح من الشمس، أتذكر ذلك المركز الثقافي المفتتح جديدا بالإيموبيليا، على كل حال كنت سأمر عليها كالمعتاد ولو من دون أي جديد، المرة الأولى التي ألج برجها القبلي، هذا إن لم تخونني ذاكرتي، ولكني اعتدتها خائنة، أسال الحارس عن المركز في أي الأدوار يقع، كانت مصلى صغيرة اتخذت موقعها في نفس الدور، على بعد خطوتين من باب الشقة التي يقع فيها المركز، كدت لا أرى اللافتة من ذلك التشويش، ضربتين على جرس الباب وكنت سأغادر، ظننتهم لا يعملون نهارا، تفتح امرأة لها وجه صبوح، يدخل القلب سريعا، يحتويني ذلك النور الجم المنبعث من المكان ومن روحها، كانت كل النوافذ مشرعة، الأرضيات الخشبية لامعة، تنبعث منها رائحة الطلاء الجديد، تؤكد هي ذلك وهي تصحبني لمشاهدة المكان، عدة معارض صغيرة تحتل قاعتين مفتوحتين على بعضهما، أفكار طازجة وشباب يبعث بأمل غريب، لا أعرف من أين يأتي به، لكنني اعتدت ذلك أيضا، تشرح لي أنشطة القاعات الداخلية، واحدة لليوجا وأخرى لورش الكتابة وثالثة للفنون التشكيلية، مكان عرف كيف يخطف روحي، نتبادل التعارف والكروت الشخصية وأعود لكوستا، فراولة مثلجة في هذا الصيف الشتوي كانت أول ما طلبت، أهاتف صديقتي لأخبرها بمكاني، وانتظرها فيه، كنت أختبيء ريثما ينتهي كل شيء، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، حتى طبيعتها لم تعد طبيعية منذ كثير من الوقت، ولكننا نعتاد، اعتدنا أن نعتاد .
مؤخرا اكتشفت أنني أنتمي لزمن المخابيل، والمخابيل لا زمن لهم يخصهم وحدهم ويعسكرون فيه، ذلك محض مجاز، إنهم موزعون على الأزمان، ليس بالتساوي، لكل عصر نصيب، أولئك الذين لا يتسقون مع زمن، مع أي زمن، لكل الأزمان خواصها وهم متمردون على الخواص، متمردون على الدنيا بحد ذاتها، المكان صاخب كعادته، سحب دخان وسحب موسيقى عالية وضجيج أحاديث شتى، أحتسى قهوتي الثانية مع إيناس على روح المرحوم وننزل لنضيع في زحام المدينة. في المساء أنام بسرعة شديدة للمرة الأولى منذ وقت لم أعد أذكره، في المنام أرى مدينة خالية من الناس، تملؤها أشباح متشحة بالسواد يسجدون لجثث متقيحة ..