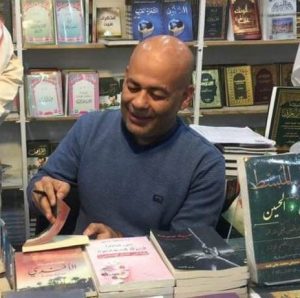ومن نافذة التاكسي بدت له الناس غير الناس، ورغم ضعف سمعه كان الضجيج يفوق الاحتمال. في الإجازات النادرة التي قرروا قضائها في مصر كانوا يتجنبون العاصمة تماماً، فيذهبون إلى شواطئ ومنتجعات نائية، شبه خالية من المصريين إلا من يعملون ويخدمون هناك. وراح يتطلع إلى الشوارع بعين تتذكر وأخرى تنكر ما تراه. حين أحسّ أنه يتذكر المكان أمر السائق بالوقوف، ثم عثر على البار القديم بسهولة فاستسخف نفسه. هبط بضع درجات إلى القبو العتيق الرطب مطأطئ الرأس خشية الارتطام بإطار الباب الخفيض. وارتمى بثقله الهائل على مقعد غير بعيدٍ عن تيار الهواء المنبعث من الخارج، وراح يتساءل كيف كنا نسهر في هذا القبو المعتم سيء التهوية كأنه جُحر فئران أو زنزانة انفرادية ومع ذلك نضحك ونغني مثل من ملكوا الدنيا بما معهم من قروش معدودة؟ ومع ذلك فمازالت محطة أم كلثوم تنثر الأغنيات القديمة كماء الورد في الجو، ومازالت البيرة برداً وسلاماً رغم اعتلال الصحة وفوات العمر. لكن ما معنى هذه النظرة على وجه النادل العجوز؟ وطيف الابتسامة الذي تأرجح للحظات فوق شفتيه؟ هل من المعقول أنه كان يعمل هنا أيضاً فيما مضى، وأنه ما زال يذكره؟ وهذا الوجه الأصفر المجدور ثمة أثر له في ذاكرته فكيف كانت صورته قبل ثلاثة عقود؟
“حمد الله ع السلامة يا زكي بيه“.
الصوت نفسه، الصوت الخشن الجافي، هو ما نفخ الرماد عن الجمرات القديمة، لكن كيف تحوّل الوجه وصاحبه إلى هذا الحطام؟
“مين؟ محمود أبو شامة؟“.
“هو بعينه يا باشا؟“.
بيه، ثم باشا؟ يعاملك معاملة الزبون المحترم، وقد اختفت قسوة الماضي مثل حلم ثقيل في قيلولة بعد غداءٍ دسم. انتزعك الصوت أيضاً من الحاضر ومن البدلة الكتان والوشاح الحريري نبيذي اللون، ليرمي بك بلمسة واحدة إلى أواخر الخمسينات، حين سال الدم من أنفك وفمك أمامه بسبب مباراة كرة قدم أحرزت فيها هدفاً في فريق أبو شامة. اختارك الفريق لتلعب ضربة الجزاء، تضع الكرة أمامك على تراب الشارع، ثم تبتعد بضع خطوات للوراء، تقف للحظات داعياً الله ألا يخزل فريقك، ثم تنطلق نحوها وتركلها بكل ما فيك من عزم. هدف، ثم المشاجرة المفتعلة، ثم دمك على الفانلة الداخلية البيضاء. وأبوه غير بعيدٍ عنكم، يجلس أمام مقهاه مثل امبراطور على عرشه، في حين يسير أبوك الكاتب في مشيخة الأزهر جنب الحيط، ويقول لأمك بعد أن سال دمك: “أهو كله لعب عيال وبكرة تلاقيهم بيلعبوا مع بعض تاني“.
قال: “عُمر تاني“.
“مسير الحي يتلاقا“.
ثم يتركه منفرداً بالذكريات ويروح يتنقل بين الموائد القليلة المشغولة في تباطؤ وكسل، موزعاً العبارات والابتسامات على الروّاد الثابتين. ومن وراء نضد البار يجلس رجلٌ هائل كالدب، أحمر الشعر بالصبغة أو بحكم طبيعةٍ مجنونة، مغطى الصدر والرسغين بالحلي الذهبية، وفي عينيه نظرة ناعسة لكنها تلتمع بذكاء مطمئن.
لا أحد بوسعه أن يُخمن مدى سعادة هذا النادل العجوز بالمصادفة المجنونة، أخيراً خرج الغريم القديم من صناديق الماضي المغلقة، خطا بقدميه إليه حيث يجلس بين يديه، ولن يتركه يمضي في أمان الله مهما كلّفه هذا، ولو عاد للسجن ليقضي هناك أيامه الأخيرة. فليهنأ بالشراب ويستسلم للذكريات دون أن يدري شيئاً عما ينتظره، ودون أن يدري شيئاً عن صورته القديمة التي عثر عليها بين أوراق المرحومة، ومازال يحملها في محفظته حتى الآن، ربما ليتجدد حقده عليهما إلى الأبد، أو لتذكره بجريمتها، نعم هي جريمة وإن ارتكبتها بالخاطر والأحلام دون الفعل المجسّد. ظلّت تحب هذا الرجل حتى بعد أن تزوجها وأنجب منها البنات والبنين. ويوم حادثة اللوري على الصحراوي، دعت عليه وهو على باب الشقة: “روح إلهي تروح ما ترجع يا بعيد”. كان يقود الشاحنة مسطولاً، يتذكر دعائها عليه أمام عجلة القيادة. مؤكد أنها استراحت من ضربه لها حين دخل السجن، ولم تزره إلا مرة واحدة مع ابنه الكبير، ثم قالوا له إنها ماتت ودفنوها في البلد. قال أنا قتلتها، كما قتلت سائق البيجو والراكب المجاور له على الطريق. ثم يجد صورته بين أشيائها القديمة، وتسأله ابنته المتزوجة ببراءة عن القمر صاحب الصورة الأبيض في أسود، فيردد أنه صديق من أيام زمان، أيام العز والسهرات، أيام جدك أبو شامة الكبير الله يرحمه … فتردد البنت “ربنا يرحم الجميع“.
نعم، ربنا يرحم الجميع، ماذا سيفعل هذا الباشا حين يُريه في اللحظة المناسبة صورته القديمة تبرز من محفظة غريمه، تخلصتِ المرحومة من الرسائل بلا شك، لكن قلبها لم يطاوعها على التخلص من صورة الحب الأول. وكانت تدعو عليه، وعاش عمراً يختنق بالذنب لأنها يضربها ولأن أخلاقه الفظة هي ما تسببت لها في الضغط وأزمات القلب حتى ماتت دون الخمسين. إلى أن عثر على الصورة القديمة فاستراح ووضعها في محفظته وهو لا يدري لماذا، ربما ليتذكر كلما عضّه الندم أنها خانته في نفسها، وأنها استحقت معاملته له معاملة العبدة، وأنه كان المغفل الوحيد في هذه القصة، وإن اعتبره الآخرون وحشاً قاتلاً، فهو على الأقل لا يخدع ولا يخون.
مرّ بمائدة الغريم القديم راسماً ابتسامة واسعة، رفع يده فوق رأسه وهو يحمل زجاجات فارغة عن مائدة خلت منذ قليل، “والله زمان يا ابن حتتي”. ثم تركه في قبضة الذكريات. توالت على ذهنه الصور القديمة دفعةً واحدة منذ أن رأى محمود أبو شامة، أيام عابدين والكفاح المذل لمواصلة التعليم رغم كل الظروف، وأبوه يضع الراتب أمام أمه على الطبلية ويقول عبارة كل شهر الخالدة: “دبرني يا وزير”… فتبتسم وهي تتناول الجنيهات بابتسامة تسليم، وتردد جوابها الشهير: “على الله التدابير.” ووسط هذا كله كانت إنعام مثل وردة على نافذة سجين، مجرد التطلع إليها ينسيه كل شيء، قلة الحيلة والانكسار وبيجامته الكستور من قماش معونة الشتاء، كل شيء إلا الطموح الذي ينهش صدره ليل نهار. أما ابتسامتها من شباك المطبخ فكانت كفيلة بأن ترقّص روحه حتى الدوار، وبأن تدور الجدران من حوله كأنه الزلزال.
انتبه لظل صديقه عادل يغطي المائدة، فالتفت نحوه. الأحضان المتوقعة والشوق الصادق. هذا رجلٌ لا تعرف دنيا الناس كيف تُعكر صفاءه. قال الصاحب القديم: “لقيتك سرحان ومبتسم كده، قلت أكيد بيستعيد ذكريات زمان، إيه رأيك بقا؟”، مشيراً بحركةٍ من يده إلى المشرب العجوز مثلهما. والحق أنها الذكريات، لكنه لا يكاد يذكر شيئاً عن سهرات هذا البار أو غيره، ابتسم لصاحبه قائلا: “آه، فعلا، الذكريات“.
لكن عين الذئب المهدّم لا تتحوّل عنه، فماذا يريد الآن ابن أبو شامة؟ وهل مازالت إنعام ملك يمينه؟ كم أنجبت له من العيال؟ هل مازال للوردة الذابلة رونقها القديم؟ كيف يسأل وهل يحق له السؤال؟ جلب العجوز البيرة لصديقه، وهو يقول: “مساء الجمال يا عادل باشا”، يعرفه إذاً، لا بدّ أن صاحبه يتردد على ركن الذكريات بين الحين والآخر. “شكراً على الناس الحلوة اللي بتشرفنا بيهم”. ما معنى هذا؟ ولماذا يشعر أن في كلامه لغزٌ وعليه هو أن يحله مازال عادل يعزف نغمته المفضلة، نغمة السكينة في عالمٍ مريض ومجنون. ما أروق بالك يا عادل، ومهما فتش فلن يجد في صوته أو نظراته ما ينمّ عن حقد مكبوح أو حسدٍ لصاحبه المحظوظ الشهير، رغم أنه مازال كما هو تقريباً، وسيخرج قريباً على المعاش بعد أن صار مدير قصر ثقافة لا يكاد يشعر بوجوده أحد. ولكن من أين يأتي بذلك الروقان والنغمة الهنية؟
للحظة أوشك أن يحكي له كل شيء، حكايته القديمة مع إنعام وهذا العجوز الذي اختطفها منه مستقوٍ بمال أبيه ونفوذه، ومحاولة انتحار إنعام قبل زواجها بيومين والفضيحة التي أوشكت أن تهدم بيوتاً، لولا النصيب. تراجع عن الفضفضة حتى لا تفلت منه كلمة فتصل إلى مسمع العجوز، فمن يدري هل انتهى مخزونه من السُمّ أم مازالت بداخله بضع قطرات أخيرة تنتظر ضحيتها.
تحدثا كثيراً عن كل شيء، حال البلد ومستقبله، عن العيال وتعليمهم وجامعاتهم، تحدثا عن الفيلا الجديدة التي اشتراها في الشيخ زايد والزيارة الواجبة قريباً. والبيرة تتوالى ومعها تتوالى نظرات أبو شامة، وعباراته التي يزداد غموضها بالتدريج، “لسه شريب زي زمان يا زكي بيه”، ثم وهو يرفع ذراعيه على جانبيه كمن سيرتفع عن الأرض ويطير: “النهارده كأني رجعت تلاتين سنة لورا”، وبينما يضع أطباق الجزر المقطع والبطاطس المسلوقة: “هاين عليّا أدبح لكم خروف، بس بصلة المحب خروف”. وكلمة الذبح ما أنسبها على لسانه، وصديقه الطيّب غافل في دنياه المسالمة عما تضمره الصدور، ولعلّه مازال يزرع الريحان في أصصٍ صغيرة بمكتبه بقصر الثقافة كما كان يفعل وهو موظف شاب، أعزب مغترب يعيش في غرفة فوق السطح. لكنه امتلك من الجرأة أن يتزوج في شرخ الشباب وهو شبه مفلس من ممثلة المسرح الجميلة غير مبالٍ بالشائعات والكلام الشائن، فهجرت هي التمثيل والأحلام الملونة من أجله، وصمد معدنها النفيس أمام امتحان الأيام. أما أنت فقد سعيتَ وراء ابنة الرجل الكبير بالسفارة المصرية في الكويت حتى تعلقت بك وتزوجتها، فكان نصرك الأهم، الأستاذ الجامعي يضمن الجاه والنفوذ. وفي المؤتمرات العلمية بالخارج يعاملونك باحترامٍ حذر، لا يشي باستخفافهم أو خشيتهم منك بسبب صلاتك المعروفة بأمراء وشيوخ الخليج. الخبير الاقتصادي وجهه ليس غريباً على الصحف وشاشات الفضائيات، والأموال في البنوك تتناسل أسرع من الأرانب في عشتها، ولكن أين إنعام الآن؟ هل ضمها القبر أخيراً، آه لو أمكنه أن يسأل هذا الحيوان.
ووجد في نفسه فجأةً ميلاً للتباهي، وكالعادة لم يستطع أن يكبحه، خاصةً ليكيد ابن صاحب القهوة الذي جار عليه الزمن كما هو واضح. فنادى عليه وسأله عن أنواع الخمور المتوفرة في البار، وأبدى أمارات الاشمئزاز بسخاء إزاء جواب محمود، وطلبَ منه أن يشتري لهم زجاجة ويسكي محترمة من أي محلٍ قريب، فأرسل أبو شامة غلاماً ضئيلاً ونحيلاً مثل قرد ظهر فجأة من الهواء، بعد أن نبّه زكي بيه أن فتْح زجاجة من خارج المحل له حساب وحده، فردد البيه: “مفهوم، مفهوم”، وحدثت أبو شامة نفسه بأنه الليلة ليلته، وما عليه إلا أن يلعب بصبرٍ وذكاء. ولن يبقى الخواجة ابن الحرام طويلاً، فقبل منتصف الليل سيأتيه ابنه بالسيارة كالمعتاد. انتهز زكي الفرصة ومدّ يده بسيجارة مارلبورو، وسأله: “وكيف أحوالك دلوقتي يا ابن حتتي؟” فابتسم أبو شامة عن فمٍ خرب، لا تقوم به إلا أسنان معدودة، ثم قال: “نحمده على كل حال، العيال اتجوزوا، وأنا من يوم ما طلعت م السجن ماليش متوى غير هنا، أوقات مابرجعش البيت باليومين والتلاتة“.
“وإنعام؟”، لا يدري كيف أفلتَ منه السؤال، فتغيّر لونه وحدّق في كأسه.
“الولية تعيش انت من زمن“.
“البقاء لله يا محمود“.
معلومات أكثر من اللازم بسيجارةٍ واحدة، أكثر من أن يستوعبها ذهن العائد حديثاً والداخل لتوه في نشوة الكحول. كيف غلبه لسانه بالسؤال عنها. “الولية تعيش أنت من زمان”، كيف صارت إنعام ولية، ومادام تجاهل الموتُ هذا المخلوق الفظ يحق له أن يقطف الورد. ولكن السجن؟ ماذا عن السجن؟ وكيف تحوّل ابن المعلم العظيم سجيناً سابقاً يخدم على الموائد. ألا نخدم جميعاً على موائد الآخرين؟ قاطع صديقه عادل أفكاره، معترضاً على فكرة شراء زجاجة فاخرة، وراح يحدثه عن الصحة وساعات النوم المقدسة، وعن العشاء مع زوجته التي لا تأكل حتى يعود. لكنه لم يستطع الانتباه لحديثه، فقط يومئ برأسه كأنك يسمع ولا يسمع في الحقيقة إلا صوت إنعام ينبعث من مطبخهم وهي تغني: “ولا زيك مية، يا أبو العين العسلية”، وكنتَ أنت صاحب العين العسلية، وكنت أنت المقصود دائماً بغنائها وضحكاتها المجلجلة، ويومَ أخذتها في حضنك وأكلت شفتيها أكلاً في القناطر الخيرية كان عيداً رسمياً بالنسبة لك، قسم تاريخك الشخصي لمرحلتين ما قبل القناطر وما بعدها. وتأوهات فتاة عاشقة أحلى من المديح في أذن طاووس مغرور. حتى اعترض الوحش طريقك وقال لك: “مالكش دعوة بإنعام بنت سيدة الخياطة، فاهم؟”، وقبل أن تتمكن من التفكير في جواب كان قد تابع سيره كأن المسألة لا تستحق أكثر من هذا.
وصلت الزجاجة ومعها المزّات المخصوصة التي طلبها، أطباق خفيفة لكنها جديرة بفندق محترم وليس باراً تعساً كهذا. وراحت الأعين تختلس النظرات نحو مائدته، وكم أعجبه هذا. وصديقك يتخبط في خجله وتردده، إلى أن حسم أمره وقال إنه سينصرف بعد قليل، هناك العشاء المقدس مع الزوجة الحبيبة ثم قصر الثقافة في الصباح. دون حسابات في البنوك ودون مؤامرات أو مخاوف، كيف؟ ما أسعده بعيش الطيور هذا. ولم يتناول حتى كأساً من الويسكي الفاخر، وقال إن خلط أنواع الخمور يؤذيه وإن البيرة فيها الكفاية، وسوف تنتبه فجأة لمغادرته وأنك سلّمت عليه وودعته قبل قليل، وستعرف عندها أنك بدأت أولى خطواتك نحو السُكر، ولن تعلم إلا متأخراً أنه دفع حساب البيرة لكما قبل أن يمضي، سيهمس بذلك أبو شامة في أذنك وستشم رائحة نتنة تنبعث من جسده أو من فمه. وستغمغم له “معلش، الجيب واحد”، وستجد نفسك تدعوه إلى كأسٍ معك، ربما طمعاً في المزيد من المعلومات والخيوط. يتردد لحظات، ثم يسحب كرسياً ويجلس في مواجهتك.
هذا الوجه يعرفك، يعرف أيام البيجامة الكستور والشبشب البلاستيك قبل زمان الكتان والحرير وأحذية كلاركس. وإذا كان لا يُخجلك شيٌ من هذا فالأهم أنه يعرف بهزيمتك أمامه، عيناه تكشفان ذلك ببساطة. لقد تزوجها ولو رغماً عنها، وأخذها بعيداً عن المنطقة كلها إلى عمارة أبيه في شارع بورسعيد. ورحتَ أنت تتسقط أخبارها على ألسنة الجيران والمعارف من بعيد كأنك لا تهتم، وعند وفاة أمها سيدة تبدتْ في الثياب السُود منفوخة البطن بالحبل محمرة الأنف والعينين وذاهلة عن الدنيا بمن فيها، فتتمنى لو تنشق الأرض وتبتلعك. ولكن من هذا العجوز القبيح الذي يجلس أمامك مطرقعهاً أصابعه على أنغام أغنية وردة، وكيف سمحتَ لصديقك الطيّب أن يترك مكانه لهذا الثعبان الذي يكاد سمه أن ينفد؟ ما أحوجك إلى الريحان الآن، في هذا الجو المغلق الخانق، وحتى نظرات الإعجاب من الزبائن الآخرين تبددت وعاد كلٌ إلى شرابه ودنياه. ويتمتم اللئيم: “احنا إنهارده زارنا النبي”، فكأنني ضيفاً في بيته. ويناديه الدُب من وراء البار، فينهض بخفة، هامساً وابتسامته تكشف مغارة فمه البشعة: “لسه الليل طويل يا ابن حتتي، ولا إيه؟“.
يمكنه الآن على الأقل أن يضع همه في الشراب، وينتبه للمرة الأولى أن الموبايل خالٍ من التغطية، وأن هذا القبو العجيب تنقطع فيه الخدمة، فيدرك سبب خرسه طوال كل هذا الوقت. ينهض بصعوبة، ويخرج من باب المكان ممسكاً بالموبايل فتتابعه أكثر من عين كأنه سيهرب من الحساب. أمام المكان اكتشف أن الليل أوغل وزال حر النهار ليسمح للنسيم باللعب ولو قليلاً. عبّ من الهواء النقي بعمق وأحس أنه سعيد ومحظوظ وأنه لم يعد يكترث لشيء في الدنيا كلها، وأنه سيبقى ساهراً في هذا البار الحقير حتى الفجر، ولعلّه يتصالح والوحش ويبكيان على صدر أحدهما الآخر في النهاية كعاشقين لإنسانة واحدة. رأى أرقام زوجته والبيت وآخرين تتابع على شاشة المحمول في محاولات سابقة للاتصال به، اتصل بالبيت، ولم يحاول حتى أن يواري ثقل لسانه: ” مافيش شبكة في المكان اللي أنا فيه، واضح إن سهرتي هتطوّل شوية، لأ، معلش، هأرجع براحتي بقا، ناموا انت.”
نعم، ناموا أو اسهروا أمام الشاشات كالعادة، شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر أو أي شاشة أخرى، فهذا ما تفعلونه طوال الوقت. ناموا مطمئنين فلا شيء يمكنه أن يهدد أمنكم وأمن أيامكم الآتية، حتى موتي لن يهدد مستقبلكم المضمون. أمّا علتي أنا فهي الماضي.
عاد لمائدته، وسرعان ما صبّ لنفسه كأساً آخر، وأحس فجأة كأنه يتذكر سهرةً قديمة قضاها هنا، مع شلة رفاق الجامعة ورأى نفسه يميل في ركن المكان ويتقيأ وأصحابه يضحكون ويسخرون، فابتسم للذكرى. وارتفع صوت آلة الساكس بديعاً في مطلع أغنية فات الميعاد، فراح يميل برأسه مع تراقص النغمات. كانت تلك السهرات القديمة حقيقة واقعة مثل هذا الحاضر تماماً، فكيف التهمتها الذاكرة الخائنة، وكانت إنعام وجسدها حقيقة أخرى فالتهمها القبر بعد أن أتى عليها هذا الوحش الأسير. اتخذ قراره بأن يكاشفه ه بكل شيء، مهما كانت النتائج، ومن عجب أنه سمعه يردد مع الست بعد قليلٍ وهو يرميه بنظرة نارية: “ستاير النسيان نزلت بقالها زمان…وتفيد بإيه … إيه… يا ندم، يا ندم، يا ندم…؟” فأحس كأن أفكارهما تتجاوبان خلسةً دون حديثٍ منطوق، وانتشى لهذا وقال إنه من الغد سيصالح العالم كله، وسيتبع بعض نصائح صديقه النبيل عادل التي طالما سخر منها، فيعتدل في كل شيء ويمارس بعض الرياضات الروحية كالتأمل وربما استعاد عواطفه نحو زوجته وأولاده وأسرته التي نسيها بمرور الأيام. “والزمن بينسي حزن وفرح ياما”. عاد محمود من أمام باب البار مكفهر الوجه. وكان الدُب أحمر الشعر قد سأله في غلظة قبل أن يدخل في السيارة: “هتقعد تسكر وتغني مع الزباين ولّا إيه؟ صحصح عشان تاكل عيش يا محمود“.
فأجاب سريعاً بابتسامة خاضغة: “معلش يا خواجة، آديك شايف، زبون صقع وإيده فرطة ولو انبسط رجله هتجيبه كل يوم هنا“.
ولولا أحمر الرأس هذا لكان أبو شامة يتسول لقمته أمام أبواب عياله، وهم أنفسهم يشقون على اللقمة من طلعة الشمس. وفي سجن مزرعة طرة كان يخدم ابنه المدان في قضية أموال عامة كأنه عبده الأمين، يغسل ثيابه ويعتني بطعامه وشيشته ويبعد عنه الأوباش من مساجين قضايا النفوس والعاهات. وقبل أن يخرج سجين الأموال العامة أعطاه عنوانه وأرقامه. عبدٌ في السجن وخادم أجير في هذا البار بعد أن خرج. وقبل سنوات كانت فلوس أبيك تعمي العيون، حتى عينيك أنت، والمخدرات تجري تحت قدميك أنهاراً، واليوم تكاد ترقص بعد كأس ويسكي من النوع النظيف عطف به عليك حبيبها الولهان، الذي لم يخجل من نطق اسمها بالفم الملآن، “إنعام” كأنها عشيقته. عاد ليأخذ نصيبه، أصبح لامعاً مثل الجنيه الذهب فرحم الله الوقفة في طابور الجمعية والوابور الجاز واللحمة التي لا تزور بيتكم إلا كل طلعة عيد من بيوت المحسنين أمثال أبي المعلم أبو شامة. لكنه عاد ليأخذ ما فيه النصيب، فماذا سيفعل به؟ لا بدّ أن تمتد الخديعة لأطول وقت ممكن، فلنشرب ولنهنأ حتى مطلع الفجر، وسوف يتلذذ بتعذيبه هكذا على نار هادئة، لكن حاذر أن يمضي قبل أن موعد الإغلاق، هكذا تضيع فرصته وربما لا أرى وجهه مرة أخرى حتى نقابل وجه كريم. بدأ محمود أبو شامة يستعجل زبائنه على إنهاء شرابهم الأخير، لأنه سيغق مبكراً الليلة. تلقوا التنبيه بسخطٍ وسباب، ولم يكترث لهم وخرج يجري اتصالاً هاتفياً ضرورياً على سبيل الاستعداد.
اضحك له يا محمود، اخدع غريمك ولو مرة، فالسنين علمتك الكثير والسجن أكثر. لا تنكر أنك كنت أحياناً تجيد تسلية المعلمين ذوي القلوب الميتة حتى لا يركبونك أنت إذا ملّوا الشباب الناعم. تغني لهم مواويل عبده الاسكندراني بصوتك الأجش السالك، وتطحن لهم البرشام وتخلطه بالتبغ، وتسخر من خصومهم حتى ينقلبوا على أقفيتهم ضاحكين، وربما منّ أحدهم عليك بصفعة محبة. أين عرش الأسد الجريح؟ كيف سلبته منه الدنيا برحيل أبيه؟ وكيف حجزوا على القهوة ووقفتَ لم تحرك ساكناً وكلك ثقة في الغد؟ وفي أي شقوق تلاشى أنداد أبيك وصبيانه الأوفياء؟ ومع الأيام وجدتَ نفسك سائق لوري وأقنعتك الخبيثة الخائنة باللقمة الحلال وبثتْ فيك خوفاً جديداً عليك من الله والأيام والحكومة، فوجهتَ غضبك إليها وحدها وحرمت بقية الخلق منه، ونزلت إلى أسوأ أنواع المخدرات، حتى غرز البوظة عرفت طريقها وشربت السبرتو الأبيض حاف تقريبا. وحين وقعت الواقعة لم يدخل السجن إلا شبح محمود أبو شامة، بعد أن كان هو قد مات وشبع موتاً. “من ناري وطول لياليا، وفرحة العزال فيا”. ثم يأتي الوسيم الأنيق البدين كأنه مأمور سجن، ليدعوني للشراب ويسألني ببجاحة عنها باسمها، ألا يود أن يعرف أيضاً كيف كانت في الفراش؟ سأخبره بذلك عن طيب خاطر ولكن بعد أن أرى دمه يسيل على جذمتي مخرومة النعل.
اقترب منه مائدته، وكان الآخر في دنيا بعيدة، يردد: “وقسوة الدنيا عليا، وقسوة الدنيا عليا”. لا تكاد تكتمل في ذهنه فكرة أو صورة حتى تشغل مكانها أخرى في سرعةٍ عجيبة. وأدرك فجأة وجود غريمه القديم أمامه فنظر له مشفقاً ومفتشاً فيه عن العدو الذي طابت له إهانته والسخرية منه كثيراً، وأحب أن يستفزه ولو قليلاً ليستعيد شيئاً من طعم العنفوان الآفل، فسأله: “كل واحد بياخد نصيبه يا أبو شامة، يا ترى إيه رأيك في نصيبك دلوقتِ؟”. فيجيبه العفريت دون تردد، مقبلاً راحة يده وجهاً وظهراً: “عنب بالصلاتو ع النبي، عيالي بخير وعيال عيالي يشرحوا القلب الحزين، والست الله يرحمها كانت حتة سكرة، هنعوز إيه أكتر من كده يا باشا… المهم كل واحد يرضى بنصيبه.”، ثم صبّ لنفسه كأساً جديداً من الويسكي بلا استئذان.
سأل نفسه من أين أتته هذه الحكمة على كبر؟ في السجن أم بين الموائد؟ أم لعلّه تلقى دورساً من صاحبنا القديس مدير الثقافة؟ لن يخدعك مع هذا، وإشارته إلى الست وقطعة السُكر لن تثير في نفسك غير الاشمئزاز والضيق، ولقد طويتَ الليالي البعيدة محترقاً لمجرد تصورك إنعام بين ذراعيه. لكن هذا كله نُسي بالفعل قبل سنين وانمحى أي أثرٍ له… فماذا الآن؟ ماذا تريد يا حضرة البروفيسور والخبير الاقتصادي الكبير؟ ثأر قديم؟ طظ! لقد تلقيت من الإهانات الأنيقة والدسائس المعسولة في بلاد النفط ما يتجاوز كل ما فعله بك هذا الشيطان في صباكم الطيّب، فعلى الأقل كان محمود يفعل ما يفعله في العلن، وتحت نور الشمس، وإن كان محمياً من أبيه ورجال أبيه بالطبع، لكنه أشرف ولا شكّ ممن يحمونهم الضباط والجنود والقواعد الأمريكية والأمم المتحدة.
انتبه على صوت محمود يتساءل: “أمم متحدة إيه بس لا مؤاخذة يا زكي بيه؟ هي شعشعت معاك ولا إيه؟“.
ارتبك لأن لسانه فضح أفكاره ولأن الآخر أدرك مقدار سكره رغماً عنه، فآثر التمادي في التحدي: “أرجو متكونوش بتقفلوا بدري، أنا ناوي أسكر طينة زي زمان، ومادمت معايا خلاص“.
“أنا معاك للصبح، وبعد ما نقفل هنا هآخدك لسهرة ولا ألف ليلة وليلة، وفين؟ في عابدين… في شارعنا بتاع زمان… فاكره؟“.
***
حاول بكل طاقته ولم يتذكر إلا نتفاً ممزقة لا تنتظم معاً في سياق. كيف وافقه على الذهاب إلى غرزة في عابدين لتعاطي الحشيش؟ كيف أصيب بهذا الجرح الغائر الذي شوّه وجهه إلى الأبد؟ وكيف اختفت كل أشيائه وثيابه حتى الحذاء؟
حينما يُجهد ذهنه يتذكر صورةً فوتوغرافية قديمة له، يُخرجها أبو شامة من محفظته، ويتذكر أيضاً اسم إنعام، وحلقة من وجوه رجالٍ غريبة في غرفة ضيقة بالطابق الأرضي من بيتٍ قديم، ودخان.
أفاق على الظهيرة في مستشفى عامٍ، وسرعان ما ظهر عادل، الذي اتصل به مجهولٌ في السادسة صباحاً وأبلغه بمكان صاحبه، وجده مرمياً في شارعه القديم ذاته، وحوله أولاد الحلال يسترونه بجلباب. حين فتح عينيه ولمس الضماد الذي يغطي خده، أراد أن يبكي فلم يستطع. وفي رأسه ترددت جملة من أغنية لأم كلثوم بإلحاح، كان يترنم بها هو ومحمود بينما يتعاونان في إغلاق باب البار من الخارج: “وعايزنا نرجع زي زمان، قول الزمان ارجع يا زمان، وهات لي قلب لا داب ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان“.