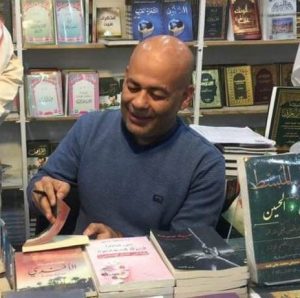لا شيء يحدث لغير ما سبب، ذوبانك فى لحظة تكتشف فيها وجودك بحيّز الظل الذي كان يشغل ذهنك في لحظةٍ سالفة، لأنك تذكرت لتوِّك ما قرأته قبل أيام: “تكمن بدايات ونهايات الظل بين النور والظلام، ربما تضاءل أو ازداد بلا حدود، لكنه الوسيلة الوحيدة التي تعرض هيئة الأجسام ومن دونه لا يمكن فهم تفاصيلها أبدا”، عناق لحظة بأخرى ألقى بذرّاتِهِ غير المرئية على قلبك، اعترضته ورودُ ثوبها الصغيرة الهاربة منه، كيف رأيتَها حرةً وملونةً ومثقوبةً بالضوء على خلفية من الظل الداكن على الأرض؟
“الحاضر كالنهر، حيثُ الماء الذي تلامس هو آخر ما مرّ وأول ما سوف يأتي”..أبصرتُها وتبصّرتُ بما يحدث لي، ليس دقًا قلبيًا عشوائيًا ولا ذلك الممل الذي يقتلك في ليالي الوحدة الطويلة، هو إيقاعٌ سريعٌ لفتح مملكة سماوية، ودفق قطع من الذهب الخالص في جاذبيةٍ قمريةٍ بطيئة بين خلاياك، كونك تتقن الرسم لا يجعل القدر بالضرورة يتحداك بهذا الوجه العجيب، ولا يجبر كذلك كل الكلمات التي حدّثوا بها من قبل عن الجمال على السقوط من أوزانها ثم على السمو في آنٍ واحد، كل ذلك في زمنٍ يعادل مسافة طرفةِ عينها.
كانت تلك المرة الأولى التي أرى فيها أنثى سمراء وشقراء، الفراشة والزهرة معًا، الطير وصائده في بدنٍ واحد، دلفتْ إلى المدرّج الكبير وثوبها المزهر يتبعها متعةً للناظرين، لم أنتبه أنني أسير خلفها إلا عندما طارت خصلةٌ من شعرها الحُرّ إلى وجهي مسحته من أعلى إلى أسفل، فأعاذتني بها منها، وأجّجَت رغبتي في ملاحقتها طوعًا، لا لشيء سوى أن أظلّ في حضرة الظل المصاحب لها.
جلسَت فبدا لي أن هناك شيئًا من الممكن أن يستوعب بهاءها دون أن يذوب أو يتحطم، التفّت صديقاتها حولها، بينما أحاولُ الاستيلاء على كرسي متميز في الصف الخلفيّ يطل على زاويةِ وجهها اليسرى حيثُ يداعبها شعاع الضوء الجانبي، وأستطيع من خلاله استراق السمع لحديثها.. كانت تحكي بحزنٍ تخالطه السخرية عن شحاذٍ أشعث قام من نومته فوق أريكة الانتظار الخشبية الطويلة على محطة الترام ليشاكسها، ظل يتحدث إليها في جدية عن الأحوال السيئة والبشر الأكثر سوءًا.. حَكَت أنها كانت ترتعد خوفًا من حركةٍ مباغتة منه تؤذيها، وفي نفس الوقت تحرّجت من الانصراف بعيدًا فتزداد حمولة حقيبة أوراقه السوداء المهترئة باسمٍ آخر تخلّى عنه، وإن كان اسمًا لا يعرفه..
“آن”.. هكذا يناديها الجميع، قالت لهن في شجاعة أنها قد منحته ابتسامة، وتهللت أساريره حتى أنه لم يلتفت إلى بضعة الجنيهات التي دستها في يده، لم تبذل تلك المخلوقة أدنى جهد كي تستحوذ على قلبي، والذي خشي عليها من الكلمات تخرج من ثغرها بحماسٍ فتؤذيها، وهي تقول: “لا يزال هناك أمل في إسعاد أحدهم”..(ادخري روحك من أجلي يا “آن”)، جملة قاطعة قالها شابٌ مقتحم لثلة الفتيات في جرأة، متوجهًا رأسًا إلى الكرسي المجاور لـ”آن”، ارتدى نظارة شمس سوادء و”تي شيرت” أحمر وسروال من الجينز القذر – هكذا يسمونه – كالح الزّرقة.. وهنا أحسستُ بأنني هذا السروال، يسكبون فوقه كمًا هائلًا من صبغة النيلة الزرقاء ثم يتركونه وحيدًا ليتجمد في الشمس فوق مدبغة خشبية عالية خلف سور مجرى العيون..!
عرفتُه طالبًا يؤدي تحية العلم كل صباح، “أسامة”..أحد الطلاب المتميزين في مدرستي، يصغرني بعام، يشارك في مسابقات نجم المكتبة وأوائل الطلبة وحفظ القرآن وإلقاء الشعر وكرة القدم، يتحدث أساتذته عن نبوغه وعُلقت عليه آمال كبيرة في الوصول إلى أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، هو الآن شاب يافع في عامه الجامعي الأول بكليةِ الصيدلة، حتى الآن لا يمثل كل ما أعرفه عنه أي إنجازٍ بالنسبة إليّ، كونه إلى جوار “آن” هو الإنجاز الوحيد الذي أحسده عليه..!
راقبتُ ابتسامتها في وجهه، أضاء مثل أول ضوء يخرج إلى الدنيا، هذا البريق المترقرق في عينيها العسليتين يطفو فوق نبعٍ صافٍ، وشفتاها الدقيقتان تنفرجان في فرحةٍ غامرة، وشعرها الطويل ينثني وينبسط بين أصابعها وهي تداعبه في زهو، هل “آن” حقيقة؟ أم هي “يوني كورن” المسحورة وقد قفزت من حكايتها هاربةً من الثور الأحمر الناري لتجلس إلى جانب هذا الرجل الأحمر المصبوغ بالنيلة؟
“تعلمتُ منذ زمن ألا أتصارع مع خنزير، لأنني سأتسخ أولًا وسيسعَد الخنزير ثانيًا”.. دار بينهما حديثٌ ضاحك، وضع “أسامة” دفترها فيما بينهما واحتوى يدها الصغيرة في يده أسفل الدفتر.. شعرتُ أن يده تعتصر قلبي والدم يصعد إلى وجهي، كان لا بدَّ من إنهاء هذا العذاب.. كان لزامًا عليّ أن أتوقف قليلًا عن التلصص وأصرخ في وجهها: إني هنا وأحبك.. قاطعتهما: “أسامة؟ كيف حالك؟ “.. نظر إليّ في توجس وبدأ يتفحص وجهي فلم يبدُ عليه أنه يعرفنى، وسألني مباشرةً: من أنت؟، قلتُ: زميلٌ لك في المدرسة يكبرك بعام، وأسهبتُ في شرح سيرته الذاتية المشرفة، رمقتني “آن” في استحسان، تقمصت دور السيدة الأولى التي يسعدها نبوغ زوجها ونجاحه، كنتُ على استعداد إلى قول ما ليس فيه حتى تطيل النظر أكثر في وجهي، سألتُه ما الذي أتى به إلى كلية الإعلام هنا, فنظر إليّ في تحدٍّ: “خطيبتى آن”..
هو كاذب، لا يرتدي أي منهما خاتمًا، ولا يصلح أن تتزوج (يوني كورن) في نهاية القصة من ثور أحمر متنكّر.. ابتلعتُ كذبته واغتنمتُ فرصة مناداتها وتبادل التحايا معها، كانت رقيقة ومهذبة وعذبة، وكنتُ متلعثمًا.. كعادتي..
منذ ذلك اليوم وأنا ظلٌ آخر لها، حفظتُ جدولها عن ظهر قلب، أجلس بالقرب منها، آئتنس بحضورها، أراقبها عن بعد بين رفيقاتها، أتتبعها في طريق عودتها إلى البيت، حتى جاء يوم تشجعتُ فيه على إلقاء التحية بعد هبوطها من الترام، هزت رأسها في خجلٍ وعلى عجلٍ كي تتخلص من الموقف، لم أمهلها واقتربت منها حتى صرتُ بمحاذاتها، طلبتُ منها أن تسمح لي بمرافقتها سيرًا حتى بيتها، شعرتُ بغضبها واندفع الدم إلى وجنتيها فازدادت جمالًا، قالت في ارتباك وهي تعتذر أنها لا تستطيع ذلك، فابتسمتُ وأنا أحاول التصديق على نيتي الحسنة وهي السير بمحاذاتها ولكن على الرصيف الآخر فحسب، لم تشعر بالاطمئنان وبدأت تلملم خيوط الأسبوع السابق من وجهي الذي يطاردها في كل مكان، أخفت اضطرابها ومضت في طريقها وأنا على الجهة المقابلة أتأمل خطوتها في تنورتها الرمادية الضيقة والتي تغطى ساقيها حتى ما قبل كعبيها بمسافةٍ صغيرة وذلك الشق في الخلف مرتفعًا إلى ما بين ركبتيها كاشفًا حد الجورب الشفاف ملفوفًا لا حول له ولا قوة حولَ قالبين من الشمع الأبيض، تمشي مسرعةً غاضبةً يطير شعرها خلفها بينما يتعلق اسمها بلسانك المتلعثم مع كل خطوةٍ تخطوها، كالذِّكر: آن..آن..آن..
“من السهل أن تقاوم في البداية على أن تقاوم في النهاية”.. بعد أسبوع أدمنتَ فيه رؤيتها وسماع صوتها، ومراقبة تنقلها كالطير من مكان إلى مكان، من الصعب أن يصيبك حرمانٌ مفاجئ منها قرابة أسبوع آخر، كان الأمر أشبه بموتٍ سريريّ للقلب بين الجوانح، والتي راحت تظهر لك في كل مرآة كشواهدَ قبور متراصة تحت جلدتك.. عندما وطأت قدمي المدرجَ باحثًا عنها ولم أجدها تذكرتُ آخر دمعةٍ ذرفها جسده المصلوب في فيلم “آلام المسيح” وكيف تحول العالم فجأة إلى صحراء مجدبة منزوعة الحياة..
لم تكن بطولة الجمهورية في “العدْو” هي ما جعلتها تتغيّب فحسب، لأنها بدت مهزومة ولو عادت فائزةً بالكأس، كانت تلك معلومة جديدة تمامًا عن “آن”، عدّاءة.. ممَ تهربين يا آن؟ أو إلامَ تذهبين؟ ولكنني أرى تقلّب قلبك جيدًا في عينيك وفي حركتك المتثاقلة غير المعتادة وفي شرودك وفي غياب الثور الأحمر عنكِ، شيء ما لا أراه يمتص حيويتك ..!
في المكتبة، أبصرتُها تجلس بصحبة كتاب، يطوق رقبتها الرخامية سوارٌ مجدول بثلاثة ألوان ذهبية ونحاسية وفضية، ترتدي قرطًا مثل دمعة العين يُرى كنجمة بعيدة مثبتةً في قطعة العجين الشهية الطرية، يبرق بياضها من تحت سترةٍ سوادء عارية الصدر تضمها سترة أخرى تكسو ذراعيها، تحدّق في ذلك النور الذي لا تدري من أين يأتي.. تحاول ألا تنظر فتفشل، تقتحم وحدتها ولا تعطيها فرصة للترحيب أو الرفض، تحاول أن تقول لها طيلة الوقت بعينيك الزائغتين: “لو تعلمين بما أجن من الهوى…لعذرتِ أو لظلمتِ إن لم تعذري”..
“أنا أحبك يا آن”، قلتُها دون لعثمة، قالت إنها سئمت من الحب ولم تعد تثق في أحد، وما زالت تعاني من تجربة أسامة، قلت أنا لا أريد شيئًا، قالت هو ظلمٌ لك، قلتُ أرضى، قالت ليس لك عندي سوى الصداقة، قلتُ دامعًا: أقبَل.. “ليس هو الفنان من يرى الأشياء كما تبدو في الحقيقة، لو فعل فالأولى به أن يتوقف عن الرسم”..على بوابة المكتبة، تبادلنا أرقام الهواتف، كنتُ مأخوذًا بموافقتها دون الالتفات إلى ملامحها العابسة، كالمرغمة على تواصل لا تريده، وعندما غادرتني بعد مصافحةٍ قصيرة جدًا شددتُ فيها على يدها ولم تُظهر فيها أدنى ترحيب، تجاهلتُ شعوري بالإهانة والتمستُ لها العذر ثم برزت تلك الصورة المثيرة أمامي: لما لا أبتر ساقَي حبيبها الوغد وأستخدمهما كساقين إضافيتين مثل مهرج السيرك العملاق على أن تكون “آن” كل جمهوري؟!
“الفنان هو ذلك الشخص الذي يصنع أشياء ليس البشر في حاجةٍ إلى امتلاكها..”.. بعد مرور عام، صارت “آن” أكثر حيوية، وبدأت تتقبل التصاقي بها، صارعتُ حزنها وذكرياتها العالقة من أجل أن تبتسم لي فقط، لا بل كي تسترجع ابتسامتها من جديد، لم أجد حرجًا في تقديم لوحة تحمل رسمًا لها أمام الجميع في عيد الحب، ثمّ قضيتُ يومًا بين سيولٍ ووحول قبل عيد ميلادها وأنا أبحث عن قطع الورد المجفف لأزهارٍ نادرة لدى خواجة يوناني في وسط البلد، ونثرتُها حول خاتمٍ من الفضة في صندوق صغير صنعتُه خصيصًا لها يحمل رسومًا مطبوعة من صورٍ عديدة لـ”آن”، مع صندوقٍ آخر يضم دودة قز نائمة فوق ورق التوت، كانت مفاجأة كبيرة لها ولن أنسى ما قالت لي في هذا اليوم ما حييت:
“كنتُ من هواة تربية دود القز.. ما زلتُ أتذكر الرجل الذي كان يبيعُنا إياها أمام باب المدرسة واصطفافنا لشرائها، نتسابق في اختيار الجيد من العلب الورقية ونتأكد أنها محكمة الغلق من أسفل ومن وجود ثقوب من أعلى تسمح لها بالتنفس، نتلمّس ورق التوت الأخضر النَّضِر منه والذابل.. وترقد الدودة الرخوة في بيتٍ ورقى غير آمن، بقطيفتها المخملية التي تصيبني بالقشعريرة، من أناملي حتى خصلات شعري، أحملها بين يديّ كأنما أحمل كنزًا..أحمل حياةً.. لا أدري كيف سيؤول هذا الكائن الدقيق في أسابيع قليلة إلى فراشة جميلة تحلق حولي.. لكنها تبدو في طورها الأرضي جميلةً أيضًا.. يعجبني سعيها وكثرة أقدامها وحرصي عليها من التأذّي.. يعجبني أنها معي وأن أراها تلتهم طعام التوت، يعجبني صمتها ورضاها بالبيت غير الآمن واستسلامها لطفلة صغيرة مثلي تربيها.. لم تشكُ من برودة ما حولها ولم تتذمر من الطعام الواحد ولم تبالِ بعراكنا وأصواتنا العالية التي تزلزل جدرانها الورقية..
أتدري، لا أذكر تحديدًا شكل يرقتي الأولى وهي تحيط نفسها بشرنقتها.. تلك القيود الحريرية.. بأي لون كانت؟ لم أفكر وقتها ما الحكمة من ذلك.. ولم أستغرق كثيرًا لأُشبِع النظر من ذلك الكائن العجيب الذي يتحول تدريجيا من زاحف إلى طائر، وفى كيفية تحوّل القضبان إلى أجنحة!”.
تابعتُ كلماتها في ذهول من رقتها وحكمتها ثم قلت: “عندما تصير قضبان اليرقة أرديةً للملوك، وتصير قضبان العنكبوت شبكة صيد لا بدَّ وأن نتوقف طويلًا أمام تلك الحكمة.. السر في النسّاج وليس النسيج..”..
“القاعدة الذهبية هي أنه لا يوجد قواعد ذهبية”، في العام التالي، وفي اليوم الدراسي الأول، بدأتُ أنهل السحر من “آن”، هاتفتُها عندما تأخرَت عن الحضور إلى الكلية، قالت إنها لن تأتي اليوم، شعرتُ بخيبة أمل وأنا بين غياضٍ من الأحزان التي هبطت كلها دفعةً واحدة..
بعد عدة خطوات وجدتُها تداهمني من خلفي، عادت “آن” طفلةً، لم ألح كعادتي كي أقتنص منها كلمةً بُحتُ بها آلاف المرات، ويالعجبي! قالتها “آن” دون طلبٍ منى، قالت “أحبك وأفتقدك”، لي أنا وحدي، هكذا وببساطة، كدتُ أذوب أمام ناظريها، لكنى لم أشعر بالخوف أبدا مثلما شعرتُ به في تلك اللحظة، هل تحبني “آن” فعلًا؟ هل يتحوّل نفورها مني منذ يومنا الأول إلى حب؟ بدأت أسترجع هواجسي القديمة: وإن كنتَ مدرِكًا هكذا لصدودها المبكّر عنك، لماذا كرستَ روحك من أجلها إذن؟،هل كان لخبر خطوبة “أسامة” تأثيرًا عليها؟ هل كان لا بدَّ أن تظل “آن” بعيدة وحَرون ومستحيلة؟ شكوك تساورُني لا أستطيع أن أخلُص منها، أكتشف أنني على بعد خطوةٍ من تحقيق أحلامي.. ولكنني غير واثق الآن من أنها بالفعل أحلامي!
هو الخوف حقًا؟! أريد شيئًا واحدًا الآن: تسقيني أمي جرعةً من الماء البارد لتطرد الخوف من كابوسي المزعج في جوف الليل فأغمض عينيّ وأعود لنومى فأهزم الثور الأحمر الناري..، الثور وحيد القرن مثل “يوني كورن” وله رأس مألوف جدًا.. رأس “آن”..!!