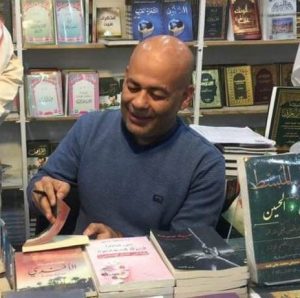حسني حسن
لمَا غادر بيت أمه العجوز، الواقع عند سفح الجبل العالي، كان يحدس، وبطريقةٍ ما، أنه رحيل بلا رجوع، وسفر بلا عودة. راح يفكر في توسلات الأم، الصامتة، وتضرعات عينيها، المخضلتين بنداوة الدمع المحبوس، إليه كي يبقى، دون أن تهتز إرادته، أو تهن عزيمته. كان مترعاً بالشباب وبالتوق إلى السفر، والأهم من ذلك، كان قد غرق، حتى أذنيه، في لجة بحار الإيمان وطلبه، وهل تقدر عبرات الأم، أو تنهيداتها، على مقارعة الإيمان، وشغف الذهاب باتجاه البعيد، داخل قلبٍ شاب؟
همس لها، عارفاً أنه يكذب، مواسياً:
– سنة واحدة، على أكثر تقدير، أبلغ فيها منبع نهر الفردوس الخفي، وأرجع يا أمي، لنعيش عمرنا كله معاً.
ومثلما كان يعرف هو أنه يكذب، كانت موقنة هي بأنه لا يصدق، ربما ليس لأنه كاذب، فهل تقدر أمٌ على إجازة نعت وليدها الحبيب بالكذب؟، بل لأنه واهم. وهكذا آمنت أمه بضياع ابنها، كملايين الملايين غيره، على طريق مغوٍ، لا عود منه، يظنون أنه يأخذهم باتجاه المحجوب الخالد، بينما هو لا يقودهم، في حقيقة الأمر، سوى للغياب ، ولملاقاة حتفهم، الذي سيلاقونه يوماً ما على أية حال، قبل أن يعيشوا كفايتهم من العيش، وقبل أن يتجهزوا جيداً للقائه.
– أنت لن تفهم يا أناندا، لن تفهم أبداً طبيعة قلب الأم، ولا تريد أن تعرف أنه ما عاد للعمر عمرٌ كي نعيشه معاً، كما تقول، كنتُ قد حفظت لك حقلك، استنقذته من البوار الذي راح يتهدده عقب موت أبيك، رويته بالعرق، وبماء جلبته، على كتفي، من نهرنا هذا القريب الصغير، دائم الجريان، غرست فيه شتلات الأرز، ورممت الدار، فرشتها بالأبسطة والأرائك المريحة، وأسرجت بها القناديل الزيتية لتبعد عن عينيك، الجميلتين، أشباح الظلام وعتمات الليل، وفي ركنها، الهادئ العميق، جهزت لك أوراق اللوتس والبرديات، الرقيقة الناعمة، وأقلام البوص المسنونة، والمحابر التي لا ينضب مدادها، ثم تمثال بوذا، الذي تحبه، مُسبل الجفنين، الرائي للحقيقة أسفل شجرة التين المباركة.
أخذ ينصت لحديث أمه بقليلٍ من الصبر، وقد بانت على قسمات وجهه النبيل أمارات الكدر. لكنه، وبرغم برمه وتطلعه لإنهاء الحوار كي ينطلق في طريقه، آثر ألا يجرحها مزيداً. اغتصب ابتسامة مفبركة، وانحنى ليقبل هامتها، وقال:
– لا، لم ينقضِ العمر بعد أيتها العجوز، ولا تزال لديك مهمة كبيرة عليك إنجازها خلال غيبتي، التي لن تطول؛ أن تجدي لي عروساً، جميلة وطيبة مثلك، دعينا نتفق على ذلك.
لم تشأ الأم إطالة عمر لحظة تدرك أنها محكوم عليها بالتلاشي والاندثار، مهما امتدت. ضمت رجلها الشاب إلى حضنها، لآخر مرة، وظلت تعِبُ من روائح جسده وأنفاسه. همست محاذرة أن تلتقي عيناها بعينيه:
– لن أُهمل تخبئة مفاتيح الدار، في مكانها المعهود، أسفل التينة الحارسة، فمن يعلم؟
سنوات طويلة وكثيرة قضاها أناندا، هائماً على وجهه، بالطريق. سنواتٌ بات لا يعرف لها عداً، ولا يتذكر، أصلاً، أن يجهد عقله بمحاولة إحصائها، ثلاثون سنة، ربما، أو ثلاثمائة، أو ثلاثة آلاف، أمضاها مستقصياً ومتتبعاً مجرى نهر الفردوس بأمل بلوغ منابعه الخفية. سأل النوتية الخائضين، بقواربهم العتيقة، غمار النهر، بلطفه وانسيابيته، بدواماته المخيفة، وبشلالاته المزمجرة الهادرة من أعالي الجبال الشاهقة. سأل الفلاحين في حقولهم المشتولة بالأرز المغمور بالماء والطين الموهوبين منه. سأل التجار، العاكفين باستمرار على دفاترهم يحصون فيها الأرباح والخسائر، المهمومين دوماً، بنقل بضائعهم ومتاجرهم، عبر ضفتيه، وعلى طول مجراه الذي يبدو بلا آخر. سأل الجنود والحراس، شاكي الشلاح، المتدرعين بلباس الغزو، الملتاثين بأحلام الضم والإلحاق، والمنخدعين بسراب القوة التي تنسرب، من بين أصابعهم، كما ينسرب ماؤه، من دون أن يخلف بقبضاتهم سوى ذكريات رطوبة عابرة. سأل الصبايا الصغيرات، الباسمات للأيام القادمات، لأحلام الحب والزواج والعيش القرير الهانئ، كما سأل بائعات الهوى، ربات اللذة الرخيصة العاوية في دماء البشرية كقطيع ذئاب ليلي تائه، منذ الأزل. وسأل السامانات في غاباتهم العذراء، التي يُشاع أنها تُروى، مباشرة، لا من النهر العظيم، وإنما من منابعه السرية المقدسة ذاتها.
وهكذا، عرف أناند،ا أخيراً، أنه ليس ثمة من لم يسأله عن الطريق الواصل إلى النبع، اللهم إلا البوذا نفسه، لكن أين هو البوذا ليسأله؟…
– تحسبه في السماء، أليس كذلك؟
– ماذا؟
– النبع المقدس؛ أشاعوا أنه يتحدر نزولاً من السماء.
– على الأرجح. بلى، أستطيع أن أقرر أن هذا ما يعتقده غالبية الناس، على الأقل.
انفجر الصوت العميق بضحكة ساخرة، غاضبة ومزلزلة، ثم تساءل:
– غالبية الناس؟ وما الذي يعرفه غالبية الناس عن هذا الأمر، أو عن غيره؟
– ربما يعرفون، ربما علمتهم الحياة.
– وأنت! ماذا علمتك الحياة؟
صمت لبضع ثوانٍ يفكر في إجابة السؤال، قبل أن يجد نفسه وقد رغب بالنكوص عمَا صرح به لفوره. اعترف بحيرة:
– ربما لم تعلمني ما هو أبعد من الشك في كل ما لقنتني إياه من تعاليم، أو من الإيمان بأني لست أعلم إلا أني لست أعلم.
ابتسم له الصوت، هذه المرة، برضا وتفهم، ثم أكد بحزمٍ رهيف:
– هذا ليس بالقليل يا أناندا، ليس بالقليل أبداً، أمَا أولئك الآخرون، كلهم، فدعك منهم، إن تسعة حمير لا يقدرون على اختيار الإجابات الصحيحة عن السؤال، في مقابل رجل واحد.
أحس أناندا بوخزة في قلبه، كما لو أن خنجراً، مدبباً مسموماً، قد اخترق قفصه الصدري، مباشرةٍ، وصولاً إلى قلبٍ طالما توله وتغنى بالناس؛ بكل أولئك الآخرين، متوهماً أنهم صورة الإله، أطفاله المُختارين فوق هذه الأرض. غامر بطرح استفهامه الأخير:
– فهل تدلني أنت، يا معلم، على الطريق إلى المنابع المقدسة؟
تثاءب الصوت بمللٍ، وأغرق في الصمت قبل أن يرد بحنوٍ، هذه المرة:
– وما يدريني أنا بطريقك يا أناندا؟ هل تعرف؟ ربما كان عليك أن تعود أدراجك، بطول النهر العظيم، راجعاً إلى الدار.
وما إن انتهى الصوت من كلامه، حتى أسدل جفنيه الثقيلين فوق عينيه الجاحظتين من سهر القرون، وراح يغط في نومٍ كثيف، هادئ الأنفاس.
بغتة، ولدهشته البالغة، توامضت، بمخيلته المشِعة، صورة التينة، الحارسة العجوز، على عتبة دارهم البعيدة، ومفاتيح الدار، التي دفنتها أمه، أسفل جذورها الباقية القوية. همس لقلبه بمرارة وتسليم وارتياح:
– طريقك المحجوب إلى المنابع المحجوبة.