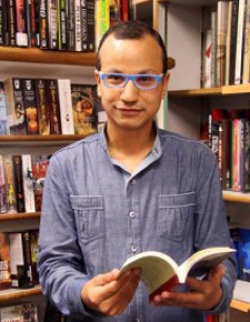و بعد كل ما كتب عن نجيب محفوظ و عن ثلاثيته، لم يعد من السهل معاودة الحديث عنهما دون تكرار ما قيل أو على الأقل دون اشتباك مع كل أو بعض كل تلك الكتابات التي نحى كثير منها منحى أكاديميا، بحيث أغلق على نفسه الباب ليقبع في دهاليز النظريات الأدبية و المناهج البحثية التي تتعامل مع كل نص أدبي بوصفه جثة مسجاة على طاولة التشريح، و ليس بوصفه جسدا حيا، ينمو و يتطور و يتخذ مساره الخاص مع كل تغير يطرأ على المجتمع.
و نظرا لانتماء الثلاثية للاتجاه الواقعي، بحرصه على التصوير الأمين لجوانب الحياة بزخمها و أبعادها، ما استطاع الرواية إلى ذلك سبيلا، في حدودها كوسيط فني. فمن الطبيعي أن يتعامل معها الكثيرون باعتبارها وثيقة تاريخية، تقف شاهدة على مرحلة بعينها من تاريخ مصر. و لعلها كذلك، إذا ما صرفنا النظر عما يميز الرواية، كتجربة فنية تهدف إلى استجلاء الظاهرة الإنسانية العجيبة، و علاقتها بالزمن و المكان.
كمال عبد الجواد نموذج المثقف المنعزل عن الواقع
استطاعت الثلاثية أن تنحت نماذجها الإنسانية التي تم تكريسها، بمرور الوقت لتصبح إشارة على نمط بعينه من الشخصيات، سواء الواقعية أو الدرامية، فهناك نموذج سي السيد و نموذج الست أمينة. و لم تكتسب هذه النماذج قوة سطوتها و حضورها الطاغي إلا لأنها استطاعت أن تحيط بظاهرة إنسانية محددة بسياقها الخاص بالطبع ولكنها أيضاً عابرة له بقدرتها على التنكر والتحوّل واكتساب أشكال جديدة.
لعلّ كمال عبد الجواد أحد تلك النماذج الإنسانية التي تمكن نجيب محفوظ من الكشف عنها، وتحليلها، واستيعاب تناقضاتها. كما أنه من أهم شخصيات الثلاثية، حيث كان الصبي الشاهد على الأحداث منذ صفحاتها الأولى، و حيث يتطوّر وعيه بالعالم و تتبلور مواقفه المختلفة، مع المضي قدما في حكاية الأسرة بتفرعاتها.
ولكن ما الذي يميز كمال عبد الجواد و يمنحه ثقله الخاص كنموذج للمثقف الحالم المثالي؟ رغم تكرر هذا النمط نفسه، بتنويعات بلا حصر طبعا، في روايات سابقة على الثلاثية ولاحقة لها عند نجيب محفوظ نفسه، ثم نزوع هذا النمط للوجود والتكرر وإعادة إنتاج ذاته، بين صفحات كثير من كتاب القصة والرواية، فيما تلا جيل نجيب محفوظ، و خاصة عند جيل الستينات. على سبيل المثال في قصص و روايات بهاء طاهر و إدوار الخراط و إبراهيم أصلان و صنع الله إبراهيم، كلٌ على طريقته الخاصة.
هذا الحضور الذي لم يتوقف تياره حتى هذه اللحظة، في مُنتَج الأجيال الأحدث من الروائيين، و لو من زوايا جديدة و بأساليب أخرى، و قد غُلفت بمذاقات جديدة، لم تمنع المحتوى القديم نفسه من فرض نفسه عليهم. لا عجب في ذلك إذا وضعنا في الاعتبار قدرة هذا النمط الروائي على استيعاب هموم وهواجس الروائي نفسه، و حيراته الوجودية و أسئلته المعضلة، وربما كذلك عزلته عمّا يُسمى بالواقع، والعزلة هي السمة الأهم في الصورة الأقدم للنمط؛ كمال عبد الجواد.
من العسير أن نجد عملاً أدبياً، تالياً على الثلاثية، له بعض قدرتها على تعرية هذا النموذج حتى العظام كما كان مع كمال عبد الجواد. فغالباً ما نراه، في تلك الأعمال التالية، منجزاً وكاملاً وكأنه وُلد من الفراغ، وربما مع إشارات سريعة إلى البيئة التي تشكّل فيها وعيه وتكونت فيها قناعاته، ولكن دون تتبع صبور لدرجات تطور هذا الوعي خطوة بعد أخرى، أو دون أن تقصى لجوانب العزلة وسبر أعماقها. من هنا تنبع الأهمية التأسيسية في شخصية كمال عبد الجواد، و لذلك يحق لنا الإشارة إليه باعتباره نموذجاً درامياً أصيلاً، نتجت عنه صورٌ عديدة، ما كان لها أن تُرسم و أن يتم استيعابها أو تلقيها فنياً، لولا الأصل الذي ترسّخ في وجداننا، حتى و لو لم نرجع إليه و نتذكره عن وعي وقصد، لدى كل تفاعل مع صورة جديدة من صوره المتناسخة والمتواترة.
رحلة البحث عن ملاذٍ آمن
يظهر كمال، في بين القصرين، ظهورا هامشيا و لكنه له ثقله و دلالته مع هذا. إنه الصبي المتصّف بالذكاء و النبوغ و سعة الخيال، إلى جانب غرابة منظره، كبر الرأس و النحافة و ضخامة الأنف، يفتقد الشجاعة اللازمة لارتكاب حماقات هذه السن، و يخشى دوما من تلقي عقاب أبيه. ينطوي على مشاعر دينية عميقة، متوارثة عن الأسرة عموما، و تقويها علاقته الوثيقة بأمه، حيث يجلس معها يوميا لتدارس ما تلقاه بالمدرسة من جديد في الدين، حيث يعمل جاهدا على إبهارها و الطعن في معارفها الدينية، و الممتلئة بحكايات الجن و العفاريت. كمال الصبي، الذي ” لم تكن الرغبة في العراك تنقصه لكنه كظمها تقديرا للعواقب” و الذي كان يحتال بالكذب و اختلاق الحكايات المؤثرة ليفوز بانتباه أفراد أسرته في مجلس القهوة كل أصيل. و الذي يطمح للتوظف بالشهادة الإبتدائية، مثل أخيه ياسين، و ليس إلى الالتحاق بمدرسة الحقوق مثل فهمي، لكي يظفر بحقوق الرجل في السهر بالخارج.
يسأل كمال أمه، خلال جلسة درس الدين الخاصة بهما: “أيخاف أبي الله؟ ” و كأنه وقد وقع في أسر طغيان أبيه، ربما أكثر من أي فرد آخر في الأسرة، يحاول البحث عن متنفس من هذه السطوة في عالم الغيب، البحث عن سلطة أخرى، أكثر رحابة و حنوا، سلطة يرمز إليها ضريح الحسين الذي ورث حبه عن أمه. و قد كان كمال شريك أمه في رحلتها إلى الحسين الحبيب، الرحلة المختلسة من بين أنياب السلطة الاجتماعية للأب الطاغية، و قد جرت عليها و على البيت كله ألوانا أليمة من العقاب.
يظل كمال، على مدار الكتاب الأول و المؤسس للثلاثية، يتنقل بين عالم الكبار، حاملا الرسائل و هامسا بالأسرار و النميمة، متلهفا على تلقي الانتباه الجدير به، و الذي ضحى في سبيله بكل شيء، حتى حماسته الوطنية الفطرية التي تشربها عن أخيه الكبير فهمي، حين صادق عددا من العساكر الإنجليز المرابطين أمام البيت، و راح يتقبل هداياهم، و يغني لهم ” يا عزيز عيني”، و قد وجد فيهم ملامح أقرب إلى حسن الملائكة بعد أن ظل يتخيلهم كالشياطين.
السعي نحو التفوق و العظمة
مع الصفحات الأولى للكتاب الثاني، قصر الشوق، حيث يكون لكمال نصيبا عظيما من السرد، و حيث يستوي شابا نال البكالوريا و يستعد للتعليم العالي، نتعرف على المرحلة التالية التي ترسخ عزلة كمال و تعاليه عن الواقع المحيط. و نتابع جداله المضني مع والده، من أجل إقناعه برغبته في الإلتحاق بمدرسة المعلمين، المجانية و التي لا يدخلها إلا أبناء الفقراء في رأي أبيه، و لكنها تمثل لكمال السبيل الطبيعي لكي يواصل إطلاعه بدون حدود.
” أجل إنه لا يشك لحظة في صدق رأيه و جلاله، و لكن هل يدري ماذا يريد؟ ليست مهنة المعلم بالتي تجذبه، إنه يحلم أن يؤلف كتابا، هذه هي الحقيقة، أي كتاب؟، لن يكون شعرا، إذا كانت كراسة أسراره تحوي شعرا، فمرجع ذلك إلى أن عايدة تحيل النثر شعرا لا إلى شاعرية أصيلة فيه، فالكتاب سيكون نثرا، و سيكون مجلدا ضخما في حجم القرآن الكريم و شكله، و ستحدق بصفحاته هوامش الشرح و التفسير كذلك، و لكن عم يكتب؟ز ألم يحو القرآن كل شيء؟ لا ينبغي أن ييأس، ليجدن موضوعه يوما ما، حسبه الآن أنه عرف حجم الكتاب و شكله و هوامشه، أليس كتاب يهز الأرض خيرا من وظيفة و إن هزت الأرض؟! كل المتعلمين يعرفون سقراط، و لكن من منهم يعرف القضاة الذين حاكموه؟! “
يدرك كمال عبد الجواد في دخيلته نقاط ضعفه و مواطن قوته، و مثل كل منا لا يجد توازنه إلا في الاعتماد على مواطن القوة و المبالغة فيها بحيث تمحو كل أثر لنقاط الضعف، فتبدو و كأنها غير موجودة أصلا. و في شبابه المبكر يطمح لكتابة كتاب جامع مانع، بل و يشبه القرآن الكريم شكلا على الأقل. وكأن الاكتفاء بما هو أقل من العظمة المطلقة و الخلود الحقيقي لا يرضي من لا يجد له موضعا مشبعا في الحياة كما يحياها الناس، لضعف أصيل في ثقته بنفسه و بالعالم. و لكن هل من المحتوم أن يبلغ هذا الطموح إلى مبتغاه إذا ما ساندته إرادة قوية؟
كما نطلع أيضا في مستهل قصر الشوق على اكتشافه المحزن لخواء ضريح الحسين، الذي لم يستطع أبدا التعامل معه بالعقل، كما فعل صديقه فؤاء، ابن الحمزاوي مساعد السيد أحمد في دكان تجارته. بل و نقم كمال على برود العقل، و لم يتقبل أن يكون ضريح الحسين مجرد رمز، و لا شيء غير ذلك.
و مما يتوافق مع هذا التوجه المثالي، موقف كمال الشاب من الغرائز، عندما يثير فؤاد سيرة قمر و نرجس، البنتين اللتين اكتشف كمال و فؤاد معهما الجنس الآخر مع مطلع المراهقة، فحين يقول له فؤاد: ” إنك تحمل نفسك ما لا يحتمل؟ يجيب كمال: إني كذلك و ما ينبغي لي أن أكون غير ذلك…” ثم يضيف بعد قليل: ” إني أرى الشهوة غريزة حقيرة، و أمقت فكرة الاستسلام لها، لعلها لم تخلق فينا إلا كي تلهمنا الشعور بالمقاومة و التسامي حتى تعلو عن جدارة إلى مرتبة الإنسانية الحقة، إما أن أكون إنسانا و إما أن أكون حيوانا…”
الحب قدس الأقداس
في العباسية تحول ضريح الحسين إلى سراي آل شداد، حيث تقيم المعبودة عايدة، شقيقة زميله و صديقه حسين شداد، الذي يقاسمه الولع بالمعرفة الإنسانية، و إن خالفه في الانتماء الطبقي و الميول السياسية. ” ليس من الهين على قلبه الخفاق أن يمشي في هذا المحراب الكبير، و لا أن يطأ أديما وطئته قدماها من قبل، إنه يكاد من غجلال أن يتوقف، أو يمد يده إلى جدار البيت تبركا، كما كان يمدها إلى ضريح الحسين من قبل أن يعلم أنه لم يكن إلا رمزا. ”
غير أن حبه لعايدة سرعان ما يتحول هو الآخر إلى ضريح آخر، بعد أن يمضي أربعة أعوام هائما في عالم فردوسي من صنعه الخاص، و بعد أن يتم التلاعب بمشاعره طويلا يكتشف أنه كان طرفة يتندر بها أهل السراي، عندما تحكي لهن عايدة عن العاشق الولهان، ثم تعلن خطبة عايدة بخصمه، ابن المستشار، و تزف إليه. في الوقت نفسه تقريبا يتخلى كمال عن مظلة الدين، و إن بقى له إيمانه بالله كما بقى إيمانه بعايدة و بالحب، في عالم مثالي مجرد. لكنه كان يستعين بالدين و عايدة في مواجهة الغريزة، و الآن و قد ذهبا بدأ يخطو خطواته الأولى نحو اكتشاف عالم الخمر و النساء.
مع سقوط عايدة المعبودة افتتح كمال تاريخا طويلا مع البغاء، و أكمل من حيث لا يدري التاريخ الأسري غير المشرف، سائرا على خطى أبيه و أخيه ياسين، و إن كان يختلف عنهما في الحوافز، ففي حالتهما كانت الغريزة هي القائد، بدرجات مختلفة من الشغف بالجمال و سعة الإنفاق، أما دافع كمال بالأساس فهي الحيرة، و يأسه من الحب.
” الحقيقة نور لألاء، فغض الطرف، وراء ستار القداسة الذي سجدت أمامه طيلة حياتك يعبثان كالأطفال ( يقصد عايدة و حسن سليم ) ، ما لكل شيء سيدو خاويا! الأم.. الأب.. عايدة، كذلك ضريح الحسين.. مهنة التجارة.. أرستقراطية شداد بك، يالشدة الألم. ”
النتيجة التي توصل لها كمال عند تحطم أوثانه، هي فقدان الإيمان بنفسه أيضا، و كأنه وجوده الهش معلق بوجودها و دورانه في فلكها و كأنه يسقط مع سقوط تلك الأوثان، حتى العلم أو الفلسفة لم يمثلا لكمال دعما كافيا يحول بينه و بين السقوط.
العزلة تحكم حلقاتها
“قد يلوذ من الوحشة بوحدة الوجود عند سبينوزا، أو يتعزى عن هوان شأنه بالمشاركة في الانتصار على الرغبة مع شوبنهور، أو يهون من إحساسه بتعاسة عائشة بجرعة من فلسفة ليبنتز في تفسير الشر، أو يروي قلبه المتعطش إلى الحب من شاعرية برجسون…”
هكذا نرى كمال في مطلع كهولته، مع بداية السكرية، حيث صار معلما محترما و محبوبا، رغم هجمات السخرية على منظره الغريب من التلاميذ، يقف شاهدا على شيخوخة أسرته و جفاف حياة البيت القديم. هكذا يتهكم الراوي تهكما مريرا، على هذا الذي يشبه الناس و لكنه ينأى عن الناس، ليسجن نفسه سجنا اختياريا بين كتبه و أفكاره، ليستبدل بالحياة و بحرارتها و كفاحها الحي سطورا تكاد توحي بامتلاكه الحقيقة، و سرعان ما تتبدى سرابا لا يمكن القبض عليه.
عندما كان يحاول كمال أن يعبر عن نطاق طموحه المعرفي، لم يجد خيرا من كلمة الفكر لتضم كل ما يكان يتوق للغوص في أعماقه، و من الطريف أن يكون هذا هو اسم المجلة الشهرية التي بدأ، فيما بعد نشر مقالاته الفلسفية فيها بانتظام.
“واجهته مشكلة أخرى تتعلق بمقالاته الشهرية في مجلة ” الفكر”، و كان يخاف هذه المرة الناظر و المدرسين أن يسألوه عما يعرض فيها من فلسفات قديمة و حديثة تنقد أحيانا العقائد و الأخلاق بما لا يتفق و مسئولية ” المدرس” و لكن من حسن الحظ أن أحدا من المسئولين لم يكن بين قراء ” الفكر”، ثم تبين له بعد ذلك أن المجلة لا تطبع أكثر من ألف نسخة يصدر نصفها إلى البلاد العربية، فشجعه ذلك على الكتابة إليها و هو آمن على نفسه و وظيفته. ”
تتضح هنا عزلة كمال الاختيارية في أكثر من مفارقة، فهو راض عن النطاق الضيق لتوزيع المجلة التي يكتب بها، مادام هذا سيجعله بمنأى عن تساؤلات و استجوابات الزملاء و المسئولين. فكمال ليس على استعداد لمناطحة السلطة، و عمله كمدرس لا يعني أن يدافع عن أي من الأفكار التي يكتب عنها، و ينقلها للآخرين، من تلاميذ أو غيرهم، ناهيك عن أنه لم يكن إلا ناقلا لأفكار الأخرين و فلسفاتهم، و عدم اقتناعه العقائدي بأي منها بما يكفي للدفاع عنها و التضحية في سبيلها بكيانه كله.
بين مسئولية الإيمان و حرية الريبة
و إذا كان نجيب محفوظ يوجه سهام النقد القاسي و السخرية المضمرة المريرة إلى شخصيته، فلا يرجع ذلك إلا للحسرة على الإمكانيات المعطلة لهذا النموذج ممثلا في كمال عبد الجواد، تلك الإمكانيات نفسها التي لم يكن صاحبها غافلا عنها، و لا غافلا عن تعاطفه مع الجماعة بروحها الخاصة و قوتها التي لا تحد.
لذلك لم يكن عجيبا أن يهتف “الوفد عقيدة الأمة” غداة ليل قضاه في تأمل عبث الوجود و قبض الريح، و العقل يحرم صاحبه نعمة الراحة، فهو يعشق الحقيقة و يهوى النزاهة و يتطلع إلى التسامح و يرتطم بالشك و يشقى في نزاعه الدائم مع الغرائز و الانفعالات، فلابد من ساعة يأوى فيها المتعب إلى حضن الجماعة ليجدد دماءه و يستمد حرارة و شبابا. في المكتبة أصدقاء قليلون ممتازون مثل دارون و برجسون و راسل. في هذا السرادق آلاف من الأصدقاء، يبدون بلا عقول، و لكن في مجتمعهم شرف الغرائز الواعية، و ليسوا في النهاية أقل من الأول خلقا للحوادث و صنعا للتاريخ. في هذه الحياة السياسية يحب و يكره و يرضى و يغضب ويبدو كل شيء و لا قيمة له. و كلما واجه هذا التناقض في حياته زعزعه القلق. و لكن ليس ثمة موضع في حياته يخلو من تناقض و بالتالي من قلق. ”
من النادر أن نجد مريضا على وعي حاد بطبيعة مرضه يفوق ما لدى الأطباء و العلماء. نموذجنا المثقف الحالم، كمال عبد الجواد، لم يكن يعوزه الوعي، و لم يكن جاهلا بدائه و أصله و سببه. لكن القلق الوجودي الذي لا يبدو له أول من آخر كان هو السور الذي يحميه، و يعزله عن تلك الحشود حتى و هو وسطها، و هو مرض يتفاقم مع كل لحظة تمر بالعليل، و مع كل لحظة يصير أهون الأفعال سؤالا كبيرا، يولد بدوره علامات استفهام بلا نهاية، فتختفي المسئولية و يكتفي العليل بما هو ضروري و حسب، الحد الأدنى من التفاعل الإنساني و الاجتماعي ليرجع ملهوفا إلى قوقعته، حيث يجد الأمان في كنف الكتب و الأفكار. دون أن يكون بمقدوره حتى أن ينتج في هذا ما يمكن اعتباره فعلا إيجابيا من نوع ما، فحين يواجهه رياض قلدس، صديقه القاص، في لقائهما الأول بمجلة الفكر، قائلا :” حاولت عبثا أن أهتدي إلى موقفك أنت مما تكتب، و أي فلسفة تنتمي إليها…؟ ” يقول كمال: ” إني سائح في متحف لا أملك فيه شيئا، مؤرخ فحسب، لا أدري أين أقف…” و نظرا لموقف كمال المتشكك حيال كل عقيدة و كل إيمان، لا يتحمس كثيرا إزاء إيمان رياض قلدس بالعلم و الفن.
” لم يكن كمال غارقا في السياسة كرياض، أجل لم يستطع الشك أن يدمرها فيما دمر فلبثت حية في عواطفه، كان يؤمن بحقوق الشعب بقلبه، و إن كان عقله لا يدري أين المفر. عقله يقول حينا ” حقوق الإنسان ” و حينا آخر يقول ” بل البقاء للأصلح و ما الجماهير إلا قطيع” و ربما قال ” و الشيوعية أليست تجربة جديرة بالاختبار؟ ” ….”
بارقة أمل أو الأنفاس الأخيرة
لا نستطيع إنهاء حديثنا عن كمال عبد الجواد، حديثنا هذا الذي يمكن اعتباره مجرد مقدمة أو اقتراح نحو إحاطة أشمل و أثرى ليس هذا مكانها، دون أن نشير إلى موقف كمال عبد الجواد، قرب نهاية سطور هذه الملحمة الإنسانية الكبرى، من ابني شقيقته خديجة، عبد المنعم المنتمي إلى الإخوان المسلمين و أحمد المنتمي لجماعة ماركسية سرية، بعد القبض عليهما، و ما يقوله له أحدهما، أحمد، و يوافقه عليه شقيقه الإخواني عبد المنعم، من دعوة للإيمان و للثورة الأبدية ، و العمل الدائب على تحقيق إرادة الحياة ممثلة في تطورها نحو المثل الأعلى، مهما كانت طبيعة هذا المثل الأعلى الذي يؤمن به المرء.
و عندما يروي كمال ما قاله له الشابان على صديقه رياض، يستبشر الأخير انقلاب خطير يوشك أن يقع، و هنا يقول كمال في حذر: ” لا تسخر مني إن مشكلة الإيمان مازالت قائمة بدون حل، و غاية ما أعزي به نفسي هو أن المعركة لم تنته، و لن تنته و لو لم يبق من عمري إلا ثلاثة أيام كأمي…”
متأخرة للغاية ربما جاءت صحوة كمال عبد الجواد، و لعلها صحوة سطحية و قصيرة العمر، تحت وطأة ما يحدث حوله، و لن تلبث أن تمر مرور الكرام مع الوضع في الاعتبار تراكم الخبرات و السنوات، و معركته الأبدية مع الإيمان.
و لو أن روائيا لعوبا، قرر في المسقتبل أن يسجل الأيام الأخيرة من حياة كمال عبد الجواد في رواية، فلن يجده هناك قد حطم عزلته و استعاد إيمانه الضائع بنفسه و بالحياة، بل على الأغلب سنرى عجوزا خرفا ضائعا في متاهة مكتبته مازال يتساءل عن معنى الوجود، و عبثية الموت، و أسطورة الحب، ومازال يساءل الصمت الكوني عما يحكم هذا الوجود: العقل أم الجنون؟
” و لكن لعل الشك نوع من الهروب كالتصوف و الإيمان السلبي بالعلم. فهل تستطيع أن تكون مدرسا مثاليا و زوجا مثاليا و ثائرا أبديا؟!”