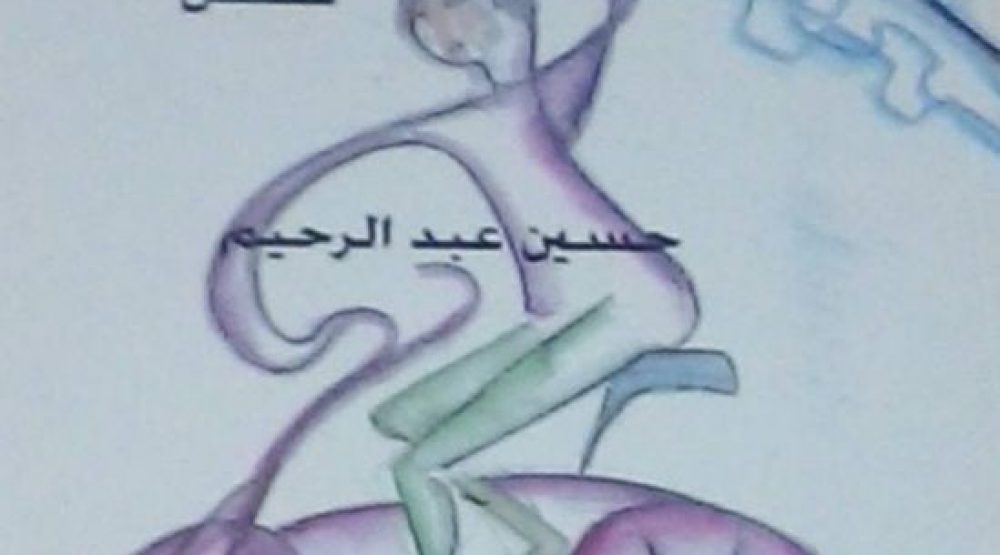في قصة «عبده فلاش»، يلتحم خط القص الرئيس مع كلام الشخوص، وتلوح عوالم حسين عبد الرحيم الحميمة «فرشة الفاكهة والحاج حسن عبد الرحيم الصعيدي»، وتتجادل مع الهم العام «بورسعيد في لحظتها الفارقة أثناء العدوان الثلاثي على مصر 1956م»، وبما يمهد لاستعادة أجواء إنسانية خلقت ثقافتها الخاصة، فتبرز مثلاً أغاني المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي. وعبر تداخل زمني خاص يبدأ بالراهن المعيش، ثم يرتد إلى الماضي «لحظة العدوان الثلاثي»، ثم العودة من جديد إلى اللحظة الراهنة.
ما بين القاهرة الآن وبورسعيد قديماً، تتشكل ملامح النص القصصي لدى حسين عبدالرحيم، هذا النص المسكون بنوستالجيا عارمة يصبح فيها الحنين إلى الماضي هاجساً لروح قلقة ومحفزاً لها في آن، وليس محض ذكرى عابرة، بل باعث متجدد على الألم، والغربة والتساؤل.
في «يا حمام روح»، نرى الموازاة بين الحالة النفسية للشخوص، والأجواء الفيزيقية المحيطة (خريف فربيع)، وبما يؤذن بمزاج نفسي متقلب، ينبش دائماً في الذاكرة/ الماضي، وكأنّ لدى شخوص المجموعة إصراراً متجدداً على استعادة ما كان «بورسعيد الزمان والمكان». ثمة أمكنة ترتحل مع الكاتب في نصوصه التي ينتظمها خيط جامع «القاهرة/ بورسعيد»، واستعادة الكاتب هنا للأمكنة تتجاوز دلالاتها المادية المباشرة إلى مرموزاتها الدلالية.
في «قفزة أخرى لطائر وحيد»، ثمة تنويع في استخدام صيغ الحكي، تبدأ بضمير المخاطب، انتهاءً بالمقطع الأخير المكتوب بضمير الغائب. وهنا يلوح شجن خاص، قفزة جديدة لطائر مأزوم صوب نسائه الجميلات، معتقداً أنّ في الحب مأوى وملاذاً له.
في «مشوار» تبدو ملامح المكان القديم مهيمنة على فضاء المشهد القصصي، بخاصة حين يأتي ذكر «قناة السويس»، وتأثيرات خبر خصخصتها على سيكولوجية ضابط حارب من أجلها. في «سبعة وجوه من رماد»، ثمة محاولة لأنسنة الفكرة عبر محاولة فنية واعية لتخليص مشهد ناصر من أسطوريته، والتعاطي معه من زاوية التخييل السردي، فيلوح مشهد التنحي ومن بعده مشهد موت الزعيم عام 1970، فيقارب الكاتب هذه الحوادث الدالة والفارقة ويخرجها من حيز الرصد الوثائقي المباشر ذي الصبغة التاريخية إلى طابع فني محض، تستعاد فيه الأسئلة القديمة ويوضع كل شيء موضع المراجعة، بلا صراخ أيديولوجي وبلا مباشرة.
في» تيكني كولور»، نرى رصداً رهيفاً لحالة ما بين الصحو والغفوة، ما بين اليقظة والحلم، لنصبح أمام تعبير جمالي عن عالم هذه المجموعة الواقفة في منتصف المسافة بين الواقع والمتخيل، بين ما كان وما هو كائن، بين بورسعيد الباسلة، والقاهرة الصاخبة، بين حضور المقولات الكبرى، وتشظيها في آن: «حاول أن يتحسس طريقه وسط الظلام الدامس، مازال في انتظار دقات جرس المنبه، شعر بدوار، رأى نفسه يسير فوق طوار طويل، اقترب من وسط الميدان وهمّ بسؤال السائق. مسرح البالون. رايح فين هناك. معمل تيكني كولور للتحميض». (ص 31).
ثمة حالة من الحزن الموجع تختص قصة فرح، والتي تتحدث عن موت فتاة يافعة تحت أنقاض فندق متهالك، فيما السارد يتلقى خبر مولد ابنته التي كان قد قرر أن يسميها «فرح».
تطلّ بورسعيد من جديد في قصة «وهذا البلد»، بدءاً من المفتتح: «بورسعيد يا مجدي الغابر»، وصولاً إلى التماهي بين الذات الساردة والمدينة المفقودة عقب تراكمات خلفتها سنوات الانفتاح الاقتصادي الكارثية، بما أحدثته من هزة قيمية ومجتمعية، تطل بورسعيد لا بوصفها مكاناً مادياً متعيناً، عبر بناياتها القديمة وشوارعها المسكونة برائحة شهداء الاحتلال البريطاني ومن بعده العدوان الثلاثي، ولكن عبر فضاءاتها النفسية الواسعة التي تخلقها حال الذكرى والتأسي على ما فات، ويصبح مثلاً حضور اسم الشهيد البطل/ الطفل «نبيل منصور» الذي سقط برصاص الاحتلال الإنكليزي، مؤشراً على معان كبرى داخل النص، ومفجراً لعدد هائل من الأسئلة عن التحولات السياسية والاجتماعية التي صاحبت المدينة في ما بعد منذ منتصف السبعينات.
تتداخل الأصوات في قصة «طريق» على نحو مفعم بالدلالة، وبما يمنح النص القصصي حيوية خاصة، إذ يبدأ الكاتب بصوت الأم، يتلوه صوت السارد الرئيسي، ثم نرى توظيفاً لآلية المونولوغ عبر مخاطبة الذات لنفسها: «نعم الآن، الآن تحديداً يا حسين عليك أن تفعل ما تمليه عليك الأقدار» (ص 45)، ثم صوت البطل المساعد في القصة، سعيد، ثم صوت الشقيق الأصغر للبطل أحمد، وهكذا… تعتمد هذه القصة أيضاً على المفاجأة، ساعيةً إلى كسر أفق التوقّع لدى قارئها.
في «يوم جمعة»، يصبح الحدث القصصي الرئيسي «وفاة صديق الراوي»، مفجراً لأسئلة عميقة تصنع ندوباً داخل الروح، يبثها القاص على دفعات داخل نصه، الذي يبدأ بألم وجودي محض: «كيف سيتحمل إنسان هذا الزمان كل هذه الآلام؟»، ثم ينهيه بسؤال آخر ينبئ عن رثاء للذات وإحساس بالفجيعة القادمة: «أين سيكون المستقر يا حسن؟» (ص 57).
في «زووم إن»، النص الذي تحمل المجموعة اسمه، يتجاور بشير الديك وعاطف الطيب، وتتجاور أفلام «سكة سفر»، و «سواق الأتوبيس»، ويحضر فارس بطل فيلم «الحرّيف» جنباً إلى جنب منتصر، بطل فيلم «الهروب»، لنصبح وباختصار أمام عالم مسكون بالتنوع والتجاور والنظر المختلف للواقع والأشياء، وهو العالم الذي ينحاز إلى السرد السلس، وتداعي المعاني، والانتقالات الذكية لحسين عبدالرحيم بين الجمل والمقاطع في مجموعته التي تبدو أكثر نضجاً وإحكاماً من نصوصه السابقة، وتعبيراً جمالياً بديعاً عن حيوية القصة المصرية في لحظتها الراهنة.