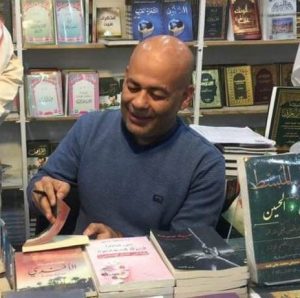كان النظر من النافذة تسلية كبيرة ومهمة، حتى إن التليفزيون عندما وصل أخيرا إلى تركيا، كان الناس يتصرفون أمام أجهزتهم بنفس الطريقة التى كانوا يسلكونها أمام نوافذهم. وعندما كان أبى وأعمامى وجدتى يشاهدون التليفزيون، كانوا يتناقشون دون نظر بعضهم إلى بعض، ويتوقفون مرة تلو الأخرى لوصف ما رأوه للتو، تماما كما كانوا يفعلون وهم يطلون من النافذة.
«إذا استمر تساقط الثلوج هكذا، فسوف تتعطل حركة السير»، كانت عمتى تقول ذلك وهى تنظر إلى كتل الجليد تسقط فى حركة دائرية.
وكنت أقول وأنا أنظر من النافذة الأخرى التى تطل على الشارع العريض الذى توجد به خطوط الترام: «ذلك الرجل الذى يبيع الحلوى قد عاد إلى ناصية نيشانتاشى».
فى أيام الآحاد كنا نذهب إلى الطابق العلوى مع أعمامى وعماتى وأى شخص آخر يعيش فى شقق الطوابق السفلية لتناول طعام الغداء مع جدتى. وبينما كنت أطل من النافذة فى انتظار وصول الطعام، كنت أشعر بسعادة غامرة لأننى هناك مع أمى وأبى وعماتى وأعمامى، حتى إن كل شىء كان يبدو متلألئا تحت الضوء الباهت المنبعث من الثريا الكريستال المعلقة فوق مائدة الطعام الطويلة. كانت غرفة جلوس جدتى مظلمة، كما كانت كذلك حجرات الجلوس السفلية، ولكن بالنسبة لى كانت تبدو دائما أكثر ظلمة. ربما كان هذا بسبب الستائر التل والستائر القطيفة الثقيلة المعلقة على كل جانب من أبواب الشرفة التى لا تفتح أبدا، لتلقى بظلال مخيفة. أو ربما كانت البارافانات المرصعة بعرق اللؤلؤ، والمناضد الضخمة، والصناديق الكبيرة، والنموذج الصغير للبيانو الكبير. مع كل تلك الصور الفوتوغرافية ذات الإطارات فى الأعلى، أو الفوضى العامة لتلك الغرفة الخالية من الهواء والتى دائما ما نستنشق بها رائحة الغبار.
انتهت الوجبة، وكان عمى يدخن فى إحدى الغرف المظلمة المجاورة. قال: «لدى تذكرة لمباراة كرة قدم ولكنى لن أذهب»، ثم أضاف: «سيأخذكم أبوكم بدلا منى».
يصيح أخى الأكبر من الغرفة الأخرى: «دادى، خذنا إلى مباراة كرة القدم».
تنادى أمى من حجرة الجلوس: «سوف يستفيد الأولاد من الهواء النقى».
قال أبى لأمى: «إذن خذيهم أنت إلى الخارج».
ردت أمى: «أنا ذاهبة إلى أمى».
قال أخى: «نحن لا نريد الذهاب إلى جدتى».
قال عمى: «يمكنك أن تأخذ السيارة»
قال أخى: «أرجوك يا أبى!».
ثم كان هناك صمت غريب طويل. وكأن كل شخص فى الغرفة يفكر أفكارا معينة حول أمى، وكأن أبى يستطيع أن يقول ماذا كانت تلك الأفكار.
سأل أبى عمى: «إذن سوف تعطينى سيارتك، أليس كذلك؟»
فيما بعد، عندما نزلنا إلى الطابق السفلى، وبينما كانت أمى تساعدنا على ارتداء بلوفراتنا وجواربنا الصوفية الكاروهات السميكة، كان أبى يقطع الردهة جيئة وذهابا، وهو يدخن سيجارة. ترك عمى سيارته الدودج موديل 52 «الأنيقة بلون الكريم» أمام مسجد «تشويكيا» (Teşvikiye). سمح أبى لكلينا بالجلوس فى المقعد الأمامى للسيارة، ونجح فى جعل المحرك يدور من أول لفة للمفتاح.
لم يكن هناك طابور أمام الاستاد. قال أبى للرجل الواقف أمام باب الدخول: «هذه التذكرة لهما معا، أحدهما فى الثامنة والآخر فى العاشرة. وأثناء مرورنا كنا نخشى أن ننظر فى عينى الرجل. كانت هناك مقاعد خالية كثيرة فى المدرج، وجلسنا فورا.
خرج الفريقان بالفعل إلى الملعب الموحل، واستمتعت بمشاهدة اللاعبين يجرون هنا وهناك فى سراويلهم البيضاء الناصعة وهم يقومون بعمليات الإحماء. قال أخى، مشيرا إلى أحدهم: «انظر، هذا هو محمد الصغير.. لقد صعد للتو من فريق الأشبال».
«نحن نعرف».
بدأت المباراة، ولوقت طويل التزمنا الصمت. وبعد فترة قصيرة تاهت أفكارى عن المباراة إلى أشياء أخرى. لماذا يرتدى لاعبو كرة القدم جميعهم نفس الزى بينما كانت كل أسمائهم مختلفة؟ تخيلت أنه لم يعد هناك لاعبون يجرون هنا وهناك فى الملعب، وإنما فقط الأسماء. وكانت شورتاتهم تتسخ أكثر وأكثر. بعد فترة راقبت سفينة كبيرة ذات مدخنة تمر ببطء عبر مضيق البوسفور ظاهرة خلف المدرجات. لم يسجل أى من الفريقين أهدافا حتى نهاية الشوط الأول. واشترى أبى لكل منا قرطاسا من الحمص وكعيكة بالجبن.
«دادى، لا أستطيع الانتهاء من هذا الطعام»، قلت ذلك وأنا أريه ما تبقى فى يدى من طعام.
قال: «ألقه هناك.. لن يراك أحد».
وقفنا وأخذنا نتحرك حتى نشعر بالدفء، تماما كما فعل الآخرون جميعا. كنا مثل أبينا نضع أيدينا فى جيوب سراويلنا الصوفية، ورحنا نتلفت للنظر إلى الجمهور الجالس خلفنا، وذلك عندما نادى شخص من الزحام على أبى. وضع أبى يده على أذنه إشارة إلى أنه لا يستطيع سماع شىء فى كل هذا الضجيج.
وقال: «لا أستطيع الحضور»، واستطرد مشيرا إلينا: «معى أطفالى».
كان الرجل الموجود وسط الزحام يرتدى وشاحا أرجوانيا. وكافح حتى يصل إلى صفنا، وهو يدفع ظهور المقاعد ويدفع بعض الجالسين حتى يصل إلينا.
سأل والدى بعد أن عانقه: «هل هما ولداك؟ إنهما كبيران، لا أستطيع أن أصدق ذلك».
لم يقل والدى شيئا.
قال الرجل: «إذن متى ظهر هذان الطفلان؟»، وهو ينظر إلينا بإعجاب، ثم استطرد: «هل تزوجت بمجرد أن أنهيت المدرسة؟»
أجاب والدى دون أن ينظر فى وجه الرجل: «نعم». وتحدثا لفترة أطول. ثم استدار الرجل ذو الوشاح الأرجوانى إلى أخى وإلى ووضع بعض الفول السودانى المقشر فى أيدينا. وعندما ذهب جلس أبى فى مقعده، ولفترة طويلة لم يقل شيئا.
ولم يمر وقت بعد أن عاد الفريقان إلى أرض الملعب وهم يرتدون شورتات نظيفة، حتى قال والدى: «هيا بنا نعود إلى البيت، لقد بدأتما تشعران بالبرد».
قال أخى: «أنا لا أشعر بالبرد».
قال والدى: «نعم، تشعر بالبرد، وعلى كذلك. هيا بنا دعنا نذهب».
وبينما كنا نشق طريقنا وسط الآخرين، كنا نصطدم بالركب، وأحيانا ندوس فوق أقدام الجالسين، وقد دسنا فوق الطعام الذى تركته على الأرض. وبينما كنا نهبط المدرج سمعنا الحكم ينفخ فى صفارته كإشارة لبدء الشوط الثانى.
سأل أخى: «هل كنت تشعر بالبرد؟.. لماذا لم تقل إنك لم تكن تشعر بالبرد؟» ظللت صامتا، قال: «غبى».
قال أبى: «يمكنك أن تستمع إلى الشوط الثانى من الراديو بالبيت».
قال أخى: «هذه المباراة ليست مذاعة من الراديو».
قال أبى: «هدوءا الآن، سوف آخذكما من طريق «التقسيم» أثناء عودتنا».
ظللنا صامتين، قاد أبى السيارة عبر الميدان، وتوقف بالضبط قبل أن نصل إلى مكتب المراهنات خارج الطريق تماما كما ظننا. وقال: «لا تفتحا الباب لأى أحد، سوف أعود فورا».
ثم خرج من السيارة، وقبل أن يقوم بغلق السيارة من الخارج ضغطنا على الأزرار وأغلقناها نحن من الداخل. ولكن أبى لم يذهب إلى مكتب المراهنات، بل جرى إلى الجانب الآخر من الشارع المرصوف بالحصى. كان هناك محل مزين بملصقات السفن، وطائرات بلاستيكية كبيرة، ولوحات لمناظر طبيعية مغمورة بأشعة الشمس، وكان المحل مفتوحا أيضا أيام الآحاد، ودخل أبى هذا الدكان.
«أين ذهب والدى؟»
سأل أخى: «هل سنلعب بالدور العلوى أم الدور السفلى عندما نصل البيت؟»
وعندما عاد أبى كان أخى يلعب بدواسة البنزين. وانطلقنا عائدين إلى نشانتاشى، وتوقفنا مرة أخرى أمام مسجد.
قال أبى: «ألا ترغبان فى أن أبتاع لكما شيئا!… ولكن أرجوكما ألا تطلبا تلك السلسلة من الشخصيات المشهورة مرة أخرى».
ورحنا نرجوه: «أوه، من فضلك يا أبى.. أرجوك».
وعندما دخلنا محل علاء الدين ابتاع أبى لكل منا عشر عبوات من العلكة من سلسلة الشخصيات المشهورة. وذهبنا إلى البناية التى نقطن بها، كنت فى حالة انفعال شديد عندما وصلنا إلى المصعد حتى ظننت أننى سأبلل سروالى، كان الطقس دافئا بالداخل، ولم تكن أمى قد عادت بعد. أسرعنا بفتح أوراق العلكة ونحن نلقى بالأغلفة على أرضية الحجرة. والنتيجة:
حصلت أنا على نسختين من فيلد مارشال فوزى شاكماك، ونسخة من كل من شارلى شابلن والمصارع هاميت كابلان وغاندى وموتسارت وديجول، واثنتين لأتاتورك وواحدة لجريتا جاربو رقم 21 التى لم يحصل عليها أخى بعد. وبهذه المجموعة أصبح لدى 173 صورة من الشخصيات المشهورة. ولكنى ما زلت بحاجة إلى 27 شخصية أخرى لاستكمال المجموعة. حصل أخى على أربع نسخ من فيلد مارشال فوزى شاكماك (فيلد مارشال فوزى شاكماك جنرال فى حرب الاستقلال1876 ـ 1950)، وخمسة لأتاتورك. وواحدة لأديسون. وقذفنا بالعلكة إلى أفواهنا وبدأنا قراءة المكتوب على خلفية البطاقات..
علكة حلويات مامبو
الشخص المحظوظ الذى سيقوم بجمع الـ100 شخصية المشهورة سيحصل على هدية كرة قدم من الجلد كان أخى يحمل مجموعته المكونة من 165 بطاقة: «هل تحب أن تلعب فوق أم تحت؟»
«لا»
سألنى: «هل تعطينى جريتا جاربو مقابل بطاقاتى الاثنتى عشرة لفوزى شاكماك؟» وعندئذ يصبح لديك 184 بطاقة».
«لا»
«ولكنك الآن لديك بطاقتان لجريتا جاربو»
لم أقل شيئا.
وقال لى: «عندما يقومون بتطعيمنا فى المدرسة، سيكون التطعيم موجعا حقّا، لا تتوقع منى أن أهتم بك، أوكى؟»
«لن أفعل على أى حال».
تناولنا عشاءنا فى صمت. وعندما أذيع برنامج عالم الرياضة على الراديو، اكتشفنا أن المباراة انتهت بالتعادل 2 ـ 2، ثم جاءت أمنا إلى حجرتنا لتضعنا فى الفراش. بدأ أخى فى تجهيز حقيبته للمدرسة، وجريت أنا إلى حجرة الجلوس. كان أبى واقفا أمام النافذة يحدق أسفل الشارع.
«أبى، لا أريد الذهاب غدا إلى المدرسة».
«كيف تقول ذلك الآن؟»
«إنهم سيقومون بتطعيمنا غدا، وأنا أصاب بحمى، وأتنفس بصعوبة. أسأل أمى».
نظر إلى ولم يقل شيئا. جريت بسرعة إلى الدرج وأخرجت قلما وورقة صغيرة.
سأل أبى: «هل تعلم أمك هذا الموضوع؟»، وهو يضع الورقة فوق مجلد كيركجارد الذى كان يقرؤه دائما ولكنه لم ينجح أبدا فى إكماله. واستطرد: «سوف تذهب إلى المدرسة ولكنك لن تأخذ تلك الحقنة»، وأضاف: «ذلك ما سوف أكتبه».
ثم قام بالتوقيع، ونفخت أنا على الحبر، ثم طويت الورقة ووضعتها فى جيبى وأنا أجرى عائدا إلى حجرة النوم، ووضعت الورقة فى حقيبتى، ثم تسلقت إلى الفراش وبدأت أقفز فوقه.
قالت أمى: «الزم الهدوء، حان وقت النوم».
2
كان منزل جدتى الأخرى قريبا من مسجد صقلية فى نهاية خط الترام. والآن يزدحم الميدان بمحفات المينى باص والأتوبيسات البلدية وبمبان عالية قبيحة ومحلات كبرى لصقت عليها اللافتات، ومكاتب يتدفق العاملون بها فوق الأرصفة وقت وجبة الغداء كالنمل، ولكن فى تلك الأيام كانت على أطراف المدينة الأوروبية. كان الطريق يستغرق منا خمسة وعشرين دقيقة سيرا من منزلنا إلى الميدان الواسع المرصوف بالحصى. وبينما نسير يدا بيد مع أمى تحت أشجار الزيزفون والتوت، كنا نشعر وكأننا جئنا إلى الريف.
تعيش جدتى الأخرى فى منزل من أربعة طوابق بنى بالحجارة والخرسانة ويشبه علبة كبريت مقلوبة على جنبها، ويواجه البيت إسطنبول من الناحية الغربية، وخلفه كانت بساتين التوت فى التلال. وبعد وفاة زوجها وزواج بناتها الثلاث، لجأت جدتى للعيش فى غرفة واحدة فى هذا المنزل الذى كان مزدحما بالخزانات والمناضد والصوانى والبيانوهات وقطع الأثاث الأخرى. وكانت خالتى تطهو لها الطعام وتجلبه أو تضعه فى آنية معدنية وترسله لها مع سائقها. لم يكن الأمر أن جدتى لا تريد ترك حجرتها لتنزل مجموعتين من السلالم إلى المطبخ لتطبخ، فهى لم تكن تذهب حتى إلى حجرات المنزل الأخرى، والتى كانت مغطاة بطبقة سميكة من الغبار وأنسجة العنكبوت الحريرية. ولكن الأمر كان أن جدتى، مثل أمها التى قضت سنوات عمرها الأخيرة منفردة فى دار خشبية فخمة كبيرة، استسلمت جدتى لمرض انزوائى غامض، ولم تكن تسمح بوجود من يعتنى بها أو من يقوم بشئون النظافة اليومية.
وعندما كنا نذهب لزيارتها، كانت أمى تضغط على الجرس لفترة طويلة، وتطرق البوابة الحديدية حتى تفتح جدتى فى النهاية المصاريع الحديدية الصدئة على نافذة الطابق الثانى المطلة على المسجد وتحدق فينا، ولأنها لم تكن تثق فى عينيها كانت لا تستطيع الرؤية لمسافة بعيدة كانت تطلب منا أن نلوح لها بأيدينا.
قالت أمى: «تعالوا بعيدا عن المدخل حتى تستطيع جدتكم أن تراكم يا أطفالى».
وتراجعت معنا إلى منتصف الرصيف، وأخذت تلوح وتصيح: «أمى يا عزيزتى، هذا نحن، أنا والأطفال، هل تسمعيننا؟»
وأدركنا من ابتسامتها الحلوة أنها تعرفت علينا. وعلى الفور انسحبت من النافذة، وذهبت إلى غرفتها وأخرجت المفتاح الكبير الذى تحفظه تحت وسادتها، وبعد أن لفته بورق الجرائد ألقته إلينا من النافذة. وانطلقنا أخى وأنا نتدافع ونتصارع لالتقاطه.
كانت ذراع أخى لا تزال يؤلمه، مما جعله يبطئ، ولذلك فقد وصلت قبله إلى المفتاح، وأعطيته لأمى. وببعض المجهود نجحت أمى فى فتح الباب الحديدى الكبير. وبدأ الباب يتحرك ببطء ونحن الثلاثة نقوم بدفعه. ومن الظلمة جاءت تلك الرائحة التى لن أصادف مثلها أبدا: تحلل، عفن، غبار، شيخوخة، وهواء راكد. لكى تجعل اللصوص المتكاثرين يعتقدون أن هناك رجلا بالمنزل، تركت جدتى على مشجب المعطف يمين الباب مباشرة قبعة جدى المصنوعة من اللباد ومعطفه ذا الياقة الفراء، وفى الركن كان الحذاء ذو الرقبة، والذى كان يخيفنى دائما.
بعد قليل، فى نهاية مجموعتين مستقيمتين من السلالم الخشبية، وبعيدا، بعيدا جدا، رأينا جدتى واقفة يغمرها ضوء أبيض. تبدو كالشبح وهى تقف ساكنة تماما فى الظلال المحيطة مستندة إلى عكازها، لا يضيؤها سوى الضوء النافذ من خلال الأبواب ذات الألواح الزجاجية المصنفرة والحديد المشغول.
وأثناء صعودها على درجات السلم الخشبى التى تحدث صريرا، لم تقل أمى لجدتى شيئا. (أحيانا كانت تقول «كيف حالك يا أمى الحبيبة؟»، أو «أمى يا عزيزتى لقد افتقدتك، الجو بارد جدا بالخارج يا أمى يا عزيزتى!»). وعندما وصلت إلى أعلى السلم، قبلت يد جدتى، محاولا ألا أنظر إلى وجهها أو إلى الشامة الضخمة على رسغها. وكنا لا نزال نشعر بالخوف من السن الوحيد الموجود فى فمها وذقنها الطويل، والشعر الموجود حول فمها. ولذلك بمجرد دخولنا الغرفة ربضنا بجوار أمنا. وعادت جدتى إلى الفرش الذى تقضى فيه معظم اليوم فى قميص نومها الطويل ووشاحها الصوفى، وابتسمت لنا وهى تنظر إلينا نظرة تقول: حسنا، قوموا الآن بتسليتى.
قالت أمى: «مدفأتك لا تعمل بصورة جيدة يا أمى»، وتناولت منخس النار وراحت تحرك به الفحم.
انتظرت جدتى لفترة قصيرة، ثم قالت: «اتركى المدفأة وشأنها الآن، وقولى لى ما الأخبار؟ وماذا يجرى فى العالم؟»
قالت أمى وهى تجلس بجانبنا: «لا شىء على الإطلاق يا أمى العزيزة».
«أليس لديك ما تقوليه لى على الإطلاق؟»
«لا شىء مطلقا يا أمى العزيزة».
بعد فترة صمت قصيرة، سألت جدتى: «ألم ترى أحدا؟»
«تعلمين ذلك بالفعل يا أمى العزيزة».
«لوجه الله، أليس لديك أى أخبار؟»
ساد صمت.
قلت أنا: «جدتى، لقد تم تطعيمنا بالمدرسة».
قالت جدتى وهى تفتح عينيها الزرقاوين الكبيرتين وكأنها فوجئت: «صحيح؟ هل كان مؤلما؟»
قال أخى: «ما زالت ذراعى تؤلمنى».
قالت جدتى وهى تبتسم: «أوه، يا عزيزى».
ثم كان هناك صمت آخر طويل. وقمنا أخى وأنا لنطل من النافذة على التلال البعيدة وأشجار التوت وعشة الدجاج القديمة الخالية فى الحديقة الخلفية.
قالت جدتى مناشدة: «أليس لديك ما تروينه لى مطلقا؟ تصعدين لرؤية حماتك، ولا شىء آخر؟»
قالت أمى: «جاءت ديلروبا هانم عصر الأمس، ولعبت الورق مع جدة الأولاد».
عندئذ، وبصوت فرح، قالت جدتنا ما توقعناه: «تلك سيدة القصر!»
كنا نعلم أنها لا تتحدث عن أحد تلك القصور ذات اللون الأبيض المائل للصفرة التى قرأنا عنها كثيرا فى القصص الخيالية والصحف فى تلك الأعوام، ولكن عن قصر دولما بختش Dolmabahçe وأدركت بعد زمن فيما بعد أن جدتى كانت تنظر باستعلاء إلى ديلروبا هانم التى جاءت من حريم السلطان الأخير لأنها كانت محظية قبل زواجها من رجل أعمال، وأنها كانت تنظر باستعلاء أيضا إلى جدتى لأنها تصادق هذه المرأة. ثم انتقلنا إلى موضوع آخر كانتا تناقشانه فى كل زيارة تقوم بها أمى: كانت جدتى تذهب كل أسبوع إلى باى أوجلو لتناول الغداء فى مطعم مشهور ومرتفع الأسعار يدعى عبدالله أفندى، وبعد ذلك كانت تشكو كثيرا من كل شىء أكلته. ثم فتحت الموضوع الثالث المعروف مسبقا بالسؤال التالى: «يا أطفال، هل تجعلكم جدتكم تأكلون البقدونس؟»
أجبنا فى صوت واحد قائلين ما أوصتنا أمنا بقوله: «لا يا جدتى، إنها لا تفعل ذلك».
وكالعادة، قالت لنا جدتنا إنها رأت قطة تتبول على البقدونس فى إحدى الحدائق، وإنه من المحتمل جدّا أن ينتهى الأمر بذلك البقدونس لأن يصبح دون غسيل جيد جزءا من طعام شخص أبله، وكيف أنها لا تزال تناقش هذا الأمر مع بائعى الخضر فى سيسلى ونشانتاشى.
قالت أمى: «يا أمى العزيزة، الطفلان يشعران بالملل، هما يريدان أن يلقيا نظرة على الغرف الأخرى. سأذهب لأفتح لهما الحجرة المجاورة».
كانت جدتى تغلق كل حجرات المنزل من الخارج لتمنع أى لص قد يدخل من إحدى النوافذ من الوصول لأى حجرة أخرى فى المنزل. فتحت أمى الحجرة الكبيرة الباردة التى تطل على الشارع الذى تسير فيه خطوط الترام. ووقفت هناك معنا للحظة تنظر إلى المقاعد ذات الذراعين، والأرائك التى تغطيها الأتربة، والمصابيح، والصوانى، والمقاعد التى يعلوها الصدأ والغبار، ورزم الصحف القديمة، وسرج الحصان البالى، ودراجة الفتيات ذات الصرير والمقود المكسور فى الركن. ولكنها لم تخرج أى شىء من صندوق الثياب لتريه لنا، كما كانت تفعل فى أيام أكثر بهجة («كانت أمكما ترتدى هذا الصندل عندما كانت صغيرة، يا أطفالى»؛ «انظرا إلى زى المدرسة الخاص بخالتكما، يا أطفالى»؛ «هل تودان رؤية الحصالة الخنزير الخاصة بأمكما خلال فترة الطفولة، يا أطفال؟»
قالت أمى: «إذا شعرتما بالبرد تعاليا وأخبرانى»، وانصرفت.
جرينا إلى النافذة، أخى وأنا، لننظر إلى المسجد والترام فى الميدان. ثم قرأنا فى الصحف حول مباريات كرة القدم القديمة. قلت: «أشعر بالملل، هل تحب أن تلعب فوق أم تحت؟»
قال أخى: «المصارع المهزوم يريد النزال»، دون أن يرفع عينيه عن صحيفته، واستطرد: «إننى أقرأ الصحيفة».
كنا قد لعبنا مرة أخرى ذلك الصباح، وفاز أخى ثانية.
«من فضلك!»
«لدى شرط: إذا أنا فزت تعطينى صورتين، وإذا فزت أنت أعطيك واحدة فقط».
«لا. واحدة».
قال أخى: «إذن لن ألعب، إننى أقرأ الجريدة كما ترى».
ثم أمسك الصحيفة تماما مثل المخبر الإنجليزى فى الفيلم الأسود والأبيض الذى شاهدناه مؤخرا فى سينما «أنجيل». وبعد النظر من النافذة فترة أطول قليلا، وافقت على شرط أخى. أخرجنا صور الشخصيات المشهورة من جيوبنا، وبدأنا اللعب. وفى البداية فزت، ولكن بعد ذلك خسرت سبع عشرة بطاقة أخرى.
قلت: «عندما نلعب بهذه الطريقة أخسر دائما. لن أستمر فى اللعب ما لم نعد إلى القواعد السابقة للعبة».
قال أخى وهو لا يزال يقلد ذلك المخبر: «أوكى.. أريد أن أقرأ تلك الصحف على أى حال».
أمضيت بعض الوقت أنظر من النافذة. وأحصيت بطاقاتى بدقة: لا يزال لدىّ 121 بطاقة باقية. عندما غادر أبى أول أمس كان لدى 183! ولكنى لا أريد التفكير فى ذلك. ووافقت على شروط أخى.
وفى البداية كنت أفوز، ولكنه بدأ فى الفوز مرة أخرى. لم يكن يبتسم، مخفيا فرحته وهو يأخذ بطاقاتى ويضيفها لمجموعته.
بعد قليل قال: «إذا كنت تحب، يمكننا أن نلعب ببعض القواعد الأخرى»، وأضاف: «الفائز يأخذ بطاقة واحدة. وإذا فزت أنا يمكننى اختيار البطاقة التى أريدها منك، لأن بعض بطاقاتك ليس عندى منها، وأنت لا تعطينى أبدا من تلك البطاقات».
وافقت، معتقدا أنى سوف أكسب. ولا أعرف كيف حدث ذلك. خسرت فى ثلاث مرات متتالية أهم بطاقة عندى لصالح مجموعته، وقبل أن أنتبه، كنت قد فقدت بطاقتى جريتا جاربو رقم 21، والملك فاروق 78. أردت أن أستعيدها كلها فى الحال، لذلك رددت كبرت اللعبة، كانت تلك هى الطريقة التى أصبحت بها البطاقات العديدة المهمة التى أملكها أينشتين (63)، ورومى (3)، وسركيس نظاريان مؤسس شركة «مامبو للبان وحلوى الفاكهة»، رقم (100)، وكليوباترا (51) وقد تحولت إلى مجموعته فى دورين فقط.
لم أستطع حتى أن أستوعب. ولأننى كنت أخشى أن يغلبنى البكاء، جريت إلى النافذة ونظرت إلى الخارج: كم كان كل شىء يبدو جميلا فقط منذ خمس دقائق وصول الترام إلى محطة النهاية، منظر البنايات السكنية على البعد من خلال أفرع الأشجار التى كانت أوراقها تتساقط، الكلب الراقد فوق أرضية الشارع المرصوفة بالحصى، يخمش نفسه بتكاسل شديد. لو كان الوقت قد توقف، لو فقط استطعنا العودة خمسة مربعات كما فعلنا عندما لعبنا نرد سباق الخيل ما كنت لعبت فوق أو تحت مع أخى مرة أخرى.
ودون أن أرفع جبينى عن لوح النافذة الزجاجى، قلت: «هل نلعب مرة أخرى؟»
قال أخى: «لن ألعب، فأنت سوف تبكى».
«جواد، أعدك لن أبكى». قلت ذلك بإصرار وأنا أتجه إلى جواره. «ولكننا لا بد أن نلعب بالطريقة التى كنا نلعب بها فى البداية، بالقواعد القديمة».
«سوف أقرأ صحيفتى».
قلت: «وهو كذلك»، وأنا أخلط بطاقات مجموعتى التى أصبحت أكثر نحافة من أى وقت مضى، «بالقواعد القديمة، فوق أو تحت؟»
قال: «بدون بكاء، حسنا، فوق».
كسبت، وأعطانى واحدة من فيلد مارشال فوزى شاكماك. لم آخذها.
«هل تعطينى فمن فضلك بطاقتى رقم 78، الملك فاروق؟»
قال: «لا، هذا ما لم نتفق عليه».
لعبنا دورين آخرين، وخسرت. إذا كنا فقط لم نلعب ذلك الدور الثالث، وعندما أعطيته بطاقة نابليون رقم 49 كانت يدى ترتعش.
قال أخى: «لن ألعب أكثر من ذلك».
ناشدته. ولعبنا دورين آخرين، وبدلا من أن أعطيه الصور التى طلبها، رميت كل البطاقات المتبقية معى على رأسه وفى الهواء: البطاقات التى كنت أجمعها على مدى شهرين ونصف الشهر، وأنا أفكر فى كل واحدة منها، وكل شخصية فيها، فى كل يوم يمر، مخبئا إياها، أكدسها متوترا، وأرتبها مهتمّا رقم 28 ماى وست، و82 جول فيرن، و7 محمد الفاتح، و70 الملكة إليزابيث، 41 «جلال ساليك» (Celal Salik) الكاتب الصحفى، 42 فولتير طارت جميعها فى الهواء وتبعثرت فوق أرضية الغرفة.
يا ليتنى كنت فقط فى مكان مختلف تماما، فى حياة مختلفة تماما. قبل أن أعود إلى غرفة جدتى، تسللت بهدوء إلى أسفل درجات السلم التى تصدر صريرا وأنا أفكر فى شخص بعيد القرابة، والذى كان يعمل فى مجال التأمين، وانتحر. أخبرتنى جدتى لأبى أن المنتحرين يبقون فى مكان مظلم تحت الأرض ولا يذهبون إلى الجنة أبدا. عندما مضيت لمسافة طويلة على السلم، توقفت فى الظلام، واستدرت وصعدت إلى أعلى وجلست على آخر درجة، بجوار غرفة جدتى.
وسمعت جدتى تقول: «أنا لست متيسرة الحال مثل حماتك، عليك أن تعتنى بأطفالك وتنتظرى».
قالت أمى: «ولكن من فضلك يا أمى العزيزة، أتوسل إليك، أريد أن أعود هنا مع أطفالى».
قالت جدتى: «لا يمكنك الإقامة هنا مع طفلين، هذا لن يصلح مع كل هذه الأتربة والأشباح واللصوص».
قالت أمى: «يا والدتى العزيزة، ألا تذكرين كم كنا سعداء ونحن نعيش هنا فقط نحن الاثنتين، بعد أن تزوجت أختى وتوفى أبى؟»
«مبروك يا حبيبتى، كل ما كنت تفعلينه طوال اليوم هو تقليب صفحات القضايا القديمة فى دفاتر أبيك».
«إذا أنا أشعلت الموقد الكبير فى الطابق السفلى، فإن هذا المنزل سيكون مريحا ودافئا فى خلال يومين».
قالت جدتى: «قلت لك ألا تتزوجيه، أليس كذلك؟»
قالت أمى: «إذا أحضرت خادمة فسوف يستغرق الأمر منا يومين فقط للتخلص من كل تلك الأتربة».
قالت جدتى: «أنا لن أسمح لأى من هؤلاء الخدم اللصوص بالدخول إلى هذا المنزل.. وعلى أى حال يحتاج الأمر ستة أشهر لإزاحة كل تلك الأتربة وأنسجة العنكبوت. وعندئذ يكون زوجك الضال قد عاد إلى البيت مرة أخرى».
سألت أمى: «هل هذا هو كلامك الأخير، يا أمى العزيزة؟»
«مبرور يا بنيتى الحبيبة، إذا جئت إلى هنا مع طفليك، فعلى أى شىء سنعيش، نحن الأربعة؟»
«أمى العزيزة، كم مرة طلبت منك توسلت إليك أن تبيعى الأراضى فى «بيبك» قبل أن يصادروها؟»
«لن أذهب إلى مكتب العقارات لأعطى هؤلاء الرجال الأقذار توقيعى وصورتى».
قالت أمى وهى ترفع صوتها: «أمى العزيزة، من فضلك لا تقولى ذلك، لقد أحضرنا أختى الكبرى وأنا كاتب التوثيق حتى بابك».
قالت جدتى: «لم أثق أبدا فى ذلك الرجل، يمكن أن يرى الإنسان بوضوح على وجهه أنه محتال، وقد لا يكون حتى كاتب توثيق، ولا تصيحى فى وجهى هكذا».
قالت أمى: «حسنا، يا أمى العزيزة، لن أفعل». ونادت علينا من الغرفة، «يا أولاد، يا أولاد، تعاليا الآن، اجمعا أشياءكما، سوف نذهب».
قالت جدتى: «تمهلى، إننا حتى لم نقل كلمتين».
همست أمى: «إنك لا تريديننا يا أمى العزيزة».
«خذى هذه، دعى الأطفال يتناولون بعض الحلوى التركية».
قالت أمى: «لا ينبغى لهما أن يأكلا شيئا قبل الغداء». وبينما كانت تغادر الحجرة، مرت من خلفى لتدخل الغرفة المواجهة، وقالت لأخى: «من ألقى كل تلك الصور على الأرض؟ التقطها فورا الآن، وأنت… ساعده!»
وبينما كنا نجمع الصور فى صمت، رفعت أمنا أغطية الخزانات القديمة ونظرت إلى الثياب التى تعود إلى طفولتها، أزياء الباليه الخاصة بها، الصناديق الصغيرة. الأتربة تحت الهيكل الأسود لدواسة ماكينة الخياطة ملأت أنفى، وجعلت عينى تدمعان.
وبينما كنا نغسل أيدينا فى الحمام الصغير، توسلت جدتى بصوت ناعم: «مبرور يا عزيزتى، خذى براد الشاى هذا، إنك تحبينه كثيرا، وهو من حقك…. لقد أحضره جدى لأمى العزيزة عندما كان حاكما لدمشق. وهو قد جُلب من الصين، من فضلك خذيه».
قالت أمى: «أمى العزيزة، من الآن لا أريد أى شىء منك، وضعى ذلك فى دولابك وإلا سوف تكسريه، هيا يا أولاد، قبلا يد جدتكما».
قالت جدتى تاركة يدها لنا لنقبلها: «يا صغيرتى مبرور، يا بنيتى الحبيبة، من فضلك لا تغضبى من أمك المسكينة… من فضلك لا تتركينى هنا بدون زيارة، بدون أى أحد».
تسابقنا على درجات السلم، وعندما دفعنا نحن الثلاثة الباب المعدنى الثقيل وفتحناه، غمرنا ضوء الشمس المشرقة ونحن نتنفس الهواء النقى.
صاحت جدتى: «أغلقوا الباب جيدا خلفكم… مبرور، سوف تأتين لرؤيتى مرة أخرى هذا الأسبوع، أليس كذلك؟»
وبينما كنا نسير وأيدينا فى يدى أمنا، لم يتحدث أحد. وأنصتنا فى صمت بينما كان الآخرون يسعلون وهم ينتظرون مغادرة الترام. وعندما بدأنا أخيرا نتحرك، انتقلنا أنا وأخى إلى الصف التالى من المقاعد، قائلين إننا نريد أن نراقب السائق، وبدأنا نلعب فوق أو تحت. وفى البداية خسرت بعض البطاقات، ثم كسبت القليل. وعندما رفعت الرهان، وافق مبتهجا. وسرعان ما بدأت أخسر مرة أخرى، وعندما وصلنا إلى محطة عثمان بيه، قال أخى: «مقابل كل الصور التى بقيت معك، هذه رقم 15 التى تريدها جدّا».
لعبت، وخسرت. وقبل أن أسلم المجموعة كلها لأخى، سحبت خفية صورتين دون أن يرانى. ثم انتقلت إلى الصف الخلفى لأجلس مع أمى. لم أكن أبكى. نظرت بأسى من النافذة بينما كان الترام يئن وأخذت سرعته تتزايد تدريجيّا. وراقبت كل شىء يمر علينا، كل هؤلاء البشر والأماكن الذين ذهبوا إلى الأبد: محلات الخياطة الصغيرة، والمخابز، ومحلات الحلوى تنسدل على واجهاتها المظلات، سينما «تان»، حيث شاهدنا تلك الأفلام عن روما القديمة، والأطفال يقفون بطول الجدار بجوار المقدمة، يبيعون المجلات الهزلية القديمة، الحلاق بمقصاته الحادة، والذى كان يخيفنى أيضا، ومجنون الحى نصف العارى، والذى دائما ما يقف على باب محل الحلاق.
نزلنا فى «هاربيا». وبينما كنا نسير نحو المنزل، كان صمت أخى الذى يعبر عن رضاه يكاد يصيبنى بالجنون. أخرجت صورة لندبرج التى كنت أخبئها فى جيبى.
كانت هذه هى المرة الأولى التى يرى فيها أخى هذه الصورة. قرأ وهو مندهش: «واحد وتسعون ليندبرج، مع الطائرة التى طارت عبر الأطلنطى!.. أين وجدت هذه؟»
قلت: «لم آخذ حقنتى أمس، وذهبت إلى المنزل مبكرا، ورأيت أبى قبل أن يرحل. أبى اشتراها لى».
قال: «إذن نصفها ملكى، فى الواقع عندما لعبنا ذلك الدور الأخير، كان الاتفاق أن تعطينى كل ما تبقى معك من الصور». وحاول أن ينتزع الصورة من يدى، ولكنه لم ينجح. أمسك رسغى ولواه بشكل عنيف جعلنى أركله فى ساقه. وتعاركنا، ووقعنا أرضا متماسكين بالأيدى.
قالت أمى: «توقفا!…. توقفا! نحن فى منتصف الشارع».
توقفنا. مر علينا رجل يرتدى بدلة وامرأة ترتدى قبعة. شعرت بالخجل لتعاركنا فى الشارع. خطا أخى خطوتين وسقط على الأرض. قال وهو يمسك قدمه: «إنها تؤلمنى بشدة».
همست أمى: «قف، تعال هنا الآن. قف، الجميع يراقبوننا».
وقف أخى، وبدأ يحجل على قدمه على الطريق مثل جندى مصاب فى أحد الأفلام، وكنت خائفا أن يكون مصابا بحق، ولكنى كنت لا أزال مسرورا لرؤيته هكذا. وبعد أن سرنا فترة فى صمت، قال: «انتظر وسوف ترى ماذا سيحدث عندما نصل إلى البيت. أمى، على لم يأخذ حقنته بالأمس».
«أخذتها يا أمى».
صاحت أمى: «هدوءا…!»
كنا آنذاك قد وصلنا إلى التقاطع الموصل إلى البيت. انتظرنا أن يمر الترام القادم من متشكا قبل أن نعبر الشارع، وبعد الترام جاءت شاحنة وأتوبيس بيشيكتاش يقعقع وينفث سحبا هائلة من العادم، وفى الاتجاه المعاكس كان ضوء دى سوتو البنفسجى. كان ذلك عندما رأيت عمى يطل على الشارع من النافذة. لم يرنى، فقد كان يحدق فى السيارات المارة، ظللت أراقبه طويلا.
هدأ الشارع واستمر هادئا لفترة طويلة، تحولت لأمى متعجبا لماذا لم تأخذ بأيدينا وتعبر بنا إلى الجانب الآخر، ورأيتها تبكى فى صمت؟!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتب تركي حائز على نوبل