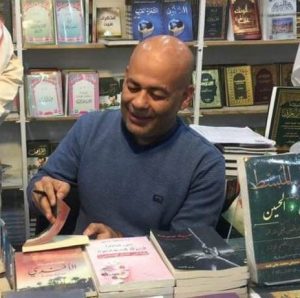ممدوح رزق
دون مقدمات تبدأ ميادة بينما نخرج من شارع المختلط ثم نعبر الطريق إلى كورنيش النيل في حكي تجربة زواجها السابق من الروائي الذي تعرّفت عليه في إحدى ندوات اتحاد الكتاب ثم تزوجها بعد فترة خطوبة لم تستغرق وقتًا طويلًا. تخبرني بأنه أرادها بشكل مفاجئ أن تترك عملها في الصحافة لأن الوسط الثقافي لا يحكمه سوى نسخ من عباس العبد. أشخر ضاحكًا فتقول وهي تشير للأمام: أنظر كيف كنا…
أحرّك عينيّ إلى حيث اتجهت يدها.. كانت هناك أريكة فوق رصيف الكورنيش مواجهة للنيل تجلس عليها ميادة وطليقها.. نقف أمامهما مستندين إلى السور الحديدي دون أن يلتفتا إلينا.. يخاطب الروائي زوجته الصحفية: هل تعرفين بماذا أحلم؟
ـ بماذا؟
ـ باليوم الذي يصبح فيه كوكب الأرض نظيفًا من الروايات المبتذلة.. التي لا تحمل شغفًا، ولا متعة. الروايات الممتلئة بألفاظ بذيئة، ليس لها غاية أو مبرر.. الروايات المترهلة، التي لا تتماشى مع نسق مجتمعنا أو عقلية المتلقي العربي.. الروايات المحبِطة، المكتوبة بأشكال مستهجنة، وغير مستحبّة، وتحكمها تعبيرات لا تمتلك ضرورة فنية، ولا تقدم أي استفادة.
ـ لكن الروايات التي تراها مبتذلة، من الجائز أن تكون ثمينة عند قارئ آخر، والتي تخلو من الشغف أو المتعة بالنسبة لك، ربما تتضمن ذلك لدى قارئ آخر، كما أن الروايات التي تعتبرها مترهلة، من الجائز أن تكون محكمة بطريقتها الخاصة عند قارئ آخر.. فضلًا عن أن هناك قرّاءً ربما يرون أنه ليس حتميًا أن تتماشى الرواية مع نسق مجتمعنا أو عقلية المتلقي العربي حتى تكون رواية جميلة.. كذلك الروايات المكتوبة بأشكال مستهجنة وغير مستحبة بالنسبة لك، من الجائز أن تكون جذّابة لشخص غيرك، والتعبيرات التي تراها بلا ضرورة فنية، ولا تقدم أي استفادة ربما لها أهميتها ولزومها عند شخص غيرك أيضًا.
ـ حبيبتي.. كل هؤلاء القراء الذين تتحدثين عنهم لا يعرفون ولا يفهمون ماذا تعني القراءة أو الكتابة.. طالما أرى الأمر هكذا فهو الصواب الذي لا شك فيه، وعدا ذلك ليس أكثر من هراء وتخريف.
ـ معك حق.
التفت مذهولًا إلى ميادة التي تقف بجانبي مبتسمة وهي تتأمل حوار النسخة القديمة منها مع زوجها السابق. أسألها بسخرية مستنكرة: معه حق؟.. هذا بدلًا من نحت الشخرة المنطقية في وجهه؟!.
تلتفت لي بنفس الابتسامة التي يبدو أنها تسترجع حلمًا لم تطمئن بعد لتفسيره القديم، وتقول بنبرة أقرب إلى الهمس، كأنها لا تريد للرجل والمرأة الجالسين فوق الأريكة ويواصلان حديثهما أن يسمعا كلماتها:
ـ نعم.. كنت أتعمّد أن أقول له ذلك.
تبدأ في التحرّك ببطء فأخطو معها بعيدًا عن الأريكة لنترك الزوجين يمهّدان لانفصالهما الوشيك.. أسألها:
ـ أخبريني بصراحة.. لماذا تزوجتيه؟
ـ لأنني طيبة جدًا.. دون مزاح أو مراوغة، كنت أشفق عليه بحق.. الهشاشة العميقة التي كان يحاول تخبئتها بتسلّطه الأعمى، والضعف البالغ وراء أحكامه المطلقة كان يهيّجني فعلًا.. يمكنك القول بأن الأصل الشرموط المدفون داخل الديكتاتور بوسعه استفزاز الشفقة الأمومية عند امرأة مثلي.
ـ كان يُمتعك كـ “هاملت” الذي يخلع جلد الطاغية قطعة قطعة مثل راقص ستربتيز مقهور حتى يعود إلى رحمك سرًا.
ـ بالفعل، لكنني منذ البداية كنت أعلم بما يعادل القرار الاستباقي أن هذه اللعبة مثلما لها متعتها فإن لها تاريخ صلاحية ستنتهي عنده أيضًا، وحينما يحدث هذا فإنني لن أرغم نفسي على لحظة أزيد في تحمّل شيء لا أقدر، بل لا أريد أن أتحمّله.
نصل إلى أسفل الكوبري.. يمر قطار فوق رأسينا فأتذكر أنني استعملت هذه اللحظة كمجاز في قصة لي منذ عشرين سنة.. تتوقف ميادة فجأة وتسألني كأنما تطالبني بتسديد دين تذكرته حالًا:
ـ احك لي عن امرأة لم تكتب عنها من قبل؟
أجيبها دون تردد:
ـ أستاذة في العلوم السياسية، كانت ميلف حماسية، تعرّفت عليها في ندوة بقصر الثقافة، وأهديتها نسخة من مجموعتي “قبل القيامة بقليل”.. ليلتها طلبت رقم تليفوني، ثم اتصلت بي في اليوم التالي.. أسمعتني قصائد مدح في المجموعة، وأنا ـ كالعادة ـ لا أستطيع الرد كما يجب، وبعد انتهاء المكالمة الطويلة وجدتها ترسل لي على الهاتف آخر الليل المزيد من عبارات الإعجاب بالمجموعة، مقترنة بأكثر الاقتباسات التي أحبّتها من القصص.. رددت عليها بكلمات شكر تقليدية كأنما أحاول التخلّص من ورطة، وحينما استمرّت في بعث الرسائل قررت الاكتفاء بقراءتها لأنني لم أكن قادرًا على مواصلة الرد عليها أكثر من ذلك.
ـ ثم…
أحكي لميادة بقية القصة.. أحكيها كشخص يتمنى أن يكون هذا الحكي طريقة لجعل القصة تخص شخصًا آخر.. هي بالفعل لا تخصني، ولكن بشكل أسوأ.. راقبت نفسي بما أظنه خلاصة الخيبة المؤسفة للعالم، وأنا أتصل بأستاذة العلوم السياسية كي أدعوها بتلعثمي الشهير إلى حفل توقيع “قبل القيامة بقليل”.. راقبت نفسي وأنا أجلس مشاركًا في التصنّع: هذه مكتبة.. أنا كاتب.. هؤلاء قرّاء.. هذا كتاب.. هذه إهداءات.. هذه صور فردية.. هذه صور جماعية.. راقبت نفسي وأنا أشاهد الدكتورة تشتري نسخة من المجموعة أمامي كي أوقّعها لها، رغم أن النسخة التي سبق أن أهديتها إليها مازالت بحوزتها.. كانت ترى في ذلك تكريمًا لي، وتعبيرًا لطيفًا عن تقديرها لكتاباتي.. راقبت نفسي وأنا منتبه إلى حرصها على الجلوس بجواري طوال الوقت، وإلى نظراتها المختلسة لي بينما أتحدث وأضحك وابتسم للقطات الفوتوغرافية المتتابعة.. راقبت نفسي بعد نهاية الحفل، وأنا أغادر المكتبة بعينين تائهتين، وابتسامة بلهاء، وملامح تتظاهر بعدم وجود بركان متحسّر داخلي يرجوها أن تطلب التحدث معي بعيدًا عن الآخرين، ثم تدعوني حين يصبح الكلام سرًا بيننا إلى احتفال خاص في بيتها.
تضحك ميادة وتسألني بتهكم كأنني أهديتها طريقة للثأر مني:
ـ ومتى قمت بحظرها على فيسبوك؟
أنظر لها بتلك الابتسامة التي تفهم منها أنني أوجّه إليها سبابًا سافلًا، يُعبّر عن تقديري لدهائها ومعرفتها المتينة بي.. أجيبها باستسلام:
ـ بعد فترة بسيطة.. لم يكن لدي استعداد لانتظار أمر، أنا متأكد تمامًا من استحالة حدوثه، كما لم يكن لدي صبر على مواصلة البقاء داخل تلك المنطقة المائعة بيننا، خصوصًا أنها كانت تحيط نفسها بمجموعة غلمان من النشطاء السياسيين والحقوقيين وفناني الثورة، وكما تعرفين فإن هذه الإفرازات المهبلية للحياة العامة تسسبب احتقانًا في خصيتي.
ـ لكنك بالتأكيد ضاجعتها كثيرًا؟
ليس كثيرًا يا ميادة.. أحيانًا ونحن نقف متجاورين في المظاهرات كنت أجعلها وسط الهتافات الصادحة تميل إلى أذني وتهمس بأنها تشعر بحريق متصاعد بين فخذيها، أو أن جحافل من النمل المكهرب تسري في شرجها، أو أن ثدييها يكادا يمزقان سوتيانها؛ فننسحب خارج الدعابة الجماهيرية التي أتقن جيدًا تمثيل أني واحد منها ثم نتوجه إلى بيتها لنغيب بعض الوقت، وحينما نعود للانضمام إلى الزومبي كي نواصل الهتاف والتصفيق والغناء ستفوح من جسدينا نفس الرائحة، وستلتقطها أنوف القطيع المحيطة بنا، الأمر الذي سيسبب لتركيز أبنائه في النضال من أجل عالم أفضل ارتباكًا مؤقتًا، سيحاولون تضليله بإنكار عفوي ينقذ كرامتهم.
ـ لكن هذا ليس مجرّد تخيل جنسي، وإنما انتقام أيضًا من “العلوم السياسية”، و”الثورة”، و”الزومبي الشعبي”.
ـ يمكنك القول إنها الحياة الروتينية للممثل بعدما يُنهي تقمّص الدور الذي اختار أن يجرّبه في الدعابة.
ـ أو أن الممثل كان يُشفي غليله، لأنه لم يستطع أن يتحوّل بصورة كاملة إلى زومبي، بمعنى أن يحصل على كل شيء في حياة هؤلاء البشر الذين حاول أن يتقمّص دور واحد منهم.
حينما تقولين كلامًا كهذا فإن رغبة محمومة تتملكني، ولا أحققها أبدًا في سؤالك: من أنتِ حقًا يا ميادة؟، وكيف تستطيعين تفسيري بهذه الحساسية والدقة؟.. ما الذي أمرره بالفعل داخلك يا ميادة؟.. قضيبي، أم حياتي التي لا أعرفها؟.
……….
*من المتوالية القصصية “البصق في البئر” ـ قيد الكتابة.